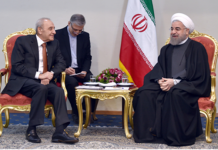أوباما وبشّار في خندق واحد!
الياس حرفوش/الحياة/26 آب/14
كان العنوان في الجريدة البريطانية صادماً: الغرب على وشك المشاركة مع قوات بشار الأسد في وجه تنظيم «الدولة الإسلامية». بعده جاء إعلان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في إطلالة أولى بعد غياب طويل، أن حكومته مستعدة للتنسيق «مع الجميع» لمكافحة إرهاب «داعش». وأن أي جهد دولي للتصدي لهذا التنظيم يجب أن يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية. لم يعد هناك مجال للاختباء خلف الأقنعة. ها هي دمشق على استعداد الآن لقطف ثمار الزرع الذي أشرفت على نموه طوال ثلاث سنوات. في آذار (مارس) 2011 نزل المعارضون السوريون بصدورهم العارية إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح. نظرية محاربة الإرهاب لم تكن سائدة يومها إلا على لسان حكام دمشق، وكان لا بد لتحويل النظرية إلى واقع من الإمعان في القتل لتعزيز التطرف في صفوف المعارضة على حساب المعتدلين في «الائتلاف الوطني» و»الجيش السوري الحر»، الذين كان يمكن أن يشكلوا بديلاً للنظام يكون مقبولاً إقليمياً ودولياً. التقت أهداف الأسد مع السياسات التي اعتمدتها إدارة باراك أوباما ومعظم الحكومات الغربية تجاه أطراف المعارضة هذه، والتي تمثلت بالتخلي عنها وتركها وحيدة في مواجهة براميل الأسد وقذائف طائراته. واليوم نرى نتيجة سياسات التردد والتسويف والقراءات الخاطئة التي اعتمدها الغرب تجاه الثورة السورية وسواها من أزمات المنطقة. الورم يكبر وينتشر وأميركا ودول الغرب تتفرج. ولا تجد هذه الدول أن واجبها هو التدخل لإجراء الجراحة أو على الأقل لمساعدة وإسعاف الجرّاحين إلا عندما يصل الورم إلى الجسد الأميركي.
هكذا لم ينتبه باراك أوباما إلى نمو «داعش» ولا إلى تزايد موجات التطرف داخل قوى المعارضة السورية إلا عندما أخبروه عن الشريط الذي بثه «داعش» لقطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي. ماذا يمكن أن تسمى قرارات كهذه سوى أنها أنانية ومصلحية، لا يعني لها شيئاً قتل ما يقارب 200 ألف مواطن سوري، ولا تهتز إلا عندما يصل السكين إلى رقبة مواطن غربي؟ هل من يستغرب بعد ذلك أن يطالب «داعش» بمئة مليون دولار لإطلاق الرهينة الأميركي؟
تخلى باراك أوباما عن السوريين وعن ثورتهم بعد أن رسم «الخط الأحمر» وأخذ يحدد للرئيس السوري مواعيد الرحيل. وقبل ذلك كان قد تخلى عن الالتزامات الأميركية تجاه العملية السياسية في العراق، وعقد صفقة ملغومة مع إيران، سمحت بإعادة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة سنة 2010، على رغم خسارته الأكثرية الضرورية لتولي المنصب. الأسد اعتبر أن السياسة الأميركية ضوء أخضر له لإخضاع السوريين وإجبارهم على القبول به رئيساً مدى العمر. والمالكي اعتبر الصفقة ضوءاً أخضر لتهميش السنّة في العراق واستعداء الأكراد وتحويل العراق إلى ولاية إيرانية يحكمها قاسم سليماني.
لم ينشأ تنظيم «داعش» من فراغ. نتحدث كثيراً عن ثقافة التطرف التي تسمح لأفكار إرهابية مجرمة مثل أفكار «داعش» وأمثاله بالنمو. ولكن، كيف السبيل لمحاربة تيارات كهذه سوى بدعم جماعات الاعتدال ومساعدة القوى القادرة والطامحة إلى تبني هذه القيم وبناء الدولة المدنية؟
لم يكن تنظيم «داعش» موجوداً في سورية عام 2011. وفي العراق، كان السنّة هم الذين قضوا على أسلاف أبي بكر البغدادي، مثل أبي مصعب الزرقاوي وصحبه، من خلال القرارات التي اعتمدها جورج بوش (أجل جورج بوش!) والجنرال ديفيد بترايوس، والتي أنشأت «الصحوات» التي تولت قتال المتطرفين والإرهابيين ودحرهم، قبل أن يتخلى المالكي عن «الصحوات»… ثم تنسحب قواته من وجه «داعش» الذي استولى على الأسلحة التي تركها الأميركيون في يد الجيش العراقي، فتحولت إلى أدوات للذبح والتهجير.
القرارات المتأخرة توازي في خطرها القرارات الخاطئة. وها هو تمدد «داعش» يفرض اليوم على الجميع إعادة حساباتهم، وربما عضّ أصابعهم أيضاً. الجنرال مارتن دمبسي رئيس أركان الجيش الأميركي يعترف أنه لن يكون ممكناً القضاء على «داعش» في العراق، من غير التصدي له في سورية أيضاً. ماذا سيعني هذا سوى أن يتحول قتال «داعش» إلى معركة يخوضها الجيش الأميركي إلى جانب جيش بشار الأسد، أو على الأقل لمصلحته، بعد أن سمح التخلي الأميركي عن المعارضين السوريين المعتدلين أن يصبح «داعش» و»جبهة النصرة» القوى الوحيدة الفاعلة اليوم في وجه قوات الأسد؟