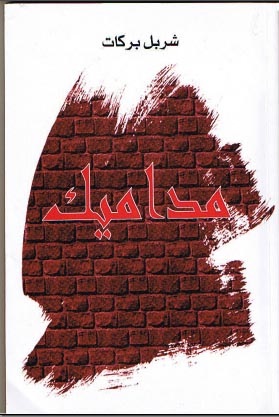كتاب الكولونيل شربل بركات “مداميك”/الفصل الثالث/الحلقة الخامسة
13 تشرين الثاني/2020
وفي فلسطين إستقبل أهالي الجش وكفر برعم المسيحيون، من وصل من اخوتهم أبناء عين إبل المنكوبة وقد فتحوا بيوتهم وقلوبهم وكانت تربطهم صداقات وقرابة مع الكثيرين، والأهم من ذلك روح العطف التي تنمو وتظهر في الملمات خاصة بين من تجمعهم روابط حضارية أو جغرافية أو دموية…
في اليوم الثاني وصل أمر إلى الجش وكفربرعم من الحاكم العسكري في صفد بوجوب إنتقال المهجرين إلى هناك حيث جهزت المدرسة لاستقبالهم. وهكذا رحل أغلب الذين وصلوا إلى هاتين القريتين إلى مدينة صفد ونزلوا بالمدرسة. وجاء من أجرى إحصاء للعائلات المنكوبة وسجل الأسماء وقد وزعت بعض البطانيات ثم قامت جمعية يهودية بتأمين وقعة طعام صباحية ومسائية لكل الذين كانوا ينزلون في المدرسة، وقد اهتم الحاكم أيضا بتأمين بعض المواد الغذائية الضرورية وتوزيعها على المحتاجين، ولكن كثيرين من الأهالي استمروا بضيافة الأصدقاء أو الأقارب، وقد نزل أبو بركات والعائلة ببيت صديقه “ادوار أفندي” الذي كان تاجرا معروفا وشخصية منظورة في صفد. وقد وضعت أم يوسف طفلها في اليوم الثاني على وصولهم إلى صفد في المستشفى هناك وأسمته “وديع”. وبقي البعض في الجش وكفربرعم بينما توجه آخرون إلى أصدقاء في قرى الجليل مثل أبو سنان وغيرها ووصل قسم منهم إلى حيفا.
في ابو سنان وصل مع الصباح خبر “أبو روفائيل” وأبنه إلى عائلته وقد كانت “أم رفائيل” مشغولة البال فلم يصل زوجها ولا “روفائيل” ولا “بولس” الصغير وعندما وصل الخبر فقدت صوابها ولم تعد تدري ماذا تفعل ولا يزال معها طفلة وولدان صغيران عدى عن “ماري” التي قررت على الفور أن تبقى والدتها مع الصغار وتعود هي مع “يوسفية” إلى عين إبل، مهما كلف الأمر، لتبحث عن شقيقها بولس. وهكذا كان فلم تمض ساعة على ذلك إلا وانطلقت باتجاه البلدة ودون أن تخبر أهل البيت الذي كانوا ينزلون فيه كي لا تحرجهم فيخاطر أحدهم بالذهاب معها. ولما كانت أبو سنان تبعد عن عين إبل مسيرة نهار ولم تستعملا وسيلة نقل فقد اسرعتا لا تلويان على شيء فوصلتا إلى البلدة بعد غياب الشمس.
كانت السنة اللهب لا تزال تتصاعد من بعض البيوت يرافقها شيء من الدخان وبدأت الجثث التي تركت في أماكنها، وقد مضى عليها نهار كامل، تتحلل وتنبعث منها روائح نتنة. وصلت “ماري” و”يوسفية” إلى البيت فوجدتا ذلك المنظر الرهيب، فبكت ماري والدها وشقيقها، ولكن بنفس الصمت الذي رافقها منذ انطلاقها، فلم تنطق بكلمة، ولكن دموعها سالت بغزارة عند رؤيتهما. ثم قلبتهما ومسحت وجهيهما بدموعها، وكانت يوسفية تبكي وتشهق فالمنظر يلوي القلب؛ فلم تكن ماري قد تجاوت السابعة عشرة من العمر، في عز صباها وجمالها، وقد تدلى شعرها على وجنتيها يغطي ذلك الوجه الجميل الذي زينته عينان خضراوان كانتا تسلبان الأبصار والقلوب، ولكنها في هذا الموقف بدت صلبة متماسكة تشابه اللبوة في منظرها، وقد غطاها الحزن الممزوج برغبة في الانتقام وأسى لا يشابهه شيء، ولكنها قالت ليوسفية بعد دقائق على وصولهما:
– لن نضيع الوقت وسوف ندفنهما قبل أن نعرف ما حل ببولس.
فدخلت يوسفية إلى البيت وأحضرت رفشا ومعولا وبدأت بحفر حفرة في الحاكورة تحت البير، وكانت أرض الحاكورة سهلة للحفر فلم تأخذ وقتا طويلا لتصبح مقبولة لكن ماري قالت لها:
– سوف نجعلها أكبر من ذلك وساذهب أنا إلى “الخشخيشة” في المقبرة الجديدة وأحضر تابوتا لكل واحد منهما وندفنهما كما يليق.
فاقنعتها يوسفية أن تنتظرها لأنها تخاف البقاء وحيدة، ولكنها بالواقع كانت تخاف عليها، فكيف ستذهب فتاة مثلها إلى المقبرة ليلا وفي قرية مهجورة، حيث يكمن في كل مكان خطر غير منتظر، ولكنها لم تجرؤ على قول ذلك، فتظاهرت هي بالخوف، وتحايلت بمد الحديث حتى أكملت عملها، فذهبتا إلى المقبرة الجديدة التي كانت قد بنيت على شكل جوارير في كل منها مدفن، فأحضرتا نعشين ثم وضعتا الجثتين فيهما ودفنتاهما كما يجب. بعدها ذهبتا إلى دار خالها، وكان عجوزا لا يبصر، فوجدتاه لا يزال على قيد الحياة وقد بقي وحيدا في بيته، وأخبرهما أن بولس حي يرزق وقد أخذه “الحج محمد” الذي كان جارهم بالكرم إلى حانين ليخبئه عنده بعد أن علم بما جرى لوالده وأخيه. فلم تنتظرا الفجر بل ذهبتا فورا إلى حانين إلى بيت “الحج محمد” الذي ذهل لقدومهما في مثل هذه الساعة من الليل وحيدتين وفي هذه الظروف، ولكنه أعتقد أن هناك من ينتظرهما، فاعطاهما الولد وتأسف على صديقه، ونزلتا باتجاه عين حانين لتشربا قليلا من الماء قبل أن تكملا الطريق بصحبة شقيقها الصغير هذه المرة…
عند وصولهم إلى العين صادفهم شاب من حانين كان ينام مع قطيعه قرب العين فأراد التحرش بماري، ولكنها كانت قد أخذت تذكارا من والدها قبل أن تدفنه، خنجرا لم يكن يفارقه كان أهداه له فارس بدوي يرجع بنسبه إلى أمراء من الغساسنة كانوا ينزلون بوادي الأردن وكان عزيزا عليه، ولذا أرادت ماري الاحتفاظ به، وعندما حاول هذا الاقتراب منها، سحبت الخنجر وغرسته في صدره وقالت له بثقة القادر ورغبة الإنتقام ترن في صوتها وقد صرت أسنانها وجحظت عيناها:
– إرحل أيها الخسيس قبل أن أمزقك إربا…
فابتعد راكضا لا يلوي على شيء وقد ذعر وأحس برهبة الموقف…
كان خوري الحدادين قد بقي في البلدة ولم يشأ الهرب إلى فلسطين، فقد كان له اقارب في “تبنين” ولم يسمح أهالي البلدة هناك للمسلحين بالمساس بهم طيلة الأشهر الماضية، ولذا فقد كان يحاول أن يجد وسيلة للوصول إليهم. فاختبأ في تبانه بالبيت طوال الليل، وعند الصباح، وقد كان خف عدد الغرباء في البلدة، خرج من البيت ليتفقد ما يجري، وكان المنظر يلوي القلب. فقد اندلعت النيران هنا وهناك وسقطت بعض البيوت التي احترقت، وكان سطح الكنيسة لا يزال مشتعلا ومنازل كثيرة من حولها ثم سمع وقع حوافر خيل، وكان منظر البلدة قد أثر به فلم يكن قد تصور ما جرى في المساء لأنه كان دخل إلى بيته وأختبأ طوال الليل، فلم يابه لذلك القادم ولم يحاول الاختباء أو حتى الدخول إلى البيت فإذا بالرجل يحييه ويسأله عن خوري الحدادين فأجابه:
– وصلت با أبني شو المطلوب؟.. وإذا كان بعدكن ما شبعتوا دم أنا حاضر… ما حدا أحسن من حدا…
فأجابه ذلك الشاب، وكان يركب فرسا من الأصايل وقد تزنر بالرصاص وفتل شاربيه الكثيفين على طريقة مرافقي البيك، بأنه أرسل للتفتيش عنه من قبل البيك واصطحابه إلى حيث يشاء.
وكان البيك قد حضر صباحا مع حفنة من الرجال وحين نظر إلى البلدة وهي تحترق، وقد كانت سابقا تعج بالحياة والحركة، وروائح الخير والبركة تفوح من كل بيوتها وشوارعها، وكان يشتهي أن تتشبه قرى المنطقة بها وبرجالها، ومع أنه لم يكن راضيا على موقفها الذي أعتبره نوعا من التحدي للتيار الذي لم يستطع هو أن يحاربه؛ فقد “تخلصنا من الأتراك صحيح ولكن أتانا الفرنسيون من جهة والأنكليز وعرب الحجاز من جهة أخرى”. وبالنسبة له لو لم يكن “الشريف” من “آل البيت ” لكان فضل الوقوف جهارة مع من يطالبون بوطن مستقل، “فقد كفانا ظلما ممن يدعون الوصاية علينا وحق القربى”، “فظلم ذوي القربى أشد مضاضة..” ولكن تردده في اتخاذ موقف صريح خوفا من حساسية الموضوع الديني، جعل الرعاع الذين حركتهم أجهزة غريبة يسيطرون على الموقف ويحركون الأمور في طريق المواجهة، ولم يعد حتى هو نفسه قادرا على اتحاذ القرارات. ولكنه رأى بهذه النتيجة، اليوم، لعنة سوف تلحق بالأجيال ونقطة عار ستلطخ إلى الأبد تاريخ هذه المنطقة التي كان يحلم، بعد أن زال الكابوس التركي، أن تصبح مركز نشاط واستقرار وحركة بين لبنان وفلسطين والشام. وقد كان يرى في هذه القرية، التي انفتح أبناؤها على حضارات العالم فتعلموا بمدارسها منذ أكثر من خمسين سنة على أيدي المرسلين، وهاجروا إلى بلاد الله الواسعة، وأغتنوا بالمال والمعرفة وسعة الآفاق، مثالا حيا على النشاط الذي يسهم في الازدهار في منطقة هو زعيمها، وإن لم يكن هؤلاء من أهل ملته. ولكن الحقد والتطرف أعميا العيون حتى “أننا لم نعد نعرف ما نقوم به، فماذا فعلنا غير النهب والسرقة وقتل بعض الأبرياء؟”.. ثم أرسل ذلك الشاب للبحث عن الخوري الذي كانت له علاقة خاصة به، ولم يستطع مواجهته، فقال للرسول أن يساعده في الوصول إلى حيث يشاء إن لقيه حيا، ورحل مع مرافقيه قبل أن يعرف النتيجة. وهكذا فقد ساعد ذلك الشاب، الخوري في الوصول إلى تبنين حيث كان أقاربه…
… وبعد سنة على هذه النكبة التي دمرت عين إبل وهجرت بنيها، عاد أهلها ليبنوها من جديد بسواعدهم ونشاطهم وبالقدرات الذاتية بالرغم من كل شيء. وبعد أن لملموا الجراح ودفنوا القتلى، كبتوا الحقد، الذي نتج عن ذلك، في قلوبهم، فالحياة ستستمر والوطن الذي حلموا به ها هو قد ظهر وتحدد، ولو بدمائهم، وقد اصبح لبنان الكبير أول دولة تقوم في المنطقة، وبدت الأمور كأنها تسير في الاتجاه الصحيح. ولكن الذي مات لن يعود، ومن فقد ثروة إضطر إلى الكفاح من جديد، ومنهم من لم يعد يرى في هذه البلاد كلها ما يشده للبقاء فهاجر مجددا إلى بلاد الله الواسعة للعمل، حيث لا مجال للانتماء إلى جماعة ولا حاجة للقتال في سبيل شيء ويتلخص الجهد في الحصول على القوت وبعض الرفاه إذا أمكن. وقد فتحت أبواب مثل “حيفا” حيث كان المرفأ الجديد الذي كان أنشئ مع بداية القرن يحرك التجارة ويستقبل سفنا أكبر من تلك التي كانت تأتي إلى صور وصيدا سيما مع سيطرة الأنكليز على فلسطين والداخل. وكانت “الكوبانيات” اليهودية تعمل على إنشاء مراكز إنتاج وعمل وأستقرار للمهاجرين من اليهود الذين زاد عددهم مع نهاية الحرب العالمية الأولى. وقد حركت هذه العملية التجارة وزادت مجالات العمل في المدينة ككل. وكان من وصل اثناء التهجير إلى حيفا، قد رأى أوضاعا أغرت البعض منهم بالعودة للعمل فيها بدل الاستقتال للحصول على لقمة العيش، في بلاد تعاني تمزقا داخليا وفي قرية لهم في كل شارع من شوارعها ذكرى أليمة. وقد كان هناك جالية صغيرة العدد من العينبليين الذين سكنوا حيفا منذ بداية القرن وعملوا مع الجالية الألمانية فيها. ولكن هذه الفئة، بحمد الله، لم تكن كبيرة. واستمرت البلدة في تضميد جراحها وإعادة البناء، حتى كان الخامس من ايار من السنة الأولى بعد العشرين يوم ذكرى مهيب، وقد جمعت رفات الشهداء ووضعت بالقبر الذي بنوه بالجهد والاندفاع الذي تحلوا به طوال السنة بعد عودتهم، وبواسطة بعض الهبات التي أرسلها إخوتهم المهاجرون في ما وراء البحار، وقد سمعوا بما حل بقريتهم. وقد كانوا أعادوا بناء بيوتهم وزرعوا حقولهم وأصلحوا الكنيسة، لكن الرصاصات التي كانت أطلقت على حمامة الروح القدس وفتحت ثغرتين تحت جناحيها بقيتا شاهدتين على ذلك النهار. ثم بنوا بقربها قبر الشهداء، كبيرا كي يتناسب مع الماساة، وبجانب الكنيسة التي يعتزون بها، ليكون شاهدا على تضحياتهم في سبيل قريتهم والوطن، وحافزا لهم للأستمرار في اليقظة والتعاون والوحدة رحمة بهؤلاء الذين بذلوا النفس ليبقوهم رافعي الرأس في هذه المنطقة التي لم يتركوها منذ أكثر من ثلاثمئة عام. وقد كان احتفالهم الأول جامعا. وحضرت وفود من قلب لبنان. وألقيت خطب بالمناسبة وكلمات وقصائد نوه فيها الخطباء بالبطولات والتضحيات. وهكذا فقد اعتبروا هذا اليوم يوم الشهداء منذ ذلك التاريخ. وظلوا يحتفلون به كل سنة. وبقي القبر، بهيبته، مزارا ومعلما وشاهدا للتذكير بالحادثة. وقد كبر الأطفال وتعلموا أن هذه البلدة قد بقيت بالبذل والتضحية، وأن لها على الوطن الاحترام والتقدير. وقد كان في نفس الوقت شوكة تؤلم لأنها تذكر بتقاتل أبناء المنطقة وتباين آرائهم واختلاف أمنياتهم، فقد كان إبن عين إبل يعتز دائما بانتمائه للوطن ويشعر أن له عليه، بينما ظل يعتقد أن جيرانه في المنطقة لا يشاطرونه الشعور نفسه وأنه في حال ضعفت السلطة قد يغيرون انتماءهم وقد يرتد عليه ذلك كما حدث في العشرين…
أكمل شريف طريقه إلى صف الهوا لمقابلة الجنرال وقد دارت برأسه كل تلك الصور والأحداث وهو يعبر الطريق، ومر على ضهر العاصي، حيث أعاد التاريخ نفسه في 1976، ولكن ضهر العاصي صمد هذه المرة ولم تهجر عين إبل بالرغم من هرب الكثيرين ونزوحهم إلى أماكن أكثر أمانا، وقد كان الوطن كله يعاني هذه المرة. وصمدت البلدة طيلة سنتين تقريبا وتحملت حصارا وقتالا مريرين وضغطا وقصفا أفقدوها بعض بنيها شبابا وكهولا، نساء وأطفالا…
كان شريف يسير باتجاه شلعبون وقد تتالت هذه الصور؛ فهنا توقفت الحياة مدة سنتين لترسم حدود الوطن يوم سقطت الدولة تحت ضغط المنظمات الفلسطينية وأجهزة الدول المجاورة. ومرة جديدة جاءنا من الشام نفس حرك النعرات ففتح الجرح الذي كاد يلتئم وأعاد التشكيك بالوطن أو أبرزه من جديد إن لم يكن بعد قد انتهى. وقد كانت المنظمات الفلسطينية، مدعومة من الشام والأنظمة “التقدمية” العربية، قد أنشأت “دولتها” وأجهزتها، في المخيمات أولا، حتى أصبحت هذه رمزا للتخريب وقلب النظام، ثم مركز تصدير الإرهاب العالمي. ولم يبقَ جماعة تسمي نفسها “ثورة” إلا وقد تدربت في هذه المخيمات على الارهاب والتقتيل. وكان جو الحرية، وخاصة الصحافية والاعلامية في لبنان، نقطة جذب لهؤلاء زيادة على الفوضى التي سببتها المنظمات وإنشائها دولة “الثورة العالمية” في قلب لبنان، حتى أصبح المواطن اللبناني، في البدء، يهاب الاقتراب من هذه المراكز، ثم تبعته الدولة كلها، فيما بعد، وأصبح على الجيش نفسه أن يغير طرق إمداده وتحركه داخل البلد آخذا بالحسبان هذه البؤر. ثم تتابعت الأحداث والاشتباكات من 1968 – 1969 التي أدت إلى قبول الدولة بسلطة هذه المنظمات واقتطاعها جزءً من البلاد سمي “فتح لاند “. فهدد الوجود الآمن لكل الجنوبيين، وخرق الهدنة المعقودة مع دولة اسرائيل ، حتى اهتز الجنوب وأهله وخلق مشاكل جديدة أدت إلى أحداث 1973 التي كاد الجيش فيها أن يقضي على هذا “السرطان” لولا تدخل “الأشقاء” بالتهديد والوعيد. وقد كان إتفاق القاهرة في 1969 أظهر هشاشة الموقف “الوطني”، وأعاد النظر في الأسس التي قامت عليها دولة 1943 ومقولة إستقلاله عن الشرق والغرب بأنه “لن يكون ممرا ولا مقرا للشرق أو الغرب “، فإعطاء “الثورة” التي جذور دعمها وتمويلها وتوجيهها تعتبر من “الشرق” أعاد المشكلة، فقام “الحلف الثلاثي” وجيء بالرئيس فرنجية لينهي، بصلابة الموقف، الانحياز لهذا “الشرق” ويعيد التوازن للوطن. فكانت أحداث 1973 تلك ونتج عنها زيادة الشرخ وتقوية المنظمات ودعم المسلمين علنا لهم، رجال دين وسياسيين، على حساب التوازن والصيغة، وبالنتيجة على حساب الوطن. وكان رد المسيحيين التحضر للدفاع عن النفس. وكانت الحرب التي لم يزل شريف ورفاقه يعيشونها طوال السنوات العشر، وقد تغيرت فيها المواقف عدة مرات، وتداخلت الأحداث، وقامت نزاعات، وفرزت مناطق، وتغيرت تحالفات، وتدخلت قوى ودول، وكان الوطن هو الخاسر الأكبر من كل هذا. وقد وضع المسيحيون أمام خيارين: إما القبول بالذل والوصاية، وإما الاستمرار بالحرب والتدمير. ولم تنفع الطروحات ومحاولات الحوار في إعادة الأمور إلى نصابها ف”الشرق”، ممثلا بسوريا، هذه المرة ، قد دعم جماعته حتى النهاية، بينما كانت ل”الغرب” طروحات ومشاريع أخرى. ولم يعد هذا الوطن الصغير مركز اهتمام له لدرجة وضع ثقل “غربي” لوقف النزف وإعادة هيبة الدولة فيه. وكأنهم إعتقدوا أن ترك المسيحيين دون دعم منهم سيزيلهم فيرتاحون من مشكلة وعبء إعتبروا أنهم يحملونهما، أو أنهم لم يعودوا ينظروا إلى وجود مبرر لدعم الأنظمة الديمقراطية والدول الصغيرة، في وقت كانت مخاوفهم من الكتلة الشيوعية قد بدأت تتضاءل. وقد تكون هذه النزعة الدينية، التي ظهرت في حرب لبنان أولا، ومن ثم في ايران، وفيما بعد في قتال الأفغان ضد السوفيات، هي الرد الغربي على الطروحات الشيوعية، ولذا كان وقف القتال في لبنان سيؤدي إلى تخفيف التطرف ونمو الأصولية التي ستكون الخطر الأكبر حتى على الدول الاسلامية… ولكن هل هذه النظرية يمكن أن تنجح؟.. وإلى أي مدى؟.. وهل إن دولا متطورة ولها تاريخ في الحضارة ونوعا من الاتزان مثل مصر والجزائر وباكستان يمكن أن تعاني من مشاكل أصولية؟.. أو أن بذور هذه الأصولية تكمن في الكتب الدينية نفسها، حتى أنه، في اي عصر، يمكن لأي زعيم أو رجل دين نفض الغبار عنها وإعادتها إلى الواجهة؟.. وهل ستكون التجربة الإيرانية هي الدافع لتغييرات كهذه؟.. ومن سيكون المستفيد منها؟.. وهل يستطيع الغرب أن يقف موقف المتفرج وقد شكل جماعة شمال افريقيا جزءً مهما من المجتمع الفرنسي، ويؤلف الأتراك وبقية المهاجرين المسلمين شريحة كبرى من المانيا، وقد أصبح الاسلام في الولايات المتحدة ملجأ لكثير من الفقراء السود الباحثين عن الجذور معتقدين بأن بعضهم كان مسلما قبل أن يتاجر بهم الأوروبيون المسيحيون كرقيق فيصلون إلى أمريكا ويفقدون الكرامة والعزة والتراث؟.. فهل سيستطيع الأوروبيون والأمريكيون إذا غض الطرف عن تنامي الأصولية الاسلامية ودعواتها المتعاظمة؟.. وماذا سيكون ردهم عندما تقرع هذه النغمة أبوابهم؟…