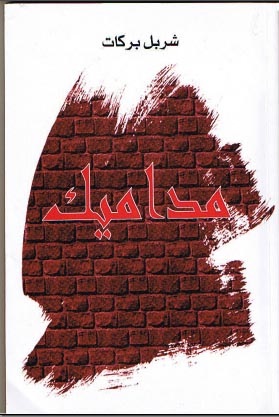كتاب الكولونيل شربل بركات “مداميك”/الفصل الثاني…الوصول إلى عين إبل/الحلقة الثالثة
29 تشرين الأول/2020
وصل شريف إلى البيت وكانت زوجته باستقباله، فالصغار بالمدرسة وقد حضرت له “وليمة” فهو آت من السفر ومن المؤكد أنه لم يأكل منذ المساء. كانت تلبس ثوبا أسود بسيطا وقد تدلت غرتها على جبينها بينما ربطت باقي شعرها إلى الوراء، وكانت بسمة ناعمة تزين شفتيها بالرغم من الرصانة التي تغلف كل شيء حولها، ففرحتها بعودته سالما في كل غدوة هي كبيرة. وفي هذه الظروف وهذا النوع من العمل يكون كل ذهاب وداعا وتخوفا من أن يكون الأخير، وكل عودة لقاء وكأنه الأول. كانت أسئلة كثيرة تبدو على شفتيها وقد كرجت على خدها دمعة بالرغم منها عندما عانقته وسألت:
– وكيفها “نور”؟
فأجاب وكانه لم يرد أن الخوض بالموضوع:
– شو “نور” الله يساعدها…
كان نزول شريف إلى بيروت بسبب ابنة شقيقته “نور” وقد كانت شابة لم تتجاوز الثالثة والعشرين من العمر تدرس الطب في اليسوعية، وهي أهم كلية في بيروت، وكانت أنهت تقريبا سنتها السادسة وتقوم بالتمرن في مستشفى “أوتيل ديو”. لم يكن ينقصها الجمال فهي شقراء الشعر زرقاء العينين لم يؤثر على وجهها حروق البارود الخفيفة التي كانت قد اصيبت بها في اول الأحداث لا بل زادتها رونقا، وقد كانت خفيفة الدم حلوة المعشر حادة الذكاء لم ينل إنتقالها من مدرسة إلى أخرى بسبب هرب العائلة من الأحداث، من مستواها العلمي وأدائها في هذا المجال، بل برعت إينما حلت، وأخيرا بين زملائها في كلية الطب.
كان والدها موظفا في مصفاة النفط في الزهراني، وكانوا بطبيعة الحال يسكنون في صيدا، وقد اشترى قطعة أرض بنى عليها منزلا في اعالي عبرا الجديدة يطل على البحر وعلى الوادي الشمالي، وقد جاور الدير، هناك، في ذلك الحي الذي كان أغلب سكانه من الموظفين الذين استقروا في جوار صيدا. وكان يحلم بأنه سيمضي بقية أيامه في ذلك البيت الذي بناه بالعرق والجهد والقرض المالي الذي ساعدتهم به الشركة. فأغلب زملائه قاموا بمثل هذه العملية. وأصبح الحي يعج بالمنازل الجديدة وأغلبها لأصدقاء، وعاشوا معا عدة سنين، وكاد أن ينهي أقساط الشركة وقد أصبح الأولاد من سن المراهقة، وإذا بالحرب تدق الأبواب.
لم يكن “مروان” يهتم بالسياسة، فقد كان جل همه وظيفته وبيته، فقد تمر سنة لا يزور فيها أحد إخوته في بيروت أو يغادر صيدا إلى الضيعة، وهو يعيش مع عائلته مرتاح البال، فقد أمن المنزل وبدأ الأولاد يكبرون وهم على أحسن حال في المدارس، وقد رزقه الله صبيين وابنتين كان يرى الدنيا فيهم، ولكن السعادة لا تدوم. ففي بدء الأحداث كتب أحد “المحبين” مقالا عن شقيقه “أبو أرز”، وكان من قادة اليمين اللبناني وينادي بضرورة خروج الفلسطينيين من لبنان…
لم يكن “ابو أرز” طائفيا كما نعت المسيحيون الباقون، ولكنه كان ينادي بلبنان الذي لا يحتاج إلى نعت أو صفة تلازمه فتملي عليه تصرفاته، فهو لبنانيا فقط وليس عربيا أو تركيا أو فرنسيا مثلا… وهو بذاته وطن العطاءات الحضارية، وطن الحريات التي لا تحدها إلا حرية الآخرين وحقهم في الحياة والتعبير. وكان يرى في الشعب اللبناني إمكانيات هائلة تقدر أن تجعله يضاهي الأمم المتقدمة والشعوب القوية. وقد راى بالفلسطينيين المتسلحين والذين يريدون السيطرة على لبنان، بديلا للأرض “السليبة”، الخطر المباشر، فدعا إلى نزع سلاحهم بالقوة، بعد أن أصبحوا قوة تهز الحكم وشكلوا دولة ضمن الدولة. وطالب اللبنانيين أن يتوحدوا لقتال هؤلاء الذين يهددون مستقبلهم واستقرارهم. لكن المنظمات الفلسطينية في ذلك الوقت كانت قد سيطرت على الشارع الاسلامي، حتى أن بعض المسؤولين الروحيين نادى بهم “جيش المسلمين”، وقد كانت المنظمات مركز تخطيط وتنفيذ للإرهاب العالمي، وكان بعض ساسة الدول الكبرى يرون ضرورة التخلص منهم وإيجاد مخرج لهم، وقد رأوا في “لبنان الضعيف” حلا ممكنا لقضيتهم، فقد يذوب “الوطن الصغير” في صراع “داخلي” ويرتاح العالم من الذين يقضون مضاجعه إرهابا وعنفا.
كان “أبو أرز” يصر على أن المشكلة هي بين اللبنانيين والغرباء وليست مشكلة داخلية. ولكنه لم يستطع أن يقنع أحدا في “الطرف الآخر” ليكمل الصورة المثلى عن اتحاد اللبنانيين في وجه الغرباء. وربما كان الفلسطينيون، وغيرهم ممن تبنى حل قضيتهم لبنانيا، يرون في طرحه مشكلة لهم قد تنزع حجة “الصراع الداخلي”، فحمّلوه تطرفا يمينيا وعمالة لاسرائيل… من هنا كان على “مروان” فور تبلغه ما كتب عن أنه شقيق “أبو أرز” الذي يسكن في صيدا، أن يسارع إلى الهرب ليلا من منزله خوفا من ردة فعل الفلسطينيين، وكانت معروفة، فقد يختطف ويقتل وتلقى جثته في مكان ما، هذا إذا لم تقتل كل العائلة. فقد سبق وقتل عمه بولس في بيروت والقيت جثته تحت جسر فؤاد شهاب في أول الأحداث مع أنه كان يسكن في المزرعة منذ أكثر من ثلاثين سنة وقد ولد أولاده وتربوا هناك ولم يعرفوا عين إبل إلا قليلا وفقط أثناء الصيف فأمهم كانت شامية وكان والدهم معاونا في الجيش وقلما مكنه عمله من التمتع بصيف أو بفرص طويلة. وهكذا فقد انتقل مروان بسيارته مع عائلته ليلا إلى عين إبل حيث بقي عدة أشهر إلى أن أصيبت “دارينا” فاضطر إلى التوجه رغم الخطر إلى بيروت حيث استقر نهائيا…
كانت “دارينا” دقيقة الملاحظة وسريعة الخاطر وقد تعلق بها “فهيم” الطبيب المبتدئ، فهو أنهى دراسته لتوه ويمارس عمله في “أوتيل ديو”.
كان “فهيم” من إحدى قرى المتن الواقعة تحت الاحتلال السوري، وقد سكن بيروت بينما بقيت عائلته في القرية، وكان سهلا عليه الذهاب لزيارة الأهل في القرية والعودة، فالمنطقة قريبة وما عليه سوى اجتياز معبر “المونتي فردي” ليكون هناك في اقل من نصف ساعة. كان “فهيم” شابا لطيفا ومهذبا وقد كانت له ملامح جذابة، وفي السنين الأولى من تمرنه في “أوتيل ديو” أعجبت به “الشيفتين ليلى”، وكانت الممرضة المسؤولة في قسم الطوارئ حيث خدم عدة أشهر في السنة السادسة، وكانت “ليلي” جذابة ويغازلها كثير من الأطباء، ولكنها لم تكن سهلة المنال، وقد كان “عندها من نفسها” ومن الخبرة في معاملة الرجال، ولذا عندما شعر “فهيم” بأنها تميل إليه أحس برجولة وبتعالي على الرفاق، وهو الخجول نوعا ما. ومنذ تلك الليلة، يوم بقيت في غرفته بعد أن وزعت العمل وكان عليهما السهر في النوبة الأخيرة، حيث استغلت “ليلى” هذه الفرصة لتذيقه طعم اللذة التي كان لها خبرة فيها، أحس “فهيم” بنشوة جعلته يواظب على تكرار هذا اللقاء الحميم، وأصبح يتمنى أن يكون دوامه ليلا مع “ليلى” وأن يخلو له “الجو”، ولكن الأمور لم تجر دائما كما يشتهي. وكانت “ليلى” تحب أن تثيره أحيانا بأن تمتنع عنه بأكثر من حجة.
مرت تلك الأشهر كلمح البصر، وقد أصبح تصرفه تجاهها ظاهرا بعض الشيء بالنسبة للزملاء. ولكن دخول “دارينا” في السنة الثانية إلى المستشفى قلب الأمور، فقد كانت طلتها تبعث الاعجاب وشخصيتها تفرض الاحترام، وبعد الأسبوع الأول كانت قد اصطدمت مع “الشيفتين” التي “لا تعرف حدود مسؤوليتها”، مما أضطر “فهيم” إلى التدخل.. بعد هذه الحادثة التي شعر فيها “فهيم” أنه يواجه شخصا يثق بنفسه وبتصرفاته ولا يترك مجالا للخطأ؛ “فنحن في مستشفى وليس في “نزل” وأقل إهمال قد يودي بحياة نحن مسؤولون عنها”، كان هذا المحور الأساسي لحديثها عندما دخلت إلى مكتب “فهيم” لتكمل الحوار. وكان “فهيم” ينظر إليها بتهيب وإعجاب في الوقت نفسه، فقد اعتبر نفسه مسؤولا عن الوضع بانسياقه وراء عواطفه تجاه ليلى من جهة، وتذكر في المقابل إندفاعه هو وطموحاته، ولكن باندفاع اقل من الذي رآه في “دارينا”. كان يسمع كلامها، عن “شرف” المهنة و”واجباتنا”، بخاصة في هذه الأحداث، حيث يتعرض الجميع لخطر الإصابة، في وطن يتمزق ولا من يوقف ذلك “وعلينا، أقله، أن نخفف من مصائب الناس”. لم ينطق بكلمة ولكنه سرح بفكره إلى الماضي، وتذكر نفسه صغيرا، يوم أصيب والده بطلق ناري من بندقية الصيد. وأنزل إلى المستشفى في بيروت وأعيد جثة هامدة، وكيف بقيت والدته “تدعي” على العاملين هناك، الذين تسببوا في مقتله من إهمالهم، فتصور أنه قد يكون مسؤولا عن مثل هذا التقصير اليوم، فاستصغر نفسه وتألم لهذا التشبيه. وكانت دارينا قد لاحظت أنه لا يتابعها، فتوقفت عن الكلام وتأملت بوجهه، فإذا بدمعة تختبىء في مقلته وقد غطت نظارتاه إحمرار في عينيه، فاستأذنت بالخروج، فتنبه ووقف معتذرا، ثم استدار يمسح نظارتيه.
بقيت دارينا واقفة وقد خففت من شدة رصانتها لتبدي بعضا من رقتها وترسم إبتسامة على ثغرها الجميل، ثم حاولت تغيير الحديث، كي لا تزيد من جرح شعوره، لكن فهيم خلصها من ذلك الموقف بالموافقة على رأيها ووجوب إعطاء الموضوع مزيدا من الاهتمام…
منذ ذلك اليوم تغيير موقف فهيم من ليلى وتصرفاته معها، فبعد أن كان يفتش عن فرصة للقائها والاستفراد بها، أصبح يتجنبها ويتهرب من الانفراد معها، وقد شعر بالذنب والتقصير الناتجين عن ذلك الانسياق وراء عواطفه، والتعلق بالمغامرات التي تعيقه عن تأدية مهامه أحيانا، ثم أخذ يلازم دارينا أكثر فأكثر لتجنب ليلى، وهكذا فقد شعرت ليلى، بأن دارينا هي منافستها على قلب فهيم، ووضعتها نصب عينيها.
لم يكن تلاقي دارينا وفهيم في البدء له اية مشاعر خاصة، فقد كان نجاح العمل هو الحافز الرئيسي لكليهما، ولكن دوام اللقاء والمشاركة بعدة مهمات جعلهما يكتشفان تقاربا في وجهات النظر لا بل تناغما وانسجاما، ثم بدأ أحدهما يشعر بفراغ لغياب الآخر، وهكذا فقد اصبح إحساس ليلى بمحله وسكنت دارينا قلب فهيم بالفعل.
في تلك الليلة وقد عرفت ليلى بغياب دارينا وزعت المهمات لتكون مع فهيم، وكما في الأيام السابقة تبعته إلى غرفته وأغلقت الباب واستلقت على السرير بينما كان يغسل يديه، وانتظرت، وهي في وضع مغر، “هجوم” فهيم الذي عرفته، ل”يغرف” من جسدها الشهوة التي يبغي فيعود إلى أحضانها طائعا وينسى تلك “الطفلة المتعجرفة” واحلامها الزائفة المتعالية. أحس فهيم بالنار المتأججة في جسده وقد رأها على ذلك السرير ومفاتنها تناديه، وقد كانت في أجمل أيامها، فأندفع مع غرائزه وخلع عنه الرصانة التي كان تحلى بها اشهرا. حاولت ليلى أن يكون هذا اللقاء الأفضل والأشهى والأجمل وفتشت على كل ما عرفت أنه يثيره لتمنحه لذة لا مثيل لها، وفي لحظة اعتبرت أنه عاد اليها بكل قواه وأحاسيسه، قالت له:
– وكيفها دارينا؟
فانتفض كأن حية لسعته، وجلس في السرير واضعا رأسه بين يديه، وأطرق، وعندما حاولت ليلى أن تلمسه وتعيده إليها، سحب يده منها ونهض ودخل الحمام. كانت هذه قمة الاهانة بالنسبة لليلى، فقد ذهب كل ما فعلت سدى عندما لفظت اسمها، فهل إن هذه “الطفلة” بهذه القوة حتى تسيطر عليه إلى هذا الحد؟ أم أنه يعتبرها هي رخيصة لدرجة أن لا يقبل بجمعهما في نفس المستوى، ولو بمخيلته؟ وأدركت أن كل ما كانت تصبو إليه وهم، فلن تستطيع بعد اليوم أن تستعيد فهيم الذي عرفته سابقا، ولن تقدر أن تنافس تلك الشابة التي سرقته منها، بالفعل، فانتابها شعور بالياس والحقد، وقررت الانتقام…
كان ذلك في مساء يوم أحد حيث أدخل عنصر من إحدى التنظيمات التي تعمل في المتن إلى المستشفى، وكان بحاجة ماسة لعملية جراحية مستعجلة، وكانت نوبة دارينا وفهيم، وأثناء تحضيره للدخول إلى العملية، وقد كان كثير التوجع، اعتقد بأنه سيموت، فقرر أن يعترف بجريمة كبيرة كان ارتكبها في الأسبوع الفائت وتتعلق بمقتل مدير معهد الهندسة في الجامعة اليسوعية، وكانت جريمة ضجت لها المنطقة الشرقية بأكملها. لم يطلب أحد منه ذلك الاعتراف، ولكنه أصر على الكلام، كان في الغرفة دارينا وفهيم وليلى، وقد قال الرجل اشياء كبيرة، وردد أسماء مهمة كان لها علاقة بالموضوع، وقد فهمت دارينا يومها أنه يتعلق بمواد مشعة أو سامة دخلت إلى البلد وقد طلب من المعهد أن يعطي شهادة تخالف نوعيتها فلم يقبل ذلك المدير فهدد مرة واحدة ثم أمر بقتله. كان هذا الموضوع خطيرا جدا في تلك الظروف، فالمليشيات تحكم البلد، ومن بين الأسماء التي ذكرت كان هناك من له صلة بالدولة ايضا، فلا يمكن أن يجابه أحد كل هؤلاء.
بعد ادخال الرجل إلى العملية، اجتمع فهيم ودارينا وليلى في غرفة فهيم وقرروا عدم التكلم بما حدث لأن فيه “قطع رؤوس”، وقالت دارينا التي لم تكن تقبل بالخطأ، أنها في حال تغيرت الأيام و”صار في دولة” سوف لن تسكت ولن تترك هذه الفعلة تمر. لم تنبث ليلى ببنت شفة، واكتفت بالموافقة على الصمت… نجحت عملية الشاب و”قام سالما”، ولم يذكر أنه تكلم عن الموضوع لأحد، ثم جاءه بعض الزوار والورود من شخصيات كان ذكرها في اعترافه، وبدا بأن ما قاله لم يكن بعيدا عن الواقع…
كانت ليلى تنتظر مناسبة للتخلص من دارينا وتصورت أن لحطة الانتقام قد أتت قبل خروج “توفيق” عنصر الميليشيا بيوم، فقد كانت دخلت إلى غرفته بعد خروج الزوار وفتحت معه حديثا عن خروجه معافى صباح الغد ثم المحت إلى يوم دخوله المستشفى وذكرت أن دارينا التي كانت تعالجه قد كلمت فهيم عن أمر تحدث عنه هو في غيبوبته له علاقة بقضية “البروفسيور” فمن هو هذا؟ إمتعض “توفيق” عند ذكر “البروفسيور” وتغير لون وجهه فبدا مخيفا وأمسك بيد ليلى وجذبها نحوه ثم بدأ باستنطاقها عما تعرفه حول الموضوع، فأخبرته بأنها لا تعرف إلا ما سمعت دارينا تكلم فهيم به، ولم تفهم ما هو. لم تكن دارينا ولا فهيم بالمستشفى يومها، وكان “توفيق” قد خرج قبل حضورهما، ولكنه أخذ رقم تلفون دارينا من ليلى، وعندما حضر الطبيبان لم تخبرهما ليلى بما حصل، وبعد يومين إتصل أحدهم بدارينا وذكر اسم “توفيق” وقال لها بأنه يريد أن يكلمها بموضوع سري جدا لا يستطيع أن يقوله على الهاتف. حاولت دارينا أن تتخلص منه وقالت بأنها لا تعرف شخصا بهذا الأسم وأغلقت الخط، ولكنه عاود الاتصال وأعطاها بعض التفاصيل، فأبلغت فهيم بالأمر وتناقشا حوله وقررا أن يواجهاه وكأنهما لا يعرفان شيئا عن الموضوع. إلا أنه أصر على مقابلتهما في مكان “أمين”، فالقضية خطيرة وهو يريد أن يريح ضميره، ولا يجب أن يعلم أحد به وسوف يمدهما بدليل حتى إذا ما اصابه أي مكروه يكون هناك من يملك إثباتا. خلال إتصاله بهما، أحسا بانهما قد يكونان مضطرين لمساعدته، وفي الوقت عينه قد يكونان وضعا أيديهما على ملف مهم للبلد قد يساعد في كشف أمور كثيرة، وإذا ما كان كاذبا فسوف يظل يلاحقهما، ولذا فقد قررا موجهته، ولكنه أراد أن يكون ذلك ليلا وعلى طريق فرعي قليل السير…
في تلك الليلة وقد كانا في منزل والدي دارينا في “الحازمية” ينتظران، اتصل وأعطاهما موعدا بعد نصف ساعة على طريق كلية الهندسة، فتوجها إلى هناك حسب التعليمات، وكان المكان معروفا لتنزه العشاق فلا يشك بقدومهما، وعليهما أن يعطيا إشارة بالضوء ويكملا طريقهما، وأثناء العودة يكون هو بانتظارهما على جانب الطريق، وهذا ما حدث بالفعل، فقد اقترب من السيارة وطلب من فهيم فتح الشباك، وتأكد من أنهما وحيدان، ثم مد يده إلى “عبه”، وسحب مسدسه المجهز بكاتم للصوت، وأطلق رصاصة في راس كل منهما…
عرف شريف بالأمر من الاذاعة، ثم اتصل ببيروت وتأكد من الخبر. لم يكن خبر الوفاة غريبا عنهم في تلك الأحداث، فكل شخص معرض لسقوط قذيفة بقربه أو إنفجار سيارة ملغومة أو حدوث إطلاق نار عشوائي أو لاختلاف بين مجموعتين في المنطقة ذاتها، أما “الجرائم” فكانت شيئا غريبا ومؤلما وقلما تحدث جريمة في داخل المنطقة الواحدة، لذلك فقد صعق الجميع للخبر سيما وأنه لم يشر إلى السبب.
تجمع الأهل والأصحاب في بيت شريف، وفتحت بيوت الجيران، وتوافد المعارف من كل المنطقة، فكثيرون لم يكونوا يعرفون الفقيدة، ولكنهم عرفوا بأنها ابنة أخت شريف، الذي يحبه الجميع وهو لا يفوت مناسبة في المنطقة لا يقوم بواجبه تجاه اصحابها، وقد توفيت بحادث مؤلم…
بقي المحبون يتوافدون إلى منزل شريف للتعزية مدة اسبوع، وكان إتصل ببيروت عدة مرات وفهم خلاصة حول الموضوع وغموضه، فقرر أن يتوجه هو إلى هناك للتعزية وحضور الأربعين، ولكنه كان مهتما أكثر بمعرفة اسباب الوفاة الخقيقية، ففي هذه البلاد يجب أن تعرف “غريمك” وإلا فلا يغمض لك جفن…
ركب شريف البحر بعد شهر من الحادث إلى بيروت، وقد دارت في راسه عدة سيناريوهات، وما أن وصل، وقام بالواجبات العائلية، حتى اتصل ببعض الرفاق النافذين للوقوف على الحقائق، فأخبره أحدهم بعد عدة ايام، وكان يعمل في جهاز أمن مهم، أن دارينا قد “تدخلت، وبطريق الصدفة، في قضية تتعلق ب”مافيا” كبيرة لا أنصح أحدا، في هذه الأيام، بمواجهتها”، وكانت قد وجدت جثة القاتل بعد اسبوع من الحادثة خارج المنطقة في احراج “المونتي فردي”…
تألم شريف لمقتل دارينا فقد كان يرى فيها طاقة هائلة وشخصية قريبة من القلب وثمرة صالحة لعائلة كانت تستحق كل خير وقد اعتبرها شهيدة أخرى على مذبح الوطن…