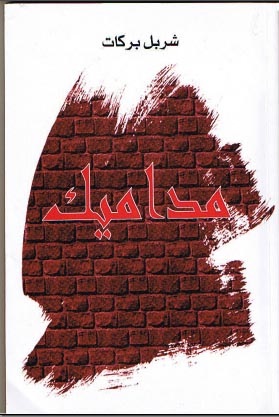كتاب الكولونيل شربل بركات “مداميك”/الفصل الثاني…الوصول إلى عين إبل/الحلقة الثانية
27 تشرين الأول/2020
ما أن وصلت السيارة إلى “بير التنية” حتى أطلت “العامرة” كما كان يسمي “أبو عماد” عين إبل، مشرورة على طول ذلك المنحدر الممتد من ضهر العاصي إلى المحفرة، تزينها من الغرب تلال مكسوة باشجار الزيتون والسنديان، وتبدو يد الفلاح وقد جللت قسما كبيرا من أراضيها، جنائن معلقة، كانت تزهر عنبا ولوزيات وتفاحا. وقد كان الجدود، منذ عودتهم إلى هذه المناطق، قد عمروها بالبساتين، فخبرة فلاحي الشمال اللبناني دفعت بسلسلة من الهجرات المتتالية إلى كل لبنان، عندما زال خطر المماليك، الذين أفرغوا المناطق القريبة من البحر ، حيث استطاعوا، من سكانها، خوفا من تعاونهم مع الفرنج. وكان الفرنج الذين طردوا من كامل الأراضي الساحلية في لبنان وسوريا وفلسطين، لا يزالون يجوبون البحر ويقتربون من الشواطئ. وقد هدم هؤلاء المماليك كل الحصون الساحلية والمدن الكبرى، وطردوا أهل البلاد من أراضيهم، بما فيهم الشيعة والدروز، فقد قضت فتاوى “ابن تيمية ” بحل قتل هؤلاء “الخارجين عن الدين” باعتبارهم من “الكفار”. وحدثت الحملة التي أفرغت هذه المنطقة من سكانها في أثناء انهاء الوجود الصليبي من صور وعكا، وخلال العمليات الحربية التي جرت آنذاك. أما افراغ كسروان، مثلا، فقد جرى بعد خروج الصليبيين، وخوفا من المتعاونين معهم وبخاصة من المسيحيين، وهكذا اقتلعوا السكان والاشجار وبذروا الملح في الأرض لكي لا تنبت، كما منعوا السكن فيها، وأعطوا الأمان فقط لمن يسكن ما وراء الجبل أي في البقاع. وكان على المسيحيين أن يهربوا إلى مناطق خرجت عن سلطة المماليك، وهي مناطق بلاد جبيل والبترون وبلاد بشري و”الزاوية”. وهكذا فعندما انكسر المماليك أمام العثمانيين، سمح هؤلاء، للعسافيين في البدء، باعمار كسروان، فامتلأت المناطق اللبنانية بالفلاحين المسيحيين الذين ضاقت بهم امكنة لجوئهم في بلاد جبيل و”الزاوية”، فخرجوا منها، مع ما لهم من الخبرة في استغلال الأرض، وتطويع الصخر، وتجليل المنحدرات، وزرعها بالوسائل البسيطة التي يدعمها الايمان، والجهد الفردي، وتقويها المثابرة وحب الأرض. خرجوا وانتشروا أولا في بلاد كسروان، ثم الشوف، حيث كان “الأمير” مدينا لهم بالحماية بعد مقتل ابيه “قرقماز”. ومن ثم الجنوب و”بلاد بشارة”، التي كانوا دوما جزءً أساسيا يزين ترابها، ويضيف إلى ألوانها مراكز استقرار على طريق القدس. هؤلاء الجدود الذين وصلوا في نهاية القرن السادس عشر سكنوا في “خربة عين إبل” حيث “قبر النصراني ” وبقايا الكنيسة وبعض أكوام حجارة البيوت التي ساعدتهم على الاستقرار.ثم بدأوا العمل في تطويع هذه الأرض وحثها على العطاء، وكان “البعل” سندهم، والثور والمحراث رفيقيهما، والجهد والمثابرة شعارهما، والعمل الطويل المستمر طريقة عيش أسهمت سريعا بتوطنهم، ككل المغامرين المرتحلين إلى أماكن جديدة في عالمنا الوسيع الذي لا يزال فيه مكان للجهد الفردي والمثابرة إذا ما ترافقا بهدوء سياسي يفسح المجال للنمو بدل التقاتل والارتقاء بدل التقهقر.
ويقال بأن “علي الصغير” الذي كان قد استعاد لتوه سلطته من ايدي أعدائه “آل شكر”، الذين قضوا على كل عائلته ولم تسلم الا والدته الحبلى به ، وكانت من “حوران” وقد فرت إلى بيت ابيها حيث ولد “علي” ونشأ ثم رجع ليثأر لعائلته، كان مارا في تلك المنطقة ليلا وسمع حركة وصوت تكسير صخور ورفع حجارة، فأرسل أحد رجاله ليستطلع الأمر، وإذا به يحضر معه رجلا يلبس شروالا ولبادة على راسه، عرف به أحد هؤلاء “النصارى” الذين قدموا حديثا وسكنوا “الخربة”. وعندما سأله عما يفعل في هذا الليل أجاب ذلك الفلاح، وقد عرف به زعيم هذه البلاد، أنه يريد أن ينهي الحائط الذي بدأه عند الصباح، فلديه عمل كثير ليقوم به قبل الشتاء، فهو يعيل أولادا صغارا، واذا لم ينه هذه الأعمال قبل موسم الأمطار فمن سينهيها؟.. ومن سيطعم الأولاد؟.. فأكبر “البيك”، ولم يكن بعد قد حمل هذا اللقب، به نشاطه وقال لمرافقيه: نحن بحاجة لمثل هذه العناصر الطيبة لتعمر الأراضي وتزدهر المنطقة، وقال لذلك الفلاح:
– هل لا يزال عندك أقارب أو أصحاب يريدون القدوم إلى هذه المناطق للاستقرار والعمل؟.. أرسل لهم ليحضروا فنحن بحاجة لهذا النشاط ولهذه الخبرات لاعمار البلاد…
وقصة هذا الفلاح هي قصة كل هؤلاء الذين سميت النجوم على أسمائهم والأراضي والينابيع، وقد زرعوا الكروم واقاموا المعاصر ونصبوا الزيتون “شجرة الخير المقدسة” التي ذكرت “التوراة” أن سكان هذه الأرض ينعمون بها؛ ف”أشير طعامه طعام الملوك وهو يغمس أرجله بالزيت”… وقد طوعوا الوعر، وأنبتوا الصخر، وزينوا المروج والتلال، ثم أقاموا بيوتا صغيرة بالحجم مملوءة بالخير والبركة، فصدق بهم القول: “فلاح مكفي سلطان مخفي” وقد وصف ذلك أحد أحفادهم بقوله:
“وشو همهم لو زمجر شباط واذار وعندن خوابي مجممي لشفافها “…
هذا الخير الذي تغنوا به زادهم تمسكا بتلك الروابي موطن استقرار بالرغم من كل شيء. وقد عانوا في البدء من ظلم هنا، وتعنت هناك، وتأثروا بحكم الجزار، ومظالم الأتراك، ونعموا بلبنان، الوطن الحلم، واستماتوا في سبيله، وها هم اليوم يرزحون مجددا تحت ذلك الحمل؛ الوطن الذي نهوى فنستشهد دونه، والواقع المر الذي يحيطنا تخاصما وتنافرا لا يخدم إلا الغرباء، وشتان بين من يبني للوطن ومن يهدم…
دارت السيارة باتجاه “دبل”. فقد أراد سعيد أن يوصل شريف إلى عين إبل قبل أن يذهب هو إلى رميش. وقد أطلت “دبل” ضيعة الشهداء، في هذه الحرب، حيث دفعت هذه القرية الصغيرة من الدماء في سبيل الوطن ما لم تدفعه أية قرية أخرى، فقلما يخلو بيت من صورة شهيد أو أكثر، وقد تربى الفتيان وأهلهم في المراكز الدفاعية، ثم لحقوا بهم شبانا مقاتلين. وفي الفترة الأولى كانت “دبل” تحت نار الفلسطينيين في “رشاف”، التي تشرف عليها، وتحصي كل خطوة لسكانها، وكان على الأهالي أن يدفنوا موتاهم أثناء الليل. لذلك، ومهما دفع أبناء دبل للبقاء في “رشاف” و”الجبل”، فهم يجدونه أسهل من أن يعودوا إلى ذلك الحصار المذل. وقد كانت دبل قبل الحرب آخر الطريق، لا يمر عليها إلا من يقصدها. لذلك بقيت منزوية على نفسها، مكفية الحاجات، منقطعة حتى عن الجيران حولها. أما اليوم وبعد فتح طريق “بير التنيه”، أصبحت ممر الساحل إلى الداخل، وقد ازدهرت وعمرت وكبرت وانتشرت على التلال المحيطة ووصلت إلى المرج. وها إن أغلبية أبنائها يعملون فيها ويسكنونها ويزيدون على مداميكها كل يوم.
كانت دبل في الماضي على طريق القوافل الصاعد من صور باتجاه فلسطين. وكان مركز “حزور” في وسط السهل قرب نبع ماء تكثر الأشجار حوله، محط قوافل ومركز استراحة، وقد حاول بعض المؤرخين أن يضع فيه مركز المدينة التوراتية “حاتصور” التي أسقطها “يشوع بن نون”، لتشابه الأسم، ولكن الممرات الضيقة التي تحيطها وعدم وجود السهول الكبرى التي تصلح لقتال العربات، حيث كان في “حاتصور” التوراة سبعمئة عربة قتال، يجعل مكانها في السهول بين طبرية والحولة مناسبا أكثر بكثير من محيط دبل ما يحمل على الاعتقاد بخطاء هذه المقولة، ويبقى اسم “حزور” المقام الذي يحترم حتى اليوم اسم لولي أو نبي أو اله قديم ربما يكون “عزير ” ذاته…
وصلت السيارة إلى قرب “بركة الحلاوة”، فاذا بنصف مجنزرة للجيش تقترب مسرعة. كان يقف خلف الرشاش “سليم” “ابن بوحنا” الذي كان ترك الخدمة مدة سنتين تقريبا، بعد خلاف مع مسؤول المركز الذي كان يخدم فيه. فكان قد نقل إلى صور في 1983، ثم إلى النبطية، وبعدها إلى العيشية حيث خدم مدة سنة، وقد طلب أن يشكل إلى منطقة قريبة من “البيت”، فلم يوافق له المسؤول على الطلب ومزقه بحجة أنه لا يريد أن يخسر عنصرا مثل “سليم”، فهو حقا كان عنصرا نشيطا، وقد انخرط في الجيش قبل الحرب ثم التحق ب”التجمع ” بعد الحوادث وخدم في عدة مراكز وكان شديد الانضباط وصاحب نخوة وتفان، وقد عرف معنى الكرامة بخاصة بعد أن خطف شقيقه “حنا” وقتل على يد الفلسطينيين، فكان “سليم” صاحب “قضية”، كما قال عنه “الشيف ادوار ” مرة، فكل يوم يرى أبناء شقيقه اليتامى. وقد كان والده “بوحنا” حمل السلاح هو الآخر أكثر من خمس سنوات بالرغم من عمره؛ “فالدفاع عن الأرض والعرض واجب على كل فرد، ولو لم نقف تلك الوقفة الشجاعة لكان مصير الكل كمصير شقيقك المرحوم حنا “، هذا ما كان يقوله له دائما “بو حنا”. كل ذلك صحيح ولكن هل يبنى الوطن عليه وحده؟ وكما يقال: “بلد بتحمل شخص بس شخص ما بيحمل بلد”. لذلك غضب سليم وترك “هذا الجيش ومن يخدمه” وتوجه إلى دبل ولم يقبل بكل الوساطات والمحاولات التي قام بها “ابو الياس ” وغيره من المسؤولين، ولم يعد يهمه إلا تلك البقرات التي اشتراها وبدأ بتربيتها ورعايتها، وقد اصبح عنده عشرة رؤوس يبيع منها في آخر السنة عددا من العجول ويبدل بعضها لتحسين النسل والحليب، وقد كان يبيع حليبا ولبنا لكل الضيعة على مدار السنة، كما يزرع “شكارة” قمح وشعير لموسم الشتاء والأيام “القاسية”. أما الشهر الماضي وبعد ذلك الكمين الذي أودى بحياة رفيقه “شبيب” وجارهم “زيد” فقد تحمس للعمل من جديد، وكان والده ووالدته في بيروت عند شقيقته “تريز”، فباع كل البقرات ل”أبو علي” دفعة واحدة، وعرف أنه خسر بها، ف”أبو علي” يقنص قنصا في الأيام العادية فكيف وهو يعلم أن “سليم” يريد التخلص من كل البقرات دفعة واحدة. ولم يؤثر الأمر عليه لأنه كان قد قرر أن يثأر ل”شبيب” و”زيد”. وهكذا فقد استأنف الخدمة في السرية نفسها التي خدما بها وتسلم إمرة فصيلة “الحقبان”…
كان مركز “الحقبان” من المراكز المهمة في المنطقة فهو يشرف على “ياطر” و”كفرا” وعلى الطريق المؤدية إلى صور من تبنين وهي تمر على “صديقين” حيث يوجد “حوزة”، وهي مدرسة دينية على الطريقة الإيرانية. وقد كانت هذه الحوزات تخرج المتطرفين الذين يشكلون العمود الفقري ل”حزب الله”. وكان بعض سكان “ياطر” فيما مضى قد عملوا مع “الجبهة الشعبية” وجعلوا من البلدة مركزا لتحضير العمليات ضد المنطقة، وعندما بدأت الانسحابات، أصر المسؤولون “عندنا”، أن تكون الحدود هذه المرة عند “الحقبان”، كي لا تصبح “ياطر” مجددا مركزا معاديا، فتتعرض “بيت ليف” والمراكز التي تحميها لعمليات تخريبية. إلا أن بقاء الأمم المتحدة على مفرق “صربين” وسماحها للفريق الأخر باستعمال محيطها للقيام بعمليات، ومرور طريق “الحقبان” من هناك بدل أن تمر مباشرة من الطريق التي فتحت في 1978والتي تقع تحت نار ونظر مركز “جبل حميد”، جعل ذلك المفرق منطقة اشتباكات، والعناصر فيه في حالة توتر بشكل دائم، مما أدى إلى تفاقم الأمور. وهكذا فإن كمينا نصب بجانب مركز الأمم المتحدة أودى بحياة “شبيب” و”زيد” وجرح أربعة عناصر. فقد فتحت النار، بعد انفجار عبوة في الملالة التي كانت تقلهم، من بناية الباطون الواقعة مقابل مركز الأمم المتحدة. ثم، عندما وصلت التعزيزات وحاولت المجموعة تطويق المقر لأن العناصر التي فتحت النار قد انسحبت إلى داخل مركز القوات الدولية، تصدت هذه القوات لعناصر الجيش ومنعتهم من الدخول، وقد لام أهل القرية آمر المجموعة لأنه قبل بالانسحاب بعد تلقيه أمرا من الاسرائيليين بذلك، ولم يقض على هذه المجموعة، ف”ذهابها بدون عقاب سيجعلنا ندفع ثمنا أكبر في المرة القادمة”، وقد كان هذا راي الجميع وبخاصة “سليم” وقد تحمس وأقسم بأن يعود إلى الخدمة ليعلم هؤلاء كيف يكون القتال… وهكذا صار فقد كان عاد إلى الخدمة قبل اسبوع عندما التقاه شريف وسعيد، في تلك الآلية بالقرب من بركة الحلاوة، في طريقهم إلى عين إبل…
صعدت السيارة إلى دبل في الطريق الجديد الذي يلتف حول القرية من الجنوب، وقد تناثرت على جانبيه المنازل المبنية حديثا لتزيد من اتساعها وتظهر الفوارق بين القديم المتجمع على بعضه والجديد المنتشر هنا وهناك، فقد كانت القرية فيما مضى تتكوم حول تلة الكنيسة واذا ما خرج بيت عن “الكوم” أصبح معلما كما في اغلب القرى الجبيلية، أما اليوم، فقد تجرأ البعض على الانفلات من الدائرة الصغرى واندفع باتجاه “البيادر”، حتى أن الكنيسة الجديدة تبعت هذا الاندفاع لتستقر إلى جانب “الدير” كبيرة متسعة يزينها برج جرس عال. ولو أنها ليست على تلة كأمها “العتيقة”، إلا أنها بجمال جحارتها واتساع واجهاتها وساحتها، تضفي رونقا على المكان.
أما الشارع الجديد فقد أعطى بعدا ومساحات أكملت الصورة، فبدت البلدة بحجمها الذي استحقته بعد طول معاناة. ويحيط بدبل من الشمال تلة “اميه” التي لا تزال مركزا اثريا فيه من الحجارة المشغولة والآبار ما يدل على تواجد سكاني قديم، ويتصل به من الشرق تلة “الجبيل” التي تحوي أيضا آثار، وعلى بعد كيلومتر واحد إلى الشمال منها تقع “بركة الحجر” وهي من المراكز الأثرية التي تستحق الذكر، ومن الغرب وفي وسط “وادي العيون” أو “وادي ايون” تقف تلة تشرف على أوله من الغرب وعلى آخره من الجنوب فهو يدور عند كعبها جنوبا، وقد كان هذا الوادي الطريق الرئيسي لقوافل صور والساحل إلى سهول فلسطين فيما مضى، وفوق هذا التل يقع قصر “عصيلة” وقد كان كما يبدو مركز حماية واشراف على هذا الممر المهم. بينما تسيطر “رشاف”، التي تذكرنا بإله الحرب الكنعاني “رشف”، على كل ما ذكرنا من الجهة الشمالية، و”قوزح”، التي يذكرنا اسمها كما هو بإله القمر الحوري، من الجنوب الغربي، وتظهر “عيتا الشعب” وهي ايضا حورية الإسم “آتا – ال – شوب” والاله “شوب” إله الحر الحوري، في أقصى الجنوب مشرفة على مرج دبل.
وإذ خرجت السيارة من دبل دارت الطريق بهم يمنة ويسرة بين تلك الروابي التي لم تزل مكسوة ببساط العشب الأخضر، حيث الربيع يتاخر هنا أكثر من الساحل، ولا تزال بعض الزهور تزين الحفافي في عدة أمكنة، وقد سرح قطيع ماعز في أول “دير- ياه”، وبدت الأراضي الزراعية وقد تلونت بالأحمر والأصفر المبيض، فتراب “البياض” يختلف من موقع إلى آخر، وقد “كرب” الفلاحون الأرض للزراعات الصيفية. ولو كانت أيام زراعة “دخان” لكنت ترى الآن الأراضي كلها ورشة تتزاحم لتنهي الزرع، هنا، بينما بدت الأتلام الخضراء في أكثر من قطعة تم زرعها، هناك، فالدخان شتلة صيفية أهم ما فيها أن الدولة كانت تشتري محصولها من المزارع فلا يضطر إلى التدليل على بضاعته، ولا يهمه التفتيش عن الشاري، وجل همه ينصب في ما يدفع له من ثمن للكيلو من قبل خبير “الريجي”… ولكن الحرب شلت هذه الزراعة وها إن أجيالا قد نشأت ولم ترى “أكباش” الدخان معلقة في المنازل ولم تعرف معنى لزرعه وقطافه و”شكه”…
ثم ظهر حرش الصنوبر، الذي زرعه الجدود ليكون لهم مكانا للتنزه، وهو يتفاخر بصنوبراته العالية على كل التلال المحيطة، فهو المكان الوحيد لرحلات الشباب وجلسات السمر وسهرات ضوء القمر، كما هو مركز مخيمات الكشاف في كل عام، فبعد أن كانت فرقة الكشاف تخيم كل سنة في منطقة من لبنان، وبعد أن تعرف الصغار، الذين كبروا على حب المغامرة والتجوال في جبال لبنان وأوديته، على قرى الشوف والمتن وحتى الشمال، جاءت الحرب لتحد من حركة الأجيال الجديدة وتلخص نشاطاتها في مخيم الصنوبر، وكأنهم عادوا، بعد سنين من الأمل بالوطن الكبير والجهاد في سبيله، إلى الأيام التي كانت فيها “حدود الدني شلقة حجر”. وها أن بناء يقام هناك بالقرب من الحرش يقال بأنه سوف يكون مستشفى للمنطقة ويرعاه “سيادة المطران” فهل سيكتمل في أيامنا؟ وماذا سيصبح الحرش عندها؟ ساحة لوقوف السيارات؟ أم حديقة خلفية للمستشفى؟ أم ماذا؟…
مرت هذه الأفكار بسرعة في مخيلة شريف فلم ينتبه إلا عند وصولهم إلى عين حانين التي كانت فيما مضى تعج دائما بالقطعان والرعيان والفلاحين وها هي اليوم قفر بعد هذه الحرب…
وصل شريف إلى عين إبل ودخلها من جهة المحفرة، حيث المثلث الذي يؤدي إلى “رميش” وقد زينته حديقة يتوسطها ثلاث قناطر كانت فيما مضى من الوسائل الحربية التي استعملها الفلسطينيون في احتلالهم لبنت جبيل وحربهم ضد عين إبل وهي كانت على ما يبدو، أجزاء متاريس من الباطون المسلح وقد ارتأى أبناء البلدة، تذكيرا بتلك الحوادث والتخلص من الفلسطينيين وأعوانهم ومشاكلهم، أن توضع هناك على المفرق بين عين إبل ودبل ورميش ثلاث قناطر للمثلث الذي يربط ثلاث قرى تضامنت لتبعد الخطر عنها وتبقى هناك في وسط حديقة رمزا يمثل الانتصار على الشر والقلق وتحويله إلى خير وطمأنينة، وقد حملت تلك الحديقة اسمي “نبيل” و”الحسون”…
كان نبيل في الرابعة عشرة من العمر يوم شارك ككل أولاد القرية بتحميل و”تحطيط” الذخيرة في “المركز”، وكان ينتظر يوم يصبح بامكانه أن يتدرب على اطلاق النار ليدافع عن البلدة. وكان أن قدر له، وبسبب قلة العناصر، أن يشترك في تدريبات للصغار على تفكيك السلاح وتركيبه وعلى اطلاق النار وبعض التدريبات الأخرى كبرنامج لدورة كان من المفروض أن تستمر ثلاثة ايام، ولكن ما حدث كان ضربة كبرى غيرت المقاييس وأحدثت جرحا كان موجعا، فقد كان “نبيل” يرافق شريف وشاهين إلى تلة “شرتا” ضمن تدريبات للأستطلاع، وفي طريق العودة إنفجر تحت الدولاب الأمامي للجيب الذي كانوا يستقلونه لغم أرضي مزقه فاستشهد على الفور.
أما “الحسون” الذي كان من المسؤولين في الدفاع عن البلدة، فهو تخرج من مدرسة الرتباء وخدم في عدة أماكن وقد واظب على العمل في فريق القيادة منذ بدء الحصار ولم يكن يقبل باقل من التواجد الدائم مع المتطوعين في كل مراكز المراقبة والدفاع. فالقرية كانت كلها جبهة وهي محاصرة من كل الجهات ما عدا الجنوب حيث كان يمكن ايضا التسلل، ولذا فقد كان من الواجب اليقظة خاصة على من كان يعرف معنى “الجهوز” ويفهم من الناحية العسكرية القدرات والامكانات. وقد استشهد الحسون ايضا بعد ثلاثة اشهر من “نبيل” وكان استشهاده مؤلما للجميع فترك أكثر من فراغ وعطل غيابه جزءً مهما من عملية الاستمرار…
وعلى بعد مئتي متر من ذلك المفترق يقع نصب آخر مما تزدان به عين إبل. فعلى يسار الطريق وأنت داخل إلى البلدة شكلان من الباطون المسلح كأنهما شراعان يحضنان جسما من الرخام ولوحة تذكارية وتتداخل أوسمة وشعارات هنا وهناك. هذا النصب تذكار لرفيق كان الكل يقدره وقد خاض معارك في هذه الحرب وتنقل بين المناطق مدافعا عن الوطن كله من شكا إلى زحلة ومن الأسواق إلى الزعرور ومن بسابا إلى الكحالة وتل الزعتر. لم يكن مرة من المتخاذلين ولم يسع إلى الكسب من هذه الحرب ولا كان من الراكضين خلف المناصب. لقد وضع الوطن نصب عينيه كما صور له دائما: شجرة باسقة تحمي حرياتنا وتحفظ تراثنا وتؤمن المستقبل والاستمرار، ولكنها لا ترتوي إلا بالدم، والدفاع عنها واجب مقدس. نشأ في بيت يزهو بالكرامات وفي بيئة تتغنى بالبطولات، فقصص الطفولة كانت عن “حنا الحاج” وهو عم أمه وكان ذاع سيطه يوم كانت الرجال تعد على الأصابع ويوم كان نفرا تركيا ينفذ حكم الاعدام بمفرده في تلك القرى دونما حاجة لقانون أو حاكم ودون معارضة تذكر. ويوم كان الغزو شريعة تقضي على غلات وأحلام هؤلاء الفلاحين المساكين، وكان “الحمدون” و”الهيب”، غزاة “العرب”، من جهة والعصابات والقبضايات والأزلام من جهة أخرى، تقض مضاجع الناس، كان اسم “حنا الحاج” يرعب الرجال فيحسبون له ألف حساب، وكانت قصصه وهيبته تخيف الصغار والكبار في محيط واسع، وحيث لم يكن للنصارى خارج الجبل أي شأن، أثبت أمثال “حنا الحاج” و”الدعبول” و”الهدبول” وغيرهم أنه يمكن الوقوف وإثبات الوجود حتى في ظل حكم اعتبر المسيحيين أهل ذمة يعيشون بحماية المسلمين ولا يحق لهم إلا ما يرى المسلم أن يعطيهم.
في هذا الجو نشأ “كيروز” وقد أعطي اسما فريدا يدل على الارتباط بالجدود في بلاد الأرز ويقوي الفخر والعزة ولا سيما في وقت كان للبنان وجهه المسيحي الذي أعطى لكل مسيحيي المشرق أملا وسندا، وإن لم يكن حقيقيا، فالمستضعفون يقويهم الأمل، والأمل ليس أكثر من وهم، في كثير من الأحيان، ينمو في الجماعة فيغزي فيها العنفوان فتتشدد، وإذ تبدو كذلك يقف أمامها الناظرون مشدوهين، فتسير بقوة الدفع ويتعامل معها الكل على هذا الاساس. ولذا فإن التخوف من أن تزول “الوهرة”، وأن “يكبو الجواد” أو “تزل القدم”، يخيف المجموعات الضعيفة أو القليلة العدد نسبيا، فتستميت للبقاء، وتقاتل للأستمرار. من هنا كان إسم لبنان ولا يزال يحرك الأفئدة ويدب الحماسة في نفوس هؤلاء.
وكان “كيروز” من أولائك الذين إذا ما سمعوا النداء لبوه، وقد خدم في الجيش إحتياطيا لمدة سنة، ثم اندفع إلى الالتحاق بالمجموعات التي حمت الأحياء منذ انطلاق الرصاصة الأولى في 1975 وحتى استقرت في قلبه تلك الرصاصة على تلة “البنيه” يوم دحر العدو واحتلها فثبتها ثم رواها بدمه وغاب إلا من ذاكرة المحبين وذلك النصب التذكاري في مدخل البلدة…