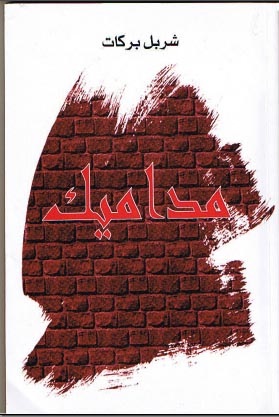كتاب الكولونيل شربل بركات “مداميك”/الفصل الأول/الحلقة الرابعة
19 تشرين الأول/2020
كانت الشمس قد اشتدت حرارتها وبدأ التململ ينتشر بين الركاب على سطح العنبر. كان هناك في الجهة الأمامية مجموعة من الشباب والصبايا العائدين من بيروت بعد رحلة قاموا بها إلى “الشرقية” للتعرف على لبنان، فأغلبهم لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر، ولذا فهم لم يعرفوا لبنان قبل الحرب، ولم يكونوا في 1982 في سن تسمح لهم بالنزول وحدهم إلى بيروت. واليوم منهم من بدأ يعمل ومنهم من التحق بالجيش وأغلبهم أنهى دروسه الثانوية وأصبح لديه امكانية التخطيط لمشاريع خاصة به، ومنهم من لا يزال ينتظر أوراق الجامعة ليعود إلى الدراسة في العام القادم. وكان “عماد”، أحد هؤلاء الشبان ينوي الدخول إلى الحربية وقد سمع أن الطلبات تقدم في هذا الوقت. فقرر النزول إلى بيروت لتقديم الطلب وقد أقنع “سليم” والآخرين أن يذهبوا معه. وكانت “ريما” شقيقة “سليم” تريد هي ايضا أن تستفهم عن طلبات كلية الهندسة في الجامعة اليسوعية. فوالدها الذي يعمل في “أبو ظبي” قد وافق قبل أن يسافر في نيسان الماضي أن تدرس هندسة الكومبيوتر في اليسوعية وهو مستعد لدفع الأقساط مهما كلفت. المهم أن تنجح. وهي، معروف عنها، أنها الأشطر في مدرستها. وإذا كان “ساكو” و”لويس” استطاعا أن يتابعا علومهما هناك بنجاح فبامكانها هي ايضا ذلك. وقد تبرعت خالتها “ماري” التي تسكن في “جل الديب” باستقبالها عندها إذا كانت تنوي فعلا أن تكمل دراستها في بيروت. فالمشكلة الأصعب على جميع تلامذة المنطقة هي السكن. فلا مشكلة إذا، وهي واثقة من نفسها، إذ أن معدل علاماتها في “الترمينال” كان 17 على 20 وقد جمعت 85 نقطة زيادة على المعدل في الشهادة العام الماضي، ولكنها لم تذهب إلى بيروت لاكمال تعليمها لأنها لم تكن قد قررت بعد ماذا ستفعل، فلم يكن والدها قد أتى بالصيف إلى عين إبل للتداول بهذا الموضوع.
كان “سامر” منزعجا من الأمر فقد بدأ يهوى “ريما” بجد خاصة بعد تلك السهرة، فهو ولو كان عنده من نفسه ويثق بكل أعماله وكل الصبايا تتمنين أن تكلمه، كونه الشاب الأكثر نشاطا واندفاعا بين “الربع”، وصحيح أن والده قد استشهد وهو لم يزل يافعا، إلا أنه كان دائما من الأوائل بالصف حتى السنة الماضية حيث قرر أن يتفرغ للعمل. ولم يشأ أن يحلم باكمال دروسه في بيروت. وقد كان منذ ثلاث سنوات يعمل صيفا مع “المعلم سامي” في تمديد المواسير. وقد تابع دورة لمدة شهر مع ال YMCA قي بنت جبيل وكان من أبرع التلامذة. وقد شجعه “المعلم سامي”. ومنذ السنة الماضية بعد “الترمينال” إنكب على العمل بجد وبدأ يلتزم ورشا لحسابه. وقد كان دائم الاعجاب ب”ريما”. ولكنه لم يجرؤ على الاقتراب منها أو يحلم بأن يصبح “صديقها” بالرغم من أنه كان يشعر بأنها تشجعه في أثناء مباريات “الباسكيت”، فهو كابتن الفريق. ولكن شخصية “ريما” تفرض هالة من الاحترام حولها وبالرغم من كونها أكثر الصبايا مزاحا إلا أن الجميع يخشونها، ولم يجرؤ أحد أن يدعي بأنها “صديقته”.
في تلك السهرة يوم كانت حفلة نجاح “ريما” التي دعت إليها كل الأصحاب، قامت هي بدعوته إلى مراقصتها، “لأنه الشاب الذي نافسها على المعدلات العالية في المدرسة وفي الشهادة”، وهكذا وبالرغم من احساسه بالحرج قليلا إلا أنه شعر بفرح لم يسبق له مثيل، فقد شرب البيرة بنهم للمرة الأولى، وعاود الرقص مع “ريما” عدة مرات. وفي آخر السهرة عندما خف الصخب خرج إلى الشرفة وجلس وحيدا، وكانت السماء في أجمل أيامها صفاء ونجومها تضيء الليل مشعة كما لم يرَ من قبل، وكانت هذه الزاوية من المنزل تطل على الوادي الذي بدأ الضباب ينساب اليه وكأنه البحر يزحف مغطيا شيئا فشيئا تلك الكتل الهرمة من أشجار الزيتون والسنديان التي تتزاحم لتملأ المنخفضات. وإذا ب”ريما” تقف إلى جانبه وتستأذنه بالجلوس. لم تسعه الدنيا. فهل كان يحلم؟ ففي نفس اليوم، يراقص “ريما” ويفرح كل الفرح، ثم ماذا؟ تأتي هي لتطلب منه الجلوس بقربه، في ذلك الجو الرومنطيقي…
مضى ذلك الليل. ما أقصره… فهل كل الساعات الحلوة تمر هكذا بلحظة عين؟
بقي “سامر” يذكر تلك الليلة، وقد أمسك بيد “ريما” وراحا يتحادثان بصمت العاشقين. كان قلبه يتكلم أكثر من لسانه. وكانت هي برقتها وسلاسة حديثها تسأل وتجيب. لم يتذكر من الحديث شيئا. لكنه ظل يذكر الجو كله والتناغم بين اللمسة البريئة التي سرت في جسده جداول من الأحاسيس، والصوت الدافئ الذي طار به إلى غير سماء. لم يستطع أن ينظر في عينيها ولا اقترب أكثر، مع أنه أحس برغبة في الالتصاق بها وكأن شيئا يجذبه. ولكنه أراد أن يبقى في نظرها ذلك الشاب المهذب الذي لا يستغل الظرف. أو أنه لم يرد أن يفسد بحركة ما ذلك الجو الذي تمنى ألا ينتهي.
تلك كانت المرة الوحيدة التي انفرد بها مع ريما، ومنذ ذلك الوقت وهو يحلم بها كلما اختلى بنفسه، وإذا ما رآها في الشارع، رف قلبه وتعمد أن يلفت نظرها. وكانت هي كعادتها تبتسم له وتحييه. ولكنه أصبح يحس بلحظ عينيها أكثر فأكثر ويشتهي أن ترمقه بنظرة منها. لذا فعندما قرر عماد وسليم النزول إلى بيروت برفقة ريما وهند وأمال تحمس للموضوع وهو الذي فتح باب رؤية لبنان بلدنا الذي لا نعرف عنه شيئا. وبالرغم من أنه قد التزم ورشة كبيرة في يارون، إلا أنه عمل أسبوعا كاملا حتى ساعات الليل ليتمكن من انهاء تمديد “السواد”، وقد كان يصطحب إثنين من العمال حتى ينهي العمل قبل الذهاب إلى بيروت.
بقرب هذه المجموعة من الشباب والصبايا، جلس راهب من البلديين، على ما يبدو. كان مظهره يدل على أنه قد تقدم بالعمر. وقد ابيض ما تبقى من شعر على راسه وتناثر خصلا خفيفة فوق هامة تلامس أطرافها شبه دائرة تبدأ من فوق أذنيه وتدور باتجاه الرقبة حيث يبدو التجعد في الجلد متأثرا من افح الشمس لتظهر خطوطه جلية. ويبدو من ردائه المغبر الذي أكلت الأيام من أطراف ياقته، وأخذ الحزام مكانه فيه حول الخصر فلا يضيع، أنه يخدم في احد الأديرة النائية في منطقة جزين. هذا الراهب الهادئ كان يرى في هذه المجموعة، أمسه الضائع أو مستقبل البلاد. وفي الحالتين فقد ظهر حنانه لهم، فبعدما حميت الشمس وبدأ التململ، سحب منجيرته من تحت ردائه وأرسل لحنا كألحان الرعيان في الجرود جمع حوله أولئك الفتية فتكوموا يستأنسون ويطيبون. ثم ما لبث، بعد انهائه ذلك النغم، أن بدأ يعزف لحنا كنائسيا رددته أمال التي كان صوتها يناسب كل الألحان. فهي منذ صغرها تخدم في جوقة الكنيسة، وقد رافقت “سور ماري اميلي” في آخر أيامها في الدير و”سور كلود”. وهي تدير اليوم الجوقة الكنائسية وتعرف كل الألحان الجديدة والقديمة، حتى أن “المطران يوسف” نفسه أشاد بصوتها، وهو الذي قلما يعجبه شيء أو يظهر ذلك الاعجاب. عندما رنمت أمال: “جبريل وافاكي يهديكي السلام…”، بدأ الجميع يردد معها شيئا فشيئا بصوت منخفض. ثم أخذت تلك الموجة طريقها إلى أكثر من مكان، وكأنها العدوى وقد دفعها صوت أمال أو نغمة المنجيرة أو توق الناس إلى تغيير الروتين، أو الترتيلة نفسها التي كانت الأكثر شعبية بين هؤلاء القرويين، أو كون “السلام” المنشود هو الحافز الذي يكمن في اللاوعي عند الجميع، خاصة في هذه الظروف الصعبة. وما أن أنهى الراهب تنغيمه حتى كان جميع من على الجسر يصغي. ثم أرسل لحنا رحبانيا إنطلقت معه أمال والمجموعة كلها وبدأ التمايل ووقع الكف كأنه ايقاع الطبل والدربكة معا وكانت “نسم علينا الهوى” أغنية “الربع” عندما يجتمعون في سهرات الصيف. ومن أغنية إلى أخرى غيّر ذلك الراهب جو الضجر والملل اللذين كانا قد سادا، وكأن حرارة الشمس الزائدة لم تعد تؤثر عليهم، وساد المرح هنا والرقص هناك ونسي الجميع هموم السفر، حتى “بو حنا” كاد أن يبتسم عندما زق “نجيب” وهو يرقص بين صناديق البيرة. كان نجيب يحاول جاهدا أن يصبح تاجرا وقد اشتغل بكل شيء حتى أنه حاول اليوم المتاجرة في البيرة معتمدا على المطاعم التي تخدم قوات الطواريء الدولية في الناقورة.
كان “نجيب” في أواخر الثلاثينات وقد التحق في سلك الدرك وخدم في أغلب المناطق اللبنانية. وهو يعرف الكثير من الأشخاص وله أصدقاء في كل المناطق. ولولا الحرب لكان اليوم في أحسن حال، كما يقول. حاول “نجيب” أن يتاجر مع اسرائيل ولكنه خسر في الفاكهة، مع أنه في 1982 كان ينقل كل يوم شاحنة “سكسويل” إلى بيروت. ولكنه “لعب على الكبير” ولم يكن “ع قد الحمل” فخسر وكاد أن “يتبهدل لولا أولاد الحلال”، وها هو اليوم يحاول من جديد. وخطر له أن البيرة اللبنانية مرغوبة عند الأجانب وقد فضلوها على ال”هاينكن” المستوردة. فنزل إلى بيروت وتعرف إلى مدير المبيعات في “المازة” وكان من أبناء المنطقة فسهل له أن ينقل شحنة وها هو يحضرها معه على ظهر هذه الباخرة، وقد وضع قسما في العنبر وترك بعض صناديق الكرتون أمام عينيه بين المسافرين. وعندما طرب “نجيب” وحاول أن يرقص، زحط بين الصناديق وأضحك الجميع حتى “بو حنا”. ثم عاد فنهض وفتح أحدها ووزع بعض الزجاجات، ولكن كثيرين امتنعوا، فالبيرة باتت ساخنة من الشمس، والكل يعرف أن “نجيب” في هذه الأيام “على قد حاله” واذا ما انحشر فلا يتراجع، لذلك لم يشاءوا أن يدفعوه إلى الخسارة من جديد وبدون سبب. أما هو فكان يلح على الجميع، حتى أنه أراد أن يسقي “ام حنا” و”بوحنا” بالقوة لولا ذلك الصوت الذي جعله يتوقف، فقد أطلق الراهب نغما استفذ “جريس” صاحب الصوت الجميل، فبدأ موال “موعود بعيونك أنا موعود…” وكان جريس من القليعة في القطاع الشرقي. وقد كان عائدا من بيروت مع أصدقاء آخرين تعرفوا بمجموعة عماد وسامر وربعهم في رحلة الذهاب وأمضوا معا في “الشرقية” بعض الوقت في زيارات وسهرات. فهم من نفس الجيل وقد كان أغلبهم، كرفاقهم، ينزلون إلى بيروت للمرة الأولى. وكان يظهر على سامر انسجامه الكلي بالموال. ف”ريما” هي صاحبة العيون السود وهو يحس دائما أن هذا الموال يصور حالته. ثم أكمل جريس ب”عا هدير البوسطة…” وكأن هدير الباخرة وعجقة الركاب هي نفسها هدير بوسطة تنورين، وقد ترددت الكلمات مع صوت جريس العذب وأنغام الراهب الشيخ وانسجام الحالة عند الجميع، لتعطي انطباعا وكأن الأغنية هي لتلك الباخرة وركابها أكثر من ركاب “بوسطة تنورين”…