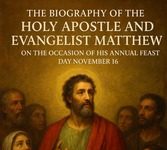بين زمنين… اللبناني والجزائري
في لبنان غابت السياسة وطويت صفحتها، ولم يبقَ أمام الفريق الحاكم من أولوية إلا اليوميات والمصالح الصغيرة، والموجع جداً أن «السياديين» السابقين تخلوا عن ناسهم، وهم قوتهم، ويغطون مواقعهم الجديدة بأحاديث عن «الاعتدال» وعن «العقلانية»، بعدما أسقطوا من حسابهم تلك الشعارات الجامعة والمدوية؛ حرية، سيادة، استقلال، رغم أنه من دونها كل استقرار هو زائف والبلد يستمر رصيف هجرة للشباب.
حنا صالح/الشرق الأوسط/14 آذار/19
تصادف اليوم الذكرى الـ14 لـ«انتفاضة الاستقلال»، يوم تجاوز نحو المليون ونصف المليون لبناني مربعاتهم الطائفية، والتقوا بوصفهم مواطنين وسط بيروت، قبضة واحدة ضد القتل والاحتلال، فنجحوا في هزِّ نظامين أمنيين في لبنان وسوريا، وهدروا بصوت واحد مطالبين بالعدالة للبنان. كان يجمعهم الأمل بأنه أزفّ زمن قيام الدولة المدنية السيدة التي تضمن الحقوق وتساوي الفرص، بحيث يتحول الكيان اللبناني إلى الوطن المنشود الذي يعيش فيه الجميع مواطنين لا رعايا ولا أتباعاً.
بعد 14 سنة، تتركز اليوم أنظار هؤلاء على الحدث الجزائري، تذكروا كيف تكوكبوا إلى وسط بيروت يستظلون العلم اللبناني دون سواه، وملأتهم المشهدية الجزائرية فرحة لا توصف وقد صنعها الملايين من نساء الجزائر وشبابها والمجاهدين وكل الفئات، استظلوا جميعاً العلم الجزائري، وقالوا كلمتهم الهادرة بثبات ورقي وهدوء وحزم. اللبنانيون اليوم يشعرون بالأسى والأسف على الزمن اللبناني، ويشعرون بالفخر بالزمن الجزائري.
لنبقَ في الحدث الجزائري؛ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توج مسيرته المشرفة كأحد رجال الثورة الجزائرية وأبرز بُناة الدولة، بالاستجابة إلى أصوات الملايين، فبادر إلى اتخاذ خطوات كبيرة تمهد لقيام الجمهورية الثانية، ويؤكد من خلالها أن مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار.
طال بقاؤه في القصر، وربما فكر في بعض الأوقات بأن إقامته يجب أن تطول أكثر، لكن الرئيس الرمز انحنى أمام العاصفة من أجل الجزائر، وهو من ابتدع سابقاً الوئام الوطني لإخراج وطنه من «العشرية السوداء» وتحقيق المصالحة الوطنية، فقال للمعترضين – عن حق – على «العهدة الخامسة»، وصلت الرسالة، وأُعلن سحب ترشحي، وقراري هو الخروج من المشهد السياسي، ومهمتي الأخيرة المساهمة الجادة في تحقيق انتقال سياسي سلس.
غيره في ليبيا مثلاً استطاب حياة القصر، فوصف كل أبناء الوطن بالجرذان، والآخر في سوريا اتهم مواطنيه بالإرهابيين، فاستقدم جيوش الأرض وميليشياتها لقتل شعبه، الذي تجرأ على المطالبة بالرغيف والحرية والديمقراطية، وتفاخر بصفاء النسيج الشعبي بعد اقتلاع نصف السوريين وتهجيرهم.
طبعاً التحرك الشعبي الجزائري كان غير مسبوق، وبدت معه البلاد التي استكانت طويلاً إلى الهدوء منذ «العشرية السوداء» وكأنها استعادت حيويتها، وهي تزخر بالطاقات والكفاءات، فتلونت بالخروج الكثيف للنساء والشباب، في إشارة واضحة إلى استفحال الوضع، وقد رفعوا شعاراً مركزياً؛ لا لـ«عهدة خامسة»، ولا لهذا الاستئثار من جانب المجموعة المتحكمة. فكان رد بوتفليقة من نفس المستوى: «أتفهم ما حرّك تلك الجموع الغفيرة… ولا يفوتني مرة أخرى أن أنوّه بالطابع السلمي». وأعلن عن القرارات السبعة، وأبرزها انسحابه من الرئاسة والحياة السياسية، والتركيز على «ندوة وطنية مستقلة» تُعدُّ دستوراً جديداً وإصلاحات شاملة، ستشكل الأساس للانتقال إلى الجمهورية الثانية، التي ستكون بمثابة الإطار للنظام الجزائري الجديد، متعهداً بأن تشرف على أعمال الندوة هيئة تعددية، بات من شبه المؤكد أن رئاستها ستسند إلى الأخضر الإبراهيمي، عضو مجموعة «حكماء الاتحاد الأفريقي» ولجنة الحكماء التي أسسها مانديلا، وتواكب هذه الندوة حكومة كفاءات وطنية، تكفل الحرية والنزاهة والشفافية.
نجح السياسي المنهك جسدياً في تجديد الوئام الوطني، وقطع الطريق على التصعيد والمواجهة، وحال دون «سورنة» الجزائر؛ خصوصاً أن هناك فئات غير عابئة بالمصالح الحقيقية للجزائريين، وهي حاولت القفز على التحرك الشعبي واختطافه وفشلت!
ما تحقق في الجزائر بعد الهبة الشعبية المستمرة منذ 3 أسابيع مهم وكبير ومفرح، لكن لا شيء نهائياً بعد. والصحيح أن أكثر الممسكين بناصية السلطة لن يتراجعوا بسهولة، وسيعملون على إعادة إنتاجها، رغم أنهم خسروا جولة أساسية، والأسئلة تبدأ ولا تنتهي حول الجهات القادرة على التوظيف، والدور اللاحق للجيش، وهو الذي وقف إلى جانب الرئيس في كل الإجراءات التي أُعلن عنها، ما يعني أن الحاجة لدور الشارع ستكون أكبر، وأموراً كثيرة تتوقف على القدرة على إنتاج صيغة جبهوية موثوقة، بعدما تحرر شباب الجزائر من الخوف والترهيب، وأسقطوا التبعية، وهم على بينة أن الأحزاب الديمقراطية التقليدية في الجزائر على وجه العموم هي إطارات صالونات محدودة التأثير.
مفرح هو الزمن الجزائري، وبائس هو الزمن اللبناني، فمنذ اللحظة الأولى للحدث اللبناني في 14 مارس (آذار) 2005 حاصر المتسلقون الحدث، وتقدم الطائفيون، وفرضت القيود على الشارع، وتباعاً جرى إبعاد الديمقراطيين؛ تنظيمات ومستقلين، وهم كانوا يشكلون قلب التحرك وروحه، وبات التذمر علنياً من كل صاحب رؤية. وإلى إمعان أعداء لبنان باغتيال القادة الرئيويين، تقدمت الأحزاب الطائفية ووضعت يدها الثقيلة على الإنجاز… والهاجس الدائم لأحزاب الطوائف كان تحاصص البلد والسطو على مقدراته وإفقار شعبه، ومن أجل ذلك لم يقصر أركان الانقسام الآذاري العمودي، فاستثمروا في الانقسام الطائفي، وبرعوا في تحويل أتباعهم مطايا مصالح صغيرة ودنيئة، بحيث بات كل انتقاد للارتكابات يحولونه إساءة إلى الطائفة.
غاب عن حركة «14 آذار» مشروع إعادة بناء الدولة وإعادة الاعتبار للدستور، وكان يجب أن يكون الأساس بعد خروج الجيش السوري استكمال بسط سيادة الشرعية دون سواها وعدم الرضوخ للسلاح غير الشرعي، وتغول الدويلة على الدولة، فأخذهم «حزب الله» إلى الدوحة في العام 2008 وعادوا سوية يحكمون البلد بالتسويات والبدع على حساب الدستور والقانون، ليتوجوا هذا المنحى بالتسوية في العام 2016، وجوهرها الموافقة على الأجندة السياسية لـ«حزب الله»، مقابل مكاسب وحصص تُترجم بمقاعد وحقائب وزارية، وكل ما يجري منذ ذلك التاريخ حتى انتخاب برلمان العام 2018 وتشكيل حكومة «إلى العمل» هو الإمعان في مسار المحاصصة الطائفية والتخلي عن القرارات الرئيسية، ما عبّد الدرب لاستتباع البلد لمحور الممانعة، وكل طروحاتهم انطلقت من مقولة إن السلاح بات مسألة إقليمية فوق طاقتهم، ويتهمون كل من يرفض الواقع المفروض أنه يستخف بالسلم الأهلي، كي يتهربوا من مسؤولية نقاشه ولإبقائه على الطاولة.
في لبنان غابت السياسة وطويت صفحتها، ولم يبقَ أمام الفريق الحاكم من أولوية إلا اليوميات والمصالح الصغيرة، والموجع جداً أن «السياديين» السابقين تخلوا عن ناسهم، وهم قوتهم، ويغطون مواقعهم الجديدة بأحاديث عن «الاعتدال» وعن «العقلانية»، بعدما أسقطوا من حسابهم تلك الشعارات الجامعة والمدوية؛ حرية، سيادة، استقلال، رغم أنه من دونها كل استقرار هو زائف والبلد يستمر رصيف هجرة للشباب.
سمير قصير أحد أبرز رموز «انتفاضة الاستقلال» تصدى قبل اغتياله لمنحى هذا التوظيف للانتفاضة، فدعا إلى «العودة إلى الشارع كي يعود الوضوح». كل المؤشرات تشي الآن أن الجزائريين لن يتركوا الشارع، ولن يسمحوا بإعادة إنتاج صيغة الحكم نفسها، والتاريخ لن يعود إلى الوراء، وربما تلفح رياح الأطلس لبنان مجدداً، خصوصاً أن التوازن الشعبي ما زال قائماً.