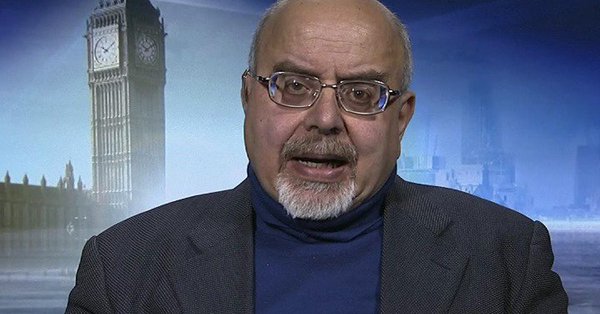أمتنا العربية… وخواصرها الرخوة
إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط/20 كانون الثاني/19
أُعلن قبل أيام عن زيارة ينوي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، القيام بها إلى تشاد، وترافق هذا الإعلان مع جولة قام بها وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إلى العراق شملت جولات غير مسبوقة على مكوّنات مؤثرة في نسيجه الداخلي الذي قلما بدا هشاً كما يبدو اليوم.
هنا، أتذكر «خريطة العالم العربي» التي كثر تداولها في عدد من وسائل الإعلام، وغدت شعارات لبعض التنظيمات القومية إبان حقبة السبعينات والثمانينات. ومعها أتذكر بعض الخطاب القومي الذي غلبت عليه النزعة الشوفينية – العرقية على حساب مبادئ راقية كاحترام الحريات العامة، والرأي الآخر، و«دولة المؤسسات»… وغيرها.
في تلك الحقبة، كنا نكرّر شعارات طيبة المقاصد وسليمة الطوية مثل «لا صوت يعلو على صوت المعركة».
المبالغة والإفراط في «القومية» بوجهها العنصري الفئوي، ولو من منطلق جمع الشمل ورص الصفوف ضد الاستعمار والانتداب، كانا لا بد أن يثمرا بحكم المنطق ردة فعل نافرة من أقليات وجدت نفسها غريبة عن هوية مفروضة عليها «من فوق»، أو على الأقل، غير معنية بها.
ولمّا كانت هناك جهات تغذي نوازع التفرقة والتفتيت في عالمنا العربي، منذ عقود سحيقة، استمر النفور… إلا أنه كان يخبو لبعض الوقت ثم يطفو على السطح، بالتوازي مع «الصعود» و«الانحدار» في عافية «الأمة» وأوضاع المنافحين عن «الهوية العربية»…
في مواسم «الصعود» كان الكل مستفيداً، لأن للنصر – كما يقال – مائة أب، بيد أن الحال كان ينعكس في فترات «الانحدار» فتنتعش الحساسيات الفئوية، عرقيةً كانت أم دينية أم مذهبية، وتخرج الدعوات الانفصالية… وتنشط حملات تتراوح بين إعادة تعريف الخصوصيات ولا تنتهي بالاستقواء بقوى خارجية أملاً في تغيير الخرائط وتبديل ميزان القوى.
قبل نكسة 1967، بلغ الأمل القومي الأوجّ تحت خفق بنود وعد «الأمة العربية الواحدة من المحيط إلى الخليج». غير أن تلك النكسة أزالت غشاوة من الوهم كانت تدغدغ المشاعر.
لا شك، تفاوتت ردّات الفعل.
البعض وجد المناسبة سانحة لتصفية الحسابات السياسية، وهذا من حقه. وهناك من استسلم لليأس، وانصرف بفكره وجسده بعيداً تماماً عن السياسة. وثمة فئة ثالثة باشرت البحث عن بدائل عملية لاقتناعها بسقوط ما سمته «النظام السياسي العربي»، وعلى الطريق وجدت خيارين متناقضين:
– فكرة «حرب التحرير الشعبية»، عبر المنظمات الفدائية الفلسطينية التي صارت عند كثيرين حتى سبتمبر (أيلول) 1970 البديل الوحيد.
– التسوية السلمية، كما فعل الرئيس المصري أنور السادات، الذي اعتبر أنه ما دامت إسرائيل هي واقعياً «الولاية الأميركية الـ51»، فإن الولايات المتحدة لن تسمح أبداً بهزيمتها. ومن ثم، فإن أوراق الحل كلها في أيدي واشنطن.
سقوط «حرب التحرير الشعبية»، بدءاً من الأردن، ثم لبنان… اكتملت أبعاده بخروج الاتحاد السوفياتي من معظم المنطقة بعد طرد الرئيس السادات الخبراء السوفيات، ومن ثم انهيار الاتحاد السوفياتي نفسه تحت «إشراف» ميخائيل غورباتشوف وبوريس يلتسين في مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي.
عند هذه المحطة، في غياب البديل القومي و«اليساري»، وبالتوازي مع صعود اليمين الديني في إيران وإسرائيل، ثم في تركيا، كان بديهياً أن تهب عواصف مماثلة على العالم العربي.
في مصر، كان متوقعاً خروج مارد «الإسلام السياسي» من قمقمه في مشروع بناء هوية سياسية متميّزة خاصة بعهد السادات، الذي روّج له مناصروه لقب «الرئيس المؤمن»، بعد ضرب بقايا الناصرية الأمنية المسماة «مراكز القوى». وعلى مستوى المنطقة ككل، في غياب القوى العقائدية المقاومة لـ«الإسلام السياسي» بوجهيه الشيعي والسنّي، تقلص كثيراً الهامش أمام مناوئيه… وبالأخص، داخل النظام السياسي العربي.
أكثر من هذا…
في العراق وسوريا، تحديداً، حيث كانت السلطة نظرياً لحزب «قومي» و«يساري» (اشتراكي) فإن حزب البعث العربي الاشتراكي، فقد «يساريته» الاشتراكية بعد عقود من انفراده بالسلطة. وخسر «قوميته» عندما طغت الولاءات المذهبية والمناطقية على قيادته الفعلية، ومؤسساته الأمنية. ولم يطل الوقت، حتى غدا «الإسلام السياسي الشيعي» مصدر تحدٍّ لنظام بغداد – بدعم مباشر من إيران – و«الإسلام السياسي السنّي» مصدر تهديد لحكم دمشق. كذلك في فلسطين، بعد سنوات من التجاذب والتنافس بين تشكيلة متنوعة من التنظيمات «القومية» و«اليسارية»، ظهر «الإسلام السياسي» هنا أيضاً، ممثَّلاً بـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي».
بل حتى في دول المغرب، اكتسبت الهوية الأمازيغية زخماً جديداً، وهذا أمر طبيعي، بعد ترهل «العروبة» و«ردكلة» الإسلام!
هذا الوضع ما كان بحاجة إلاّ إلى صاعق تفجير، ليُدخِل المنطقة المأزومة اقتصادياً وبيئياً وسياسياً، كلها في المجهول. وحقاً، تأمَّن هذا الصاعق يوم 11 سبتمبر 2001.
في ذلك اليوم، وفّرت الاعتداءات الإرهابية على نيويورك وواشنطن وريف ولاية بنسلفانيا الذريعة لهزّ البنية الإقليمية الهشة. وكانت الخطوة الأولى غزو العراق عام 2003، ومع الغزو أسقط أول أحجار «الدومينو»، وبعده – كما نعلم – «كرّت» السبحة!
بدأ الكلام يأخذ طابعاً جدياً عن «الفوضى الخلاّقة»، ولم يطل الوقت حتى بوشر بالتنفيذ. وبررّ التمدد الاحتلالي الإيراني ولادة تيارات التطرّف المسلح «القاعدي»… ثم «الداعشي».
عام 2005 اُغتيل رفيق الحريري في لبنان، وانسحبت القوات السورية منه لتتولى أمره إيران عبر «حزب الله». وانطلق العد العكسي لانفصال جنوب السودان (أُنجز عام 2011). ومن تونس إلى سوريا، عبر مصر واليمن… وأخيراً السودان، رُفع شعار «الشعب يريد تغيير النظام»، فتنوعت المعاناة واختلفت النتائج.
عودة إسرائيل إلى تشاد، حيث تعيش عبر الحدود مع ليبيا والسودان مكوّنات قبلية مشتركة مثل التبو (الذي ينتمي إليهم الرئيس إدريس دبّي) والفور… تطوُّر مهمّ.
كذلك مهمٌّ دخول إيران في النسيج العشائري العراقي، كما دخلت من قبل في قلب الحسابات الكردية، وعملية التغيير الديموغرافي في سوريا ولبنان…
ولا ننسى الطموح التركي، المستند إلى حنين لماضٍ من النفوذ الإقليمي الذي غطى المشرق العربي وامتد غرباً حتى الحدود الجزائرية المغربية.
نعم، مشاريع الآخرين كبيرة، وخواصر أمتنا كلها رخوة…