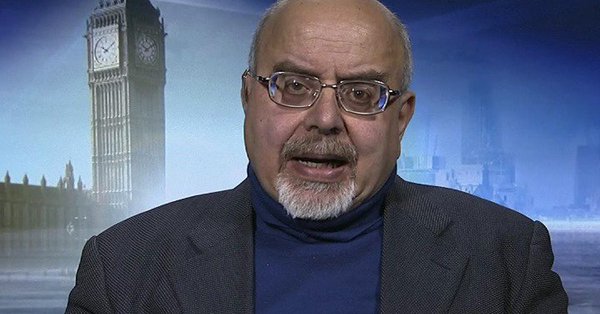كيف يمكن إبعاد «التسييس» عن أزمة سوريا؟
إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط/30 أيلول/18
أفهم أن كثيرين في عالمنا العربي ملّوا النزاعات الطويلة وباتوا متعجّلين أيَّ حلّ، حتى إن لم يكن حلاً حقيقياً.
أفهم ذلك لأن هذا العالم الجغرافي الواسع الممتد من سواحل الأطلسي إلى شاطئ الخليج مُتخم بالأزمات، كبيرها وصغيرها… أزماتنا، والحمد لله، ملءُ السمع والبصر. والانقسامات العربية المألوفة – كالعادة – لا تُعالَج بالصراحة المطلوبة والواقعية المتوخاة! بل إن المناكفة والكيدية والنظرة الأنانية الضيقة تفعل فعلها اليوم، كما فعلت دائماً، في صبّ الزيت على النار. لا حاجة إلى التوقف طويلاً أمام محنة فلسطين، فدروسها حفظناها عن ظهر قلب منذ خرجت أول دبابة من إحدى ثكنات سوريا عام 1949 لتعلن أول انقلاب عسكري عربي بعد ولادة دولة إسرائيل عام 1948. منذ ذلك الحين، دخل عنصر جديد على مقاربة الأزمات المصيرية في كيانات عربية، إما متشكلة حديثاً وإما هي في طور التشكّل وعلى أبواب الاستقلال، هو دور الجيش. الجيش في دول العالم الثالث عموماً، وبعض العالم العربي الحديثة العهد بالحكم الديمقراطي، صار مع الوقت ليس فقط «الحزب» الأقوى، بل غدا «مؤسسة الحكم» الفعلية بعدما أزاح الأحزاب التقليدية القديمة… أو استفاد من إلغاء تلك الأحزاب نفسها لعجزها عن استيعاب ديناميكيات التغيير وتحوّلات المجتمع.
في تلك الحقبة الانتقالية، ما عادت تلك الأحزاب تعني الكثير للإنسان العادي بعدما ضعفت جذورها العشائرية والطائفية والجهوية ولم تعوّضها بعلاقات مصلحية أو مطلبية تبرّر استمرارها.
هذا ما حصل طوال عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي حتى نكسة يونيو (حزيران) 1967 عندما «اهتز» صعود الجيوش كـ«مؤسسات حكم»، وراجت في بعض الشارع العربي شعارات «حرب التحرير الشعبية» خلال فترة تسلل الشك إلى قلوب قادة الولايات المتحدة بإمكانية تحقيق النصر في حرب فيتنام. ففي عام 1966 أعرب روبرت ماكنامارا، وزير الدفاع الأميركي السابق وأحد «مهندسي» سياسة واشنطن في الهند الصينية، عن شكه صراحةً بالقدرة على حسم الحرب ضد ثوار الفييتكونغ الشيوعيين والفيتناميين الشماليين المدعومين حينذاك من الصين والاتحاد السوفياتي. وحقاً، كانت الهزيمة الأميركية في فيتنام ولاوس وكمبوديا أكبر نصر عسكري لليسار العالمي ولفكرة «حرب التحرير الشعبية» منذ سيطرة الشيوعيين على الصين.
بطبيعة الحال، استوعبت واشنطن درس الهند الصينية، ولاحقاً، دروس مناطق أخرى من العالم كأنغولا وإثيوبيا، وأعدّت الخُطط للثورات المضادة. وفي الشرق الأوسط، بالذات، بعد «المدّ الأحمر»، بدأ الجَزْر من مصر (طرد الخبراء السوفيات ثم كامب ديفيد)، وأفغانستان (إسقاط الشيوعيين بسلاح المجاهدين الأفغان). ثم، مع الاقتراب من نهاية «الحرب الباردة» التي حُسمت بانهيار الاتحاد السوفياتي في نهاية 1991 انهار اليسار المعتمد على موسكو وبكين لأن موسكو نفسها سقطت وبكين تغيّرت. وتحوّلت «القطبية السياسية» في الشرق الأوسط – العربي والإيراني والباكستاني والتركي – من تنازع اليسار واليمين… إلى صراع بين «طليعتي» اليمين الذي انتصر، بوجهيه الديني والعسكري.
إنه الصراع الذي طغى على ما عرّفناه بـ«الربيع العربي» في أواخر 2010 ومطلع 2011 في كلٍّ من تونس ومصر واليمن وسوريا وليبيا. ومن ثَم، استنساباً واستسهالاً اختصرنا الصورة الشاملة به. وهكذا، ألغينا وجود أي رغبة في التغيير خارج الإسلام السياسي، وشطبنا أي حرص على الاستقرار والسلم الأهلي خارج مؤسسة الجيش والأمن.
في هذا الإطار، ما فعلناه ونفعله – كمجتمع – هو تجاهل طموحات المثقفين واليمينيين الليبراليين واليساريين المعتدلين والقوميين اللاشوفينيين والمستقلين غير المسيسين والمواطنين العاديين… وتغييبها تماماً. وهذا أمرٌ غريبٌ حقاً لأننا نتغنى دائماً بالحاجة إلى «مجتمع مدني» عاقل ومتسامح ينظر بأمل إلى المستقبل، ونحلم دائماً بأن نقارن مجتمعاتنا بالمجتمعات الراقية في أوروبا والولايات المتحدة، بل، وحتى دول آسيا الصاعدة المتقدّمة.
وهنا، لا بأس من العودة إلى الشأن السوري، حيث يبدو أن ثمّة تسابقاً الآن بين بضعة «سيناريوهات» جارٍ تنفيذها وفرضها على السوريين، وبعدهم، على المنطقة ككل. لا شك في أنه ليس ثمة أي طرف عربي يستطيع راهناً مواجهة الاندفاعة الروسية في سوريا، ولا سيما، إذا كانت تحظى بموافقة ضمنية وجزئية من واشنطن. والبديهي أن كلاً من موسكو وواشنطن متفقتان – على الأقل، مرحلياً – على النقاط التالية:
1- العدو الأول المطلوب اجتثاثه داخل سوريا هو بعض فصائل الإسلام السياسي المتشدّد، مع العلم أن منها مَن هو مُخترَق منذ البداية من قِبل نظام دمشق وداعميه الإقليميين والدوليين، وكانت مهمته منذ البداية العمل على اختطاف الثورة الشعبية، وإفشالها من داخلها، وتشويه صورتها تسهيلاً لضربها وتصفيتها.
2- تأسيس مناطق «نفوذ واقعي» تضمن مصالح اللاعبين الإقليميين على الأرض السورية، وذلك في ضوء استحالة العودة إلى فكرة «الدولة المركزية» فوق أنهار الدم وفي أعقاب تهجير الملايين.
3- خفض سقف النفوذ الإيراني تمهيداً للتعايش مع إيران «جيدة السيرة والسلوك» على مستوى المنطقة ككل، وكلاعب يمتنع الروس عن استخدامه لابتزاز واشنطن، بينما يُبقي عليه الأميركيون والروس «فزاعةً» للعرب و«حليفاً رديفاً» للأتراك.
4- الاعتراف بمخاوف إسرائيل وطموحاتها الإقليمية، وإيجاد كلٍّ من الأميركيين والروس صيغة توافقية طويلة الأمد بهذا المعنى. والواضح، بعد 7 سنوات من الحرب في سوريا أن إسرائيل كانت الرابح الأكبر.
موسكو دأبت منذ فترة، بعد قضائها فعلياً على مسار جنيف، على المناداة بإخراج «التسييس» من نطاق معالجة ملف إعادة إعمار سوريا، وقبل ذلك كانت تزعم أن وقوفها مع النظام لا يعني تأييدها إياه… بل تصدّيها للإرهاب.
ثم خرجت بفكرة «مناطق خفض التصعيد» لإكمال استراتيجية «المصالحات» القسرية التهجيرية أيضاً «بعيداً عن التسييس».
وواصل المجتمع الدولي عبر وسيطه ستافان دي ميستورا عبثيات الإصلاح الدستوري، أيضاً «بعيداً عن التسييس».
والآن تروّج موسكو وأطراف أخرى لفتح المعابر الحدودية كخطوة خجولة – ولكن واضحة – لتأكيد مسيرة التطبيع مع النظام وإعادة تأهيله. ومجدّداً، تروّج لذلك «بعيداً عن التسييس».
إذا لم تكن كل خطوات التطبيع «تسييساً»… فكيف يكون «التسييس» يا تُرى؟!