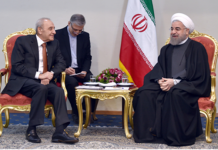سقوط وسط ما بعد الـ١٩٨٩ الأميركي
سامر فرنجيّة/الحياة/06 آذار/16
إذا صحّت استطلاعات الرأي، ويبدو أنّها لن تخطئ، فسيكون مرشح الجمهوريين للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، على رغم الاعتراضات المتأخرة والخجولة للمؤسسة الحزبية الجمهورية. فالمرشح الذي استبعده الجميع في بداية الموسم الانتخابي، لتطرفه المخيف وقلة خبرته السياسية، تحوّل خلال أشهر إلى عنوان رئيسي للمعركة الانتخابية، من خلال الانقسامات والتجاذبات التي أدخلها على الساحة السياسية. فبغض النظر عن أيلولة الأمور، نجح ترامب في أن يحوّل منطق السياسة الداخلية الأميركية، من خلال إدخاله عنصراً جديداً في الانتخابات، وهو «الرجل الأبيض الغاضب»، وزعزعته خطوط الانقسام السياسي التقليدية. بهذا المعنى، يشبه صعود ترامب ظاهرة «داعش» في استعماله التطرف كتقنية سياسية تهدف إلى تحويل شروط اللعبة السياسية وفرض واقع جديد يؤكد بأثر رجعي أحقية تطرّفه. يعلّق البعض آمالهم على «حكمة» المؤسسة الحزبية الجمهورية للوقوف في وجه ترشيح ترامب، وبالتالي في وجه التصويت الشعبي له. غير أنّ آمالاً كهذه باتت متأخرة، ويبدو أنّ أي اعتراض مؤسساتي قد ينتهي بانقسام الحزب، وبالتالي انتهاء نظام الحزبين في الولايات المتّحدة مع إمكان ظهور حزب ثالث متطرف. وتنّم صعوبة كهذه أيضاً عمّا لحظه الرئيس الأميركي باراك أوباما، من أنّ ترامب، على رغم تطرفه الظاهر، لا يشكّل استثناءً في الحزب الذي باتت أكثرية مرشّحيه من صفوف المسيحيين الجدد وحزب الشاي والشق الشعبوي منه. فالتحالف بين يمين اقتصادي ومحافظة اجتماعية ومصالح الأثرياء، الذي قام عليه الحزب الجمهوري، بات على وشك الانهيار تحت وطأة الموجة الشعبوية التي أطلقها الحزب نفسه.
وهناك بوادر لأزمة حزبية مماثلة في الضفة المقابلة، وإن كانت أقلّ حدّة، حيث تواجه مرشحة «المؤسسة» الحزبية أكبر تمرّد يساري في الحزب الديموقراطي منذ عقود. وقد تستطيع كلينتون، ومن ورائها الحزب، صدّ التحدي الذي تطرحه سيطرتهم على ساحة اليسار الليبرالي، غير أنّها خسرت الكثير نتيجة حملات خصمها بيرني ساندرز، وتحوّلت إلى مجرّد مرشحة لـ «الوسط» تواجه «متطرفين»، أو مرشّحة للأمر الواقع والمؤسسة في وجه «المراهقة السياسية»، وهذا بعد رئاسة لباراك أوباما قامت على شعارات معاكسة تماماً. ويتكرّر هذا المشهد في باقي الدول الغربية، حيث يجد «الوسط السياسي» نفسه، كما يسميه الكاتب فريد زكريا في مقالته في الواشنطن بوست (٢٥/٠٢/٢٠١٦)، محصوراً بين صعود يمين متطرف ومعارضة يسارية متجدّدة. فإذا كان صعود اليمين تحوّلاً لا عودة عنه، بخاصة مع تفاقم مسألة الهجرة والأزمة الاقتصادية، فالجديد كان في صعود يسار خارج عن تسوية الحرب الباردة، تمثّل بصعود تحالف سيريزا في اليونان وبوديموس في إسبانيا، وربّما الأهم، سقوط «حزب العمال» البريطاني، الحزب اليساري الرئيسي في تسوية ما بعد الـ١٩٨٩، في يد يسار قام على رفض مشروع توني بلير ويساره الوسطي. قد ينجح «الوسط» في البقاء في الحكم في وجه الاعتراض المتزايد، لكنّه فقد براءته ليصبح الدفاع عنه دفاعاً عن شر لا بدّ منه في وجه تطرف غير معروف النتيجة. وهذا هو الدفاع الذي قدّمه فريد زكريا للوسط السياسي كأحد مكتسبات انتهاء الحرب الباردة والمعقل الأساسي لعقلانية سياسية تستبدل الأوهام ببراغماتية تقنية. فمشكلة «الوسطيين»، وفق الكاتب، هي في أنّهم يدفعون ثمن عقلانيتهم ونجاحهم اللذين يخلوان من أي إثارة أو رومانسية سياسية. فالديموقراطية تحتاج إلى أحاسيس، والوسط لا يلهم المشاعر.إذا كان دفاع زكريا غير مقنع، فهو قد يكون محقاً في وضع الانتخابات الأميركية الحالية والتحديات الأوروبية في سياق مرحلة ما بعد الـ١٩٨٩ وأزمتها. التسوية الأيديولوجية التي أسسّت لنظام ما بعد الحرب الباردة بدأت بالانهيار، أكانت لناحية الآمال التي أحاطت بالعولمة والنظام العالمي، أو شقها القائم على انتهاء الصراعات الأيديولوجية والقومية واستبدالها بمسائل ثقافية و «جامعة». وهذا الانهيار ليس نتيجة مراهقة يسارية أو شعبوية يمينية، أو بكلام آخر، رومنسية تحاول العودة إلى السياسة بعد أن طردها العقل. بل هو مرتبط بترنح القواعد الفعلية لهذه التسوية، أكانت الأزمة الاقتصادية العالمية التي جاءت في أعقاب عدد من الأزمات المالية في العقدين الأخيرين، أو أزمة النظام العالمي التي بدأت مع حرب العراق وتفاقمت مع الأزمة السورية أو أزمة المؤسسات الأوروبية واستمراريتها. سينجح هذا الوسط في المستقبل القريب في صد الاعتراضات المتزايدة عليه. غير أنّ عملية إعادة تقييم مرحلة ما بعد الـ١٩٨٩ بدأت. وقد لا تكون البدائل عن هذا النظام مغرية، بيد أنّ التمسّك به وبوسطه لم يعد يوفّر مهرباً من إعادة التقييم هذه.
أوهام دي ميستورا
الياس حرفوش/الحياة/06 آذار/16
يطالب المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن يكون حل الأزمة السورية في يد السوريين وبقيادة سورية. ويسأل: لماذا يجب أن نقول مسبقاً ما يفترض أن يقوله السوريون طالما أن لديهم الحرية والفرصة لقول ذلك؟ الحرية والفرصة للسوريين ليقولوا ما يريدون؟ كيف ذلك ومن سيحمي هذه الحرية؟ هل يعتمد دي ميستورا على «خبرة» الرئيس الأسد في حماية السوريين ليذهبوا إلى صناديق الاقتراع في 13 الشهر المقبل تلبية لدعوته، ليدلوا بأصواتهم ويقرروا مستقبلهم بحرية، كما اعتادوا في ظل 16 سنة من حكمه، و30 سنة قبلها من حكم والده؟! أم يعتمد على فصائل المعارضة المبعثرة والمشتتة والتي تفرض الولاءات في مختلف أنحاء سورية، تبعاً لميول زعمائها ومن يعملون لديهم؟ لا أعتقد أن دي ميستورا يجهل تعقيدات الأزمة السورية، بحكم خبرته، وإن تكن قصيرة العمر، مع النظام وشبيحته، ومع قادة المعارضة المقاتلين للنظام والمتقاتلين في ما بينهم. كما لا يجهل المدى الذي بلغته التدخلات الإقليمية والدولية في مسار هذه الأزمة. لقد صارت الخريطة السورية مفتوحة الآن على طاولات قادة الدول الكبرى، بشكل لم يسبق له مثيل منذ بداية الأزمة. وما كان يصح قوله في الأشهر الأولى من عام 2011 حول قدرة السوريين على رسم صورة مستقبلهم لم يعد صحيحاً اليوم. كان يمكن أن تبقى سورية في يد السوريين لو تجاوب بشار الأسد مع تظاهرات المعارضين السلميين في تلك الأشهر الأولى، ومع نداءات دول الجوار التي لم تكن قد قطعت علاقاتها معه آنذاك، مثل السعودية وتركيا وسواهما، ودعا إلى استفتاء أو انتخابات رئاسية مبكرة، تحدد مستقبل رئاسته وشرعية تلك الرئاسة الموروثة بتزوير فاضح للدستور السوري. أما اليوم فقد أصبحت هذه الرئاسة، بل أصبح مصير البلد كله في يد الدول الكبرى وأهوائها ومصالحها، وما يمكن أن تحصّله مما تبقى من الكعكة السورية. لهذا لم يعد مستغرباً أن تشارك كل الأطراف، الإقليمية والدولية، في التفكير في مستقبل سورية وفي رسم مستقبلها، في غياب السوريين، موالين ومعارضين. وحتى الهدنة الحالية، التي سميت مجازاً «وقف العمليات العدائية»، تم فرضها فرضاً على أطراف القتال، من جيش النظام وفصائل المعارضة، من جانب الولايات المتحدة وروسيا. وإذا كان صحيحاً أن هذه الهدنة لقيت حماسة شعبية في المناطق التي تطبق فيها، فذلك يعود إلى أنها وفرت شيئاً من الحياة الطبيعية، وحدّت من أعداد القتلى، وسمحت بوصول بعض المواد التموينية والغذائية، خصوصاً إلى المدن والمناطق التي اعتمد فيها النظام سياسة «الجوع أو الركوع».
في مناخ الهدنة النسبية هذا، يريد دي ميستورا إحياء مفاوضات جنيف في الأسبوع المقبل، بعدما فشلت جلستها السابقة بسبب الخلاف على الأولويات، واستمرار العقبة الرئيسية التي يمثلها بقاء بشار الأسد. غير أن التصريحات الأخيرة للمبعوث الدولي توحي بأنه يأتي إلى جنيف حاملاً أفكار النظام في ما يتعلق بدور الأسد في رسم المرحلة السياسية المقبلة. فالدعوة إلى ترك السوريين يقررون مصيرهم بأنفسهم هي تماماً ما يطالب به الأسد، بعدما أخرجت مدافعه وطائراته وبراميله المتفجرة كل السوريين «الإرهابيين» من بلدهم، ولم يبقَ في المناطق «المفيدة» من سورية سوى أولئك السوريين الذين يرفعون راية النظام، ويمثلون «فائدة» كبرى في صناديق الاقتراع الموعود في الشهر المقبل. هذا هو الاقتراع الذي يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتفق مع الدستور السوري ولا يعرقل التسوية السياسية، على رغم أن الدعوة إلى الانتخابات تخالف القرار الدولي الأخير المتعلق بسورية والذي وافقت عليه موسكو (رقم 2254) ويضع الانتخابات الرئاسية والنيابية في المرتبة الثالثة بعد تغيير الحكومة وإقرار دستور جديد. إنها التسوية، في نظر بوتين، التي تبقي بشار الأسد في الحكم، وتحجّم المعارضة سياسياً بعدما نجح تدخل القوات الروسية في تحجيمها عسكرياً. … ثم يتحدث دي ميستورا عن ترك السوريين يقررون مصيرهم بأنفسهم، من دون تدخل خارجي!
حرب بالواسطة بين إيران والعرب
سليم نصار/الحياة/06 آذار/16
يوم السبت الماضي، مارس «حزب الله» في لبنان عملية شبيهة بعملية 7 أيار (مايو) 2008، يوم هاجم عناصره وأنصاره جماعة 14 آذار، وحاصروا بعض الزعماء بمن فيهم وليد جنبلاط وسعد الحريري. ومع أن أسباب التوتر والاحتجاج مختلفة، إلا أن مواجهات السبت الماضي رسمت خطاً أحمر حول شخصية السيد حسن نصرالله، بحيث منعت قنوات التلفزيون من تخطّيه، لا فرق أكان ذلك في معرض الجد أو السخرية. ولولا تدخّل الجيش والأجهزة الأمنية، لكانت الفتنة الطائفية والمذهبية وجدت مرتعاً خصباً عبر مواجهات العنف والعنف المضاد. وعلى رغم تبريد أجواء الاحتقان، فإن حرية الإعلام التي تميَّز بها لبنان بدأت تفقد خصوصيتها، وتعرّض العاملين فيها لمختلف أساليب التهديد والوعيد. وكان واضحاً من الشعارات التي أطلِقَت خلال مسيرات الاحتجاج المتنقلة، أن معايير السلوك الاجتماعي المتعلّقة بقيادات «حزب الله» تختلف كل الاختلاف عن معايير السلوك المتّبعة حيال زعماء 17 طائفة أخرى. من هنا قول المحللين أن وجه لبنان السابق والحقيقي قد تغير مع وجود «حزب الله» فوق أرضه. ومعنى هذا – وفق تقويم الزعامات المسيحية والسنّية – أن الوطن الذي وُلِدَ سنة 1943 لم يعد له وجود، وأن الطبقة المتوسطة التي نجحت في صنع نظام مستقر ومؤسسات اقتصادية قانونية… هذه كلها قد زالت واضمحلّت بعد سنة 1982. والسبب أن الحزب تعمَّد تحطيم كل القواعد الأساسية التي قامت عليها مداميك الجمهورية اللبنانية، مستعيضاً عنها بـ «قانون» يجيز له امتلاك أكبر ترسانة صواريخ في المنطقة. في ظلّ هذا الوضع المقلق، تحوّل اللبنانيون الى شعب لا يثق بمستقبله… ولا يطمئن الى هويته. وكل ما بقي له من حاضره يُختصَر بحقيبة سفر…
ومن أجل تفسير الوقائع التي أوصلت لبنان الى ما وصل إليه، لا بد من مراجعة سريعة للأعمال التي نقلت نفوذ إيران الى شاطئ البحر الأبيض المتوسط. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، أرسلت طهران الى دمشق سفيراً مقتدراً هو علي أكبر محتشمي، بقي في سورية من 1982 حتى 1985. وبما أنه كان يعرف حدود دوره في ظل نظام حافظ الأسد، لذلك ركّز اهتمامه على إنشاء كوادر مقاتلة من شيعة الجنوب وبعلبك، وراح يكرر زياراته الى لبنان من دون أن يطلع الحكومة على نشاطاته.
خلال مراحل بناء الخلايا المدرّبة على استعمال السلاح، استثنت سورية «حزب الله» من قرار جمع سلاح الميليشيات، خلافاً لقرارات اتفاق الطائف. ومع وجود ثلاثين ألف جندي سوري على الأرض اللبنانية، كان هؤلاء يساعدون الحزب على جمع عناصره من منطقتي الجنوب وبعلبك. وقد سهّلت لهم الأموال المرسَلة من إيران (مئة مليون دولار سنوياً) القيام بعمليات اختراق للمجتمعات الفقيرة والمتحمّسة لخدمة مذهبها. عقب انتشار أخبار المساعدات الاجتماعية التي قام بها «حزب الله» خلال سنة 1982، طلبت منه إيران «تنظيف» الأراضي اللبنانية من كل القوى الأجنبية التي قدِمَت للمشاركة في حفظ الأمن.
وخلال مدة لا تتجاوز السنتين (1983 – 1984)، أشرف عماد مغنية، المقرَّب جداً من مراكز السلطة في طهران، على تنفيذ عمليات عدة أهمها: نسف مقر المارينز قرب مطار بيروت… ونسف مركز القوات الفرنسية… ثم نسف مبنى السفارة الأميركية حيث قُتِل 250 شخصاً، بينهم 33 من موظفي الـ «سي آي إيه» في منطقة الشرق الأوسط. وكانت نتيجة تلك العمليات الدموية، التي رافقتها أعمال خطف واغتيال، انسحاب كل القوى الخارجية التي قدمت لمساعدة الدولة اللبنانية. وكان من الطبيعي أن تتساءل العواصم الغربية عن سرّ الصمت الدولي على هذه الأعمال، من دون أن يُطلب من الأمم المتحدة تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية مثل «القاعدة» مثلاً. جواب الأمم المتحدة أعطى المبررات القانونية اللازمة من أن «حزب الله» يملك كل الحق في طرد إسرائيل عن أرضه المحتلة. أما بالنسبة الى الأعمال المخلّة بالنظام الداخلي، فهي من اختصاص القوى الأمنية المحلية.
بالنسبة الى موضوع طرد كل القوى الأجنبية من جنوب لبنان وبيروت الغربية ومنطقة بعلبك، فقد أجمعت التحليلات على اعتباره خطوة تمهيدية لتسليح «حزب الله»، واعتباره كياناً مستقلاً داخل الجمهورية اللبنانية. وقد منحه ذلك التفرد هيمنة كاملة على المنطقة الممتدة من بلدة جزين حتى الحدود، أي ما عُرِف جغرافياً بمنطقة جبل عامل التي تضم إقليم التفاح وجبال الريحان وأرنون والنبطية.
ولهذه المنطقة في الذاكرة التاريخية الإيرانية صورة بهية جداً لأن أبناءها هم الذين أسسوا «التشيّع الصفوي»، في عهد اسماعيل الصفوي. وكانت إيران منذ الفتح الإسلامي وحتى العهد الصفوي، على مذهب أهل السنّة. وبسبب الخلاف مع العثمانيين، راحوا يبحثون عن مذهب آخر يعفيهم من الارتباط مع العثمانيين السنّة. وهكذا وجدوا في الشيعة العرب حاجة ماسة لتعميق التشيّع في إيران من خلال بناء فقهي وفكري أمّنه علماء منطقة جبل عامل.
وتشير دراسات هجرة علماء لبنان من منطقة جبل عامل الى إيران، الى أنهم تمتعوا بتأثير كبير في تربية جيل من الفقهاء الإيرانيين الذين مارسوا الشأن السياسي في الدولة الصفوية بعد ذلك.
ويقدّر مؤلف كتاب «هجرة علماء الشيعة» الباحث حسن غريب، أن عدد علماء جبل عامل تجاوز 97 عالماً، بينهم: علي عبدالعالي الكركي، كمال الدين درويش العاملي، حسين الجباعي، وبهاء الدين العاملي.
وتقول المصادر إن الكركي طوَّر نظرية النيابة العامة للفقهاء عن المهدي، والتي بموجبها أعطى رجال الدين الشيعة صلاحيات المهدي المنتظر (عن كتاب «جامع المقاصد»).
سنة 2006، أصدر «مركز الدراسات اللبنانية» في أوكسفورد دراسة قيّمة حول هذا الموضوع، الذي تولى كتابته المؤرخ ألبرت حوراني وحسن منيمنة وحسين الشهابي، تحت عنوان «علاقات قصية». وقد نشرته في حينه «دار توروس».
بعد انتهاء الحرب بين إيران والعراق سنة 1988، قرر الخميني تعميم نموذج النظام الذي أسسه في بلاده بواسطة آلاف الملالي. وكان لبنان في طليعة الدول المنتقاة لهذا الاختبار بسبب وجود ثلث عدد السكان من الطائفة الشيعية… وبسبب العلاقة التاريخية بين إيران الصفوية وعلماء جبل عامل.
ولما انتُخِبَ هاشمي رفسنجاني رئيساً، فاتح زواره من مشايخ شيعة لبنان بمدى احتمالات نجاح تجربة نموذج الجمهورية الإسلامية في جنوب لبنان. وتحفّظ الحاضرون على توقيت إعلان هذه البادرة، خوفاً من قيام «جمهورية مارونستان» في كسروان والمتن!
عقب انهيار المنظومة العربية، رأت إيران في هذا الزلزال السياسي فرصة تاريخية لترسيخ دويلات تابعة لنفوذها. عندها قامت قيادة «حزب الله» بخطوة مفاجئة ساعدتها دمشق على تحقيقها، بعد اغتيال رفيق الحريري. وتمثلت تلك الخطوة بعودة العماد ميشال عون الى الساحة السياسية، خصوصاً أن القوات السورية كانت قد أخلت الساحة. وهكذا شهدت كنيسة «مار مخايل» بروتوكولاً وقّعه العماد عون مع السيد حسن نصرالله. وبفضل ذلك التعهد، سقطت كل المحظورات عن ميشال عون وأنصاره وأصدقائه، بدءاً بالمتعامل مع إسرائيل العميد المتقاعد فايز كرم!
هذه السنة، انفجرت أزمة جديدة بين السعودية و «حزب الله» بسبب اتهام الرياض الحزب بإفساد علاقات اللبنانيين بمحيطهم العربي. وكان من الطبيعي أن تصدر عن ثلاثمئة ألف لبناني يعملون في دول الخليج مخاوف تتعلق بإجراءات عقابية. وقد بوشر في تنفيذ تلك الإجراءات في وقت تتهم جماعة 14 آذار «حزب الله» بتعطيل المؤسسات السياسية وعرقلة عملية اختيار رئيس جمهورية. وبما أن «حزب الله» يمثل إيران في لبنان ومختلف دول العالم، فقد هددت السعودية بفرض عقوبات على كل الشركات المتعاملة مع الحزب، خصوصاً بعدما ثبت لها أن إيران تنشط في دعم الحوثيين بهدف تحويل اليمن الى أفغانستان خليجية.
السبب المباشر لغضب السعودية كان الموقف الذي اتخذه وزير خارجية لبنان جبران باسيل، في مؤتمر الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. ذلك أنه رفض التنديد بإحراق السفارة السعودية في طهران، مخالفاً بذلك موقف الحكومة، وموقف رئيسها تمام سلام.
إضافة الى تهديد دول الخليج بمعاقبة اللبنانيين، قررت السعودية وقف المساعدة الاقتصادية التي تبلغ ثلاثة بلايين دولار، والمخصصة لتسليح الجيش والشرطة. وجاء هذا القرار ليزيد حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان. وهي أزمة مرشحة لاستقطاب دول الخليج في حال اتخذت إيران من البلد الصغير موقعاً لإحراج الدول العربية. السعودية لم تكتفِ بتجميد ثلاثة بلايين دولار، بل هددت بسحب الأموال التي أودعتها في المصارف اللبنانية قبل 13 سنة. ويقول خبراء المال إن هذه الإيداعات ساعدت على استقرار قيمة الليرة اللبنانية. كما طلبت من مواطنيها عدم السفر الى لبنان. وقد حذت حذوها أربع دول خليجية.
استطراداً لهذه المواقف، أعلن يوم الأربعاء الماضي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، أن المجلس اتخذ قراراً باعتبار «ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية». وقد نأى لبنان بنفسه عن هذا القرار، بينما تحفّظ العراق. ونتجت من هذا القرار تصريحات رسمية عدة تناولت الرئيس الأميركي باراك أوباما، خصوصاً بعدما حذّره زعماء الخليج من خطورة تهوّره بالاتفاق النووي مع إيران، والإفراج عن مئة بليون دولار، ستستخدمها طهران لزعزعة دول مجلس التعاون الخليجي. وفسرت الأمم المتحدة هذا القرار بأنه رفض قاطع لقبول سيطرة إيران على المنطقة التي تمتد من اليمن حتى لبنان…