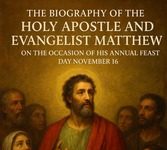“تواضع” زائد
نبيل بومنصف/النهار/14 تشرين الأول 2015
لا مكان في معجم القوى اللبنانية، بمعظمها على الأقل، ولا في سلوكياتها للتواضع الذكي، ونادراً ما تتقن قوة سياسية معنى القوة الناعمة في الظروف الملائمة. آخر نماذج هذه الظاهرة إحياء التيار العوني الذكرى الـ٢٥ لاجتياح الجيش السوري قصر بعبدا. لا يتصل الأمر هنا الا بالمكان ورمزيته حصراً بصرف النظر عن طموح الزعيم العوني الى بلوغ سدة الرئاسة. كان يمكن الجموع الحاشدة ان تجد ضالتها الطبيعية في الاحتشاد لو حصرت المناسبة بالبعد السيادي وحده الذي حوّل العماد عون رمزاً مقاوماً للوصاية السورية آنذاك، وعزلها عن التحولات التي اختطها لسياساته وتحالفاته بعد عودته من المنفى الباريسي. أما اختيار طريق القصر بالذات مكاناً للاحتشاد وسط هذا الاحتدام الهائل بين الماضي والحاضر الذي حيّد معه العامل السوري عن المناسبة، وبالكاد جرى التلميح الى الاجتياح مع شهادات ابناء الشهداء وذويهم، فإن الامر لا يعدو كونه إلاّ خطأ موصوفا. ضجيج التناقض لم يلبث ان تصاعد مع الهجوم على الخصوم واتهامهم بالتبعية للخارج وقت كانت صور فلاديمير بوتين “المنقذ!” ترتفع على أيدي جمهور لم تعرف ثقافته يوما مذاق الصلة بهذا المزاج القيصري. كيف تستوي مهاجمة “الطبقة الكيدية” وتهديدها بالثمن الكبير “لتبعيتها للخارج” فيما الضحية الكبرى (سابقاً) للنظام السوري تنزلق الى رهان عجيب طارئ على النظام إياه وحليفه الروسي؟ لعل أبرز ما يمكن استشرافه في الجانب اللبناني اليوم هو الضياع السياسي امام اجندات الدوليين والإقليميين المتطاحنة في سوريا، وهو ضياع يجعل القوى اللبنانية تعيش أزمة غير مسبوقة في تعاملها مع الرهانات الخارجية. صحيح وأكثر من صحيح ان البلبلة الهائلة الناجمة عن ابتعاد السعودية عن المسرح اللبناني تضع حلفاءها اللبنانيين في موقع شديد الالتباس، بل ان النفوذ السعودي في لبنان برمته يطرح الآن على طاولة التساؤلات البعيدة المدى. ولكن الأصح ايضا ان معسكر الخصوم الآخرين لا يبدو أفضل حالاً أبداً حتى في حالة الحزب العملاق “حزب الله” نفسه الذي يدفع تكراراً بألوف المقاتلين الى ساحات الاستنزاف مع المقلب الروسي الطالع في سوريا. لم يعد واقع القوى اللبنانية يحتمل اي جدل في سقوط حرب الرهانات سقوطاً مبيناً، ولعلها حقيقة لن يعترف بها أحد الآن. تتعولم حرب الدمار في سوريا فيما لا يزال أهل السياسة اللبنانية غارقين في عتيق الذهنيات والحسابات البائدة واتباع أنماط الاستنفار الشعبي التي لم تعد قابلة للتسييل، ما دامت الديموقراطية اللبنانية صارت الضحية الكبرى لهواية التأزيم والتعطيل وسد منافذ الحلول. وطبعا لن يكون هناك اي رهان على الإقرار المتواضع بهذه الحقيقة الا بعد فوات الأوان وبعد دفع الأكلاف الباهظة المعتادة!
انقذوا المسيحية في سوريا
سلام كواكبي: هنا صوتك/13 تشرين الأول/15
يعود سبب النقص العددي لدى الطوائف المسيحية في سوريا قبل قيام الاحتجاجات الثورية في سنة 2011، إلى تقاطع عدة عوامل من أهمها: الهجرة لأسباب اقتصادية أو سياسية والنقص في معدل الولادات بالمقارنة مع الأديان الأخرى بسبب الارتفاع النسبي في مستوى الوعي المرتبط بالمستوى التعليمي.
كما ساعدت دولٌ بعينها في تسهيل هذه الهجرة تحت مسميات عدة منها ما يتعلق بتمدد التطرف الإسلامي، مما يستوجب مساعدة الأقليات. فحصل كثيرون منهم على تأشيرات مُيسّرة. كما أفاد وجود شبكات علاقات عائلية منتشرة منذ بداية القرن الماضي في أصقاع العالم الأربعة في تأمين المرحلة الأولى من الانتقال والمكوث. إضافة إلى عوامل عديدة أخرى تستحق بحثاً معمّقاً.
بالمقابل، يغفل كثير من المتابعين عن ملاحظة أثر العامل السياسي الذي بدا للوهلة الأولى اقتصادياً، عبر موجات التأميم التي قامت تحت مسميات اشتراكية مشوهة، والتي أدت إلى تدمير الاقتصاد الوطني صناعةً وزراعةً عبر قراءة ساذجة للمفاهيم التنموية، في ستينات القرن الماضي، لتتطور سلباً في صالح مكونات طفيلية تأبطت شرّاً وفساداً بذراع السلطة القائمة منذ سبعيناته. ولكن الاقتصاد السياسي للنظام القائم كان هو المسبب الأول في دفع كثير من السوريين على مختلف طوائفهم من أصحاب المصالح والأعمال للهجرة. وقد انتشرت هذه الظاهرة خصوصاً ضمن مجموعات من لم يستسغ التعاون، أو بالأحرى الخضوع، للمفاهيم السوقية الجديدة. وبالتالي، فما كان يشكّل ضغطاً اقتصادياً بداية، تطوّر ليصبح سياسياً واجتماعياً. وتكاثر الشعور لدى المنتمين للدين المسيحي بأنهم أصبحوا “مواطنين” من الدرجة الثانية. وعلى الرغم من أن كل السوريين، إلا أصحاب الحظوة الأمنية أو الحزبية أو الزبائنية، كانوا يشعرون بأنهم في مرتبات متدنية من المواطنة، إلا أن هذا الشعور ازداد لدى اتباع الدين المسيحي بطوائفه كافة، خصوصاً إن هم اختاروا عدم التزلف والانخراط تحت عباءة “الحامي”. وساهم الاستخدام السياسي للعامل الديني ومحاباة الفكر الظلامي في السعي إلى السيطرة على الشارع الإسلامي، بعد أحداث الثمانينات في زيادة عامل الخوف لديهم.
انخفض العدد في ظل حكم السلطة “حامية الأقليات” من 15 بالمئة سنة 1970 إلى 4.6 بالمئة سنة 2008. وكانت الدولة تصرّ على تضخيم النسبة الى حوالي 10 بالمئة والكنيسة إلى حوالي 7 بالمئة. أما الدولة، فأٍسبابها واضحة في تقديم صورة وردية ترويجية تفيد في “العلاقات العامة”. وأما الكنيسة، فكما ذكر لي أحد أهم رجالاتها عندما أعددت دراسة حول الظاهرة، فهي لا تحبّذ ذكر الرقم الحقيقي حتى لا تنشر الرعب في الرعية وتدفع بمن قاوم واستمر منهم إلى الهجرة بدوره. كما أن المهاجرين يسافرون عموماً دون إخطار رسمي، مما لا يجعل السجلات قادرة على متابعة الواقع.
استغلال مسألة الأقليات في العلاقات العامة هي الأداة الأنجح التي سوّقتها الأنظمة التسلطية دائماً. وقد تم أخذ هذه الأقليات كرهينة لمصالح السياسات الحاكمة. وإن هي عارضت في جزئها أو في كلّها، فالعقاب سيكون مزدوجاً وأكثر حدّة من ذاك العقاب الحاد المسخّر لعموم الشعب. ونجحت سياسة “فرّق تسد” في إصباغ “شرعية” دولية للأمنوقراطية.
اليوم، يُبارك البطرك الروسي طائرات القتل وصواريخها معتبراً بأن “الحرب الروسية في سوريا مقدّسة”. وكذا يفعل مطران حلب للكاثوليك معتبراً بأن “بوتين يخدم قضية المسيحيين في سوريا”.
لا يعرف هؤلاء، أو هم يعرفون، بأن في قولهم هذا أكبر إساءة لمن بقي من رعيتهم في هذه البلاد وفي جوارها. هم يقترفون جريمة إنسانية بحق رعيتهم ويضعونها في حالة عداء “دينية” أمام غالبية الشعب السوري. هم يوصمون مجمل الرعية بالعداء لمجمل الشعب، وفي ذلك يتبعون تعليمات أسيادهم السياسيين مبتعدين عن أية قيم روحية أو أخلاقية. وفي تبريرهم لآلات القتل الروسية، فهم لا يختلفون في هذا مطلقاً عن المعممين الداعين إلى العنف بحق من خالفهم الرأي من مختلف الطوائف والأديان، والذين يبررون لآلات التدمير والقتل والتعذيب الداعشية.
بعض رجال الدين من كل الطوائف والأديان يحاربون مصالح أبناء طوائفهم وأديانهم من خلال إقحامها في تبرير سياسات محلية أو إقليمية أو دولية تدميرية وعدائية. هم لا يختلفون البتة عن رجال المافيا والسلطات المستبدة التي تأمر بموت وبتعذيب الأبرياء. صولجاناتهم أو عمائمهم لا يمكن لها أن تحميهم من المساءلة الأخلاقية على الأقل. في موقف وطنيٍ وشجاع لافت، احتد مطران سوري أمام مسؤول غربي يسأله عن سبل حماية المسيحيين وقال له: “يكفي، السوريون كلهم ضحايا وما المسيحيون إلا جزء من مجمل السوريين، احموا السوريين”. فمن يحمي مسيحي سوريا من بعض من سرق ماضيهم ويقضي على مستقبلهم في المنطقة من سياسيين ورجال دين ؟ تنويه: المقالات الواردة على الموقع تُعبّر عن رأي الكاتب، ولا تُعبّر عن رأي أو توجه موقع هنا صوتك أو إذاعة هولندا العالمية.
تقسيم رقم 2: «خامنئي – بوتين» بعد «سايكس – بيكو»
خالد الحروب/الحياة/13 تشرين الأول/15
لا نعرف حتى الآن المصطلح الذي سينحته التاريخ ومؤرخوه للهجمة الروسية – الإيرانية التقسيمية على سورية والمنطقة، وتفتتح مرحلة جديدة ومثيرة من الاستعمار المختلف. لكن إلى ان يتم حسم تلك المسألة اللفظية والاصطلاحية ربما نقترح وصف
تقسيم 2: «خامنئي – بوتين»، وخامنئي هنا، أي ايران، تتقدم روسيا في مسؤولية تدمير وتقسيم سورية، ولا يقلل هذا من المسؤولية الروسية بحال.
الهجوم الاستعماري الايراني – الروسي الراهن على سورية (والإيراني تحديداً على العراق واليمن) يختلف بطبيعة الحال عن الحقبة الاستعمارية الغربية التي شهدتها المنطقة في العقود الأولى من القرن العشرين (واستمرت طويلاً بعد ذلك في الجزائر وفلسطين). الاستعمار والتقسيم الغربي التقليدي كان امتداداً لحقبة تنافس امبرطوري بريطاني وفرنسي وإيطالي وإسباني وألماني في طول وعرض العالم، منطلقاً من الرغبة الجامحة في السيطرة على الموارد والأراضي والشعوب.
في فصوله البريطانية والفرنسية، على الأقل، كان يحتل ويسيطر وينهب ثروات الشعوب تحت مسوغ نشر حضارة الرجل الأبيض. وحتى يبدو «صادقاً» مع شعاراته اضطر هذا الاستعمار الى جلب بعض جوانب تقدم وتحضر «الرجل الابيض» الى المناطق المستعمرة، فكان هناك بعض التقدم هنا وهناك مثل شق الطرقات وبناء السكك الحديد (في الهند مثلاً)، وبناء الجسور (كما في السودان ومصر والتي تستخدم حتى الآن!).
اضافة الى ذلك حاول هذا الاستعمار، واستمراراً لسياسة ايجاد المسوغ والمبرر للاحتلال والسيطرة، تدريب وتعليم وتأهيل طاقات محلية عبر التعليم الجامعي الغربي وتكوين نخب قادرة على الإدارة. في خضم ذلك، سوق لنموذجه الليبرالي الديموقراطي في اوساط تلك النخب باعتباره الجسر الوحيد نحو التقدم والنجاح واللحاق بالحداثة. لا يعني هذا على الإطلاق القول إن الاستعمار الغربي كان حنوناً او ان ايجابياته تغلب سلبياته، بل القصد القول ان ذلك الاستعمار اضطر الى القيام بعمليات تجميل الوجه أفادت جزئياً الشعوب المستعمرة وبعض نخبها، الى جانب النهب والتدمير الذي قام به.
واحدة من تلك العمليات كانت انفتاح النقاش السياسي المحلي على شكل الحكم بعد مرحلة التحرر والتخلص من الاستعمار، وفي قلبها ضرورة الحرية السياسة وتبني الحكم البرلماني والديموقراطية وسوى ذلك. في الوقت نفسه تحولت القيم الليبرالية والانسانية التي «تسلح» بها الاستعمار الغربي لـ «إنقاذ الشعوب المتخلفة»، الى اسلحة بيد تلك الشعوب ونخبها، وبقيت كذلك الى الآن. فقيم حقوق الانسان والمساواة بين البشر وحق تقرير المصير وغيرها أصبحت هي الارضية التي تقوم عليها نضالات الشعوب المُستعمرة ضد سياسات الهيمنة والسيطرة والحروب الغربية.
في حقبة الهجمة والاستعمار الروسي – الايراني لسورية لن نرى حتى مجرد القيام بعمليات تجميلية لبشاعة تلك الهجمة. وليس هناك حتى مجرد شعار فارغ يهدف الى «نشر الحضارة والاستنارة»، او «إنقاذ الشعب»، او غير ذلك. في حقبة وتقسيم «خامنئي – بوتين» كل ما نقرأه والجميع متأكد منه هو ان استعمار سورية وتقسيمها يقوم ويقعد على أسس المصلحة الاستراتيجية الروسية في استقطاع الساحل السوري ليكون تحت سيطرتها المباشرة الى أمد غير معروف، والمصلحة الاستراتيجية الايرانية في استقطاع «دويلة دمشق» المتواصلة مع جغرافية لبنان الشيعية في الشرق، لتظل موطئ قدم ايرانية دائمة. لا يهم طهران ولا موسكو ان تتفتت سورية بالتوازي مع هذين الاستقطاعين الى دويلات اخرى، كردية في الشمال الشرقي، ودرزية بمحاذاة اسرائيل، و «حلبية» في الوسط الصحراوي.
إلى ذلك، ماذا يقدم النموذجان «الايراني» او «الروسي» من شكل سياسي او نظام قيم ولو على شكل شعاراتي مجوف يمكن الإتكاء عليه او استدعائه لنقد ايران وروسيا وسياساتها؟ ليس هنا اي مجموعة قيم تتحدث عن الديموقراطية او الحرية او المساواة او الكرامة بإمكان النخب «المُستعمرة» الرجوع اليها كمرجعية مشتركة لنقد النظام الفوقي. كل ما هو موجود «معايير المصلحة الاستراتيجية» للدول المُستعمرة، ايران وروسيا، وبعد ذلك لا يهم شيء. لا يهم ان تم تهجير 11 مليون سوري من بيوتهم ومدنهم وقراهم، أكثر من نصفهم الى خارج بلدهم، ورميهم ضحايا للبحر والاسماك، او للمصائر المُبهمة. لا يهم ان تم تدمير سورية وإرجاعها عقوداً طويلة الى الوراء، طالما أن أهداف بوتين الاستراتيجية في مماحكة الغرب والشبق في الظهور على شكل الرجل القوي والعظيم قيد التحقق. وطالما ان الشبق الايراني المهووس بأيديولوجية الشيعية السياسية المخلوطة بالرغبة الساحقة في تكريس النفوذ الاقليمي والاحتلالي في المنطقة العربية، يتحقق ايضاً.
هل ما سبق ذكره فيه اتهامات ومبالغات وأحكام مُسبقة، وتغاضٍ عما يقوله انصار ايران وروسيا من أن التدخل في سورية هدفه «الدفاع عن الشعب السوري» مقابل الإرهاب والتدخلات الغربية؟ حسناً، لنتأمل في ما تبقى من مساحة لنا هنا مثالاً واحداً ونستخدمه كاختبار للمقولات التي ترى في ايران وروسيا دولاً معتدية ومكروهة من الغالبية الكاسحة للشعب السوري، وهذا المثال يختصره السؤال المزدوج التالي: لماذا لم تفتح ولا تفتح روسيا وايران بلدانها للاجئين السوريين، وكلا البلدين ولغ في الشأن السوري تحت مزاعم حماية السوريين من الإرهاب، وبرر ارسال قنابله وخبرائه بمسوغ مساعدة الشعب السوري في محنته؟ ثم، لماذا لا يتوجه اللاجئون السوريون انفسهم وبمحض ارادتهم الى روسيا او ايران، وهي الدول التي هبت لنجدتهم خلال السنوات الماضية فور اندلاع ثورتهم ضد الاستبداد الاسدي؟
لا يبحث هذان السؤالان الاستنكاريان عن إجابة هي واضحة لكل من يتابع المأساة السورية بقدر ما يسلطان الضوء على مفارقة مُمضة كبيرة تُضاف الى مفارقات مواقف هاتين الدولتين، اللتين تتسابقان في ترسيم المشاريع الاستعمارية والتقسيمية في سورية. روسيا من ناحية تقفل حدودها في وجه السوريين بما يجعل الوصول الى القمر ربما أسهل لكثير من السوريين من الوصول اليها لو ارادوا التوجه اليها. لكن روسيا ايضاً وأصلاً ليست من البلدان الجاذبة للهجرة اليها بسبب تفاقم الشوفينية الروسية القيصرية وانبعاثها من القبور مع قدوم بوتين، وهي شوفينية يلحظها كل زائر، وتترجم عبر قوانين صارمة في الإقامة والعمل، ناهيك عن التجنيس الذي ربما يعد الأصعب منالاً في شمال الكرة الارضية كلها. ولعدم وجود تكافوء الفرص بين الافراد بغض النظر عن خلفياتهم وجنسياتهم فإن روسيا ليست جهة مرغوبة للسفر او العمل، بعكس الدول الغربية التي تتهكم عليها روسيا، والتي يرغب في الهجرة اليها كثيرون ومنهم روس ايضاً.
ايران ليست أفضل حالاً بطبيعة الحال، ذلك ان الشوفينية الفارسية المُتصاعدة تكاد تنافس الروسية في انغلاقها على ذاتها وعدم تقبلها الآخر. والشيء المُفارق في الحالة الايرانية هو قربها الجغرافي من سورية وبالتالي سهولة ان تكون جهة رئيسة مطروقة من قبل اللاجئين السوريين. وعلى رغم ادعاء طهران الرسمي بأن ايران تفتح حدودها للسوريين، وهو ادعاء يحتاج الى تحقق، فإن السوريين انفسهم يديرون ظهرهم لها ويغامرون بأرواحهم ويلقون بأجسادهم في البحار والمحيطات عوض ان يصلوا لإيران بمخاطر لا تقارن مع تلك التي تواجههم عند توجههم الى أوروبا.
لا تبالي طهران وموسكو بطبيعة الحال بملايين السوريين الذين لا يظهرون اساساً على شاشات رادارات الحسابات الاستراتيجية للعاصمتين، حيث ليس ثمة وقت للتفكير اساساً بقضايا هامشية و «تافهة» مثل لجوء ملايين الى خارج سورية، او سقوط آلاف الضحايا. وهذا الاحتقار المُدهش لمعاناة ملايين البشر هو المخيف حقاً في مرحلة الاستعمار الروسي – الايراني الحالية، ذلك انه يسلط الضوء على التفكير الاستئصالي الخطير الذي تترجمه سياسات واستراتيجيات الدولتين. فقد رأينا ترجمة له في نطاق الاتحاد الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وبخاصة في حرب بوتين النازية ضد الشيشان واعتماد نموذج «غروزني» والارض المحروقة ضد الخصوم، والقائمة على إبادة كل ما هو قائم ويتنفس او لا يتنفس على الجانب الآخر. و السياسة ذاتها حدثت ولا تزال تحدث في ايران وان كان بوتيرة أقل وحشية وأبعد من الإعلام ضد كل المكونات غير الفارسية في ايران وعلى رأسها العرب على طول ساحل عربستان والأهواز والداخل. ذلك انه، نسجاً وتناغماً مع تجارب البلدين «الباهرة» في الإزاحة والإبادة الديموغرافية، يتصاعد حديث عنصري وإبادي يكرر بأن اللاجئين السوريين الذين أجبرتهم حرب النظام وحلفائه على ترك بلدهم هم أصلاً من «اتباع» الجماعات التكفيرية او المتعاطفين معها، ومن الذين لا يؤمنون بالعيش المشترك والتعددية الثقافية والدينية في سورية، وبالتالي فإن التخلص منهم شيء جيد ويجب ألا يثير الشفقة ولا التحسر. وتبعاً لهذا التفكير، إذا اضفنا الملايين السورية التي هجرت داخل سورية بعيداً من مدنها وقراها وأريافها وأضفناها الى معادلة «التحليل الإبادي» المذكور لوصلنا الى نتيجة سريعة مفادها أن معظم الشعب السوري صار من اتباع الجماعات التكفيرية، ولا بأس من التخلص منه، وإعادة تركيب سورية ديموغرافياً وجغرافياً. هذه بعض بشائر عهد «تقسيم 2: خامنئي – بوتين» الذي يحتفي به انصار الاستبداد الأسدي هنا وهناك.
*أكاديمي وكاتب عربي