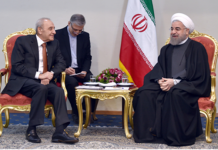تفكيك عقدة سوريا
علي إبراهيم/الشرق الأوسط/15 أيلول/15
لم يكن كثيرون يتوقعون أن تطول الأزمة السورية لتدخل عامها الخامس وأن تتطور بهذا الشكل الذي أصبحت فيه ساحة لتنظيمات غاية في التطرف، وفي نفس الوقت ساحة لصراع بين قوتين عظميين هما الولايات المتحدة وروسيا، بشكل غير مباشر حتى الآن، بخلاف التدخل الإيراني المباشر هناك دعمًا للنظام.
المشهد يبدو غاية في التعقيد، بعد أن تحولت الأزمة السورية بالنسبة إلى معظم الأطراف الخارجية إلى أزمة لاجئين مع وصول عشرات الآلاف من السوريين إلى أوروبا مخاطرين بحياتهم في زوارق المهربين لعبور المتوسط، وفي نفس الوقت ينظر العالم بقلق شديد إلى التنظيمات المتطرفة التي تعمل على الأرض هناك، وتخطط لتصدير الإرهاب إلى بقية المنطقة والعالم. أصبح المشهد أن السوريين أمامهم خياران كلاهما أسوأ من الآخر، «داعش» أو النظام السوري، فاختار الآلاف مغامرة عبور البحر مع كل مخاطرها لبدء حياة جديدة بعيدًا عن جنون «داعش» وبطش النظام. لكن الحرب الأهلية مثل النار التي تأكل في بعضها وتسبب الكثير من الدمار، وفي النهاية تفقد تدريجيًا قوتها، وتمل القوى المتصارعة، ويتبقى منها الرماد. ستنتهي الأزمة السورية في يوم من الأيام، بخسائر كبيرة لا مجال لتعويضها، فهناك نصف الشعب السوري نازح حاليًا ومدن كاملة مدمرة، وآثار تاريخية عاشت آلاف السنين لتلقى مصيرًا مشابهًا لتماثيل لبوذا في باميان بأفغانستان وذلك على يد التتار الجدد الذين يجدون في الخراب تسلية وإشباعًا لنزواتهم التدميرية. المشكلة هي كيف ستنتهي هذه الأزمة؟ وكيف سيتم تفكيك هذه العقدة؟ في ضوء واقع أن فريقي الأزمة حاليًا في غاية التطرف، بينما تبدو المعارضة المعتدلة لا حول لها ولا قوة ولم تنجح في إقناع القوى الخارجية بتسليحها بشكل فعال، وعلى الجانب الآخر حصل النظام على دعم علني من موسكو التي قالت إنها ستستمر في تسليحه باعتباره القوة الوحيدة القادرة على محاربة الإرهاب. وفي حين أن إعلان موسكو استمرار دعمها للنظام مع تقارير وجود مستشارين عسكريين يوحي بأن هناك تصعيدًا قد ينقل الأزمة إلى مستوى آخر، فإن وجهة نظر أخرى قد ترى في هذه المواقف والإعلانات تثبيتًا للمصالح ورسالة للأطراف الأخرى بأنه إذا حانت لحظة الجلوس على مائدة التفاوض فإن لنا مصالح ونفوذًا هنا لا يجب تجاهلهما، وهو ما ينطبق عليه المثل «اشتدي أزمة تنفرجي». ويعزز من ذلك أن لا أحد عاقلا يتصور أن روسيا وأميركا ستضعان قواتهما في مواجهة مباشرة، فهذا لم يحدث في ذروة الحرب الباردة أو في أزمة عالمية شحذت فيها الأسلحة النووية مثل أزمة خليج الخنازير في ستينات القرن الماضي. هذا التدخل الروسي بما يوحي به من تصعيد وصب للزيت على النار يترافق مع أزمة اللاجئين العابرين للحدود والتي وضعت الاتحاد الأوروبي في أزمة ألغت فيها دول أعضاء إجراءات أو قوانين الحدود المفتوحة، يدعوان للاعتقاد بأن ساعة التفاوض اقتربت، وعندما تفرش الطاولة وتوضع الكراسي فإن كل الأطراف يجب أن تكون جاهزة، حتى لا تفرض الحلول دون مراعاة مصالح المنطقة. والحديث عن الأطراف لا يعني «داعش» والتنظيمات الشبيهة، فهذه على الأرجح ظواهر وقتية انتهى دورها.
سوريا تقسم أوروبا
أمل عبد العزيز الهزاني/الشرق الأوسط/15 أيلول/15
لو اكتفى السياسيون في المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك برفض دخول اللاجئين لأسباب اقتصادية، أو عزموا تطبيق أنظمة صارمة لتنظيم تدفقهم، لقلنا إن ذلك من حقهم، وليس على المحسن من سبيل. إنما إطلاق التصريحات العنصرية ضد الهاربين من الحرب والفقر واشتراط معتقد ديني للمقبولين في هذا الوقت العصيب فهو بمثابة عار لحق بأوروبا كلها، وليس له سوى تفسير واحد؛ أن ما فاضت به تصريحاتهم القاسية هو ما يعتمل في صدورهم، ودفعت به قوافل اللاجئين إلى مقدمة المنصات الإعلامية. رفض هذه الدول استقبال اللاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها بسبب ديانتهم المسلمة أو قوميتهم وإساءة معاملتهم على حدودها أمر صادم من دول عانت إلى وقت قريب من التجويع والتشرد والاضطهاد من أنظمة سياسية شريرة، وأعاد إلى الواجهة من جديد فكرة تقسيم أوروبا إلى شرقية متخلفة لا تزال تعاني من آثار الفكر الشيوعي، وغربية متحضرة تحمل قيما إنسانية رفيعة.
الأقليات المسلمة في شرق أوروبا باختلاف نسبتهم في كل دولة، هم جزء من المكون الاجتماعي منذ أكثر من 400 عام، وثقافتهم الإسلامية ليست غريبة على سكان المنطقة التي تتنوع فيها الأعراق والديانات والألسن بشكل لا مثيل له في العالم. ومع أن فترة الحكم الشيوعي التي دامت قرابة أربعة عقود كانت فترة تضييق على المسلمين هناك لكنها لم تنتزع منهم هويتهم الوطنية وإن هجّرت الكثير منهم. في دولة متمدنة كالنمسا تعتمد الدولة على العنصر الأجنبي في زيادة عدد السكان، بعد ظاهرة انخفاض أعداد المواليد فيما يسمى «الطاعون الأبيض». ولأن النمسا غير مصابة بذعر التنوع الثقافي فهي تبدي ترحيبها بالقادمين الذين يمثل فيهم السوريون 40 في المائة، يضمون 12 في المائة سيدات حوامل من نسبة النساء العابرات، وتشجعهم على الانخراط في المجتمع في ظل قانون صارم يمنح حقوقا متساوية ويحمي السلم الاجتماعي من التطرف أو العادات البالية التي تناهض حقوق الإنسان. وهي في هذا الموقف الإيجابي تتبع الزعيمة الأوروبية أنجيلا ميركل التي تمثل حزبها السياسي المسيحي، وتدير هذه الأزمة بذكاء وبراغماتية شديدة، فهي تسعى لتعزيز دور ألمانيا في قيادة أوروبا «أخلاقيا»، وهو دور لا يقل تأثيرا عن دورها الاقتصادي والسياسي، بعد أن كانت برلين رمزا للديكتاتورية والعنصرية المقيتة حتى وقت ليس ببعيد. إنه سلوك الكبار، فالصغار لا يملكون أصلا ما يقدمونه لغيرهم، مع التذكير أننا نتحدث هنا عن 160 ألف لاجئ، أي نحو عشرة في المائة ممن يستضيفهم بلد صغير قليل الموارد مثل لبنان، وهؤلاء سيوفرون قوى عاملة يمكن استيعابها في دولة مثل ألمانيا تعتبر واحدة من أكبر اقتصاديات العالم، والأفضل في مقاييس الحياة الكريمة من دعم حكومي مباشر وخدمات صحية وتعليمية، وتخطط المستشارة ميركل أن تصنع من الشباب القادمين قيمة مضافة واستثمارا طويل الأمد. الإعلام الاجتماعي الذي ضخم القضية، عكس تأثيره حتى على الإعلام الرصين الذي هلل للموقف الألماني والفرنسي والبريطاني جاحدا الموقف الخليجي الذي بادر منذ اندلاع الثورة السورية إلى جعل المواطن السوري منطلقا لمواقفه السياسية. وزارة الخارجية السعودية اضطرت لإطلاق تصريح يوضح حجم ما قدمته السعودية للسوريين خلال الثلاث سنوات الماضية، ردا على التقارير الإعلامية التي ضللت الرأي العام، وكشفت الوزارة أن السعودية استقبلت مليونين ونصف المليون سوري ومنحتهم حرية الحركة والعمل وخدمة التعليم والصحة، عدا تقديم المساعدات المالية واللوجستية لدعم السوريين في مخيمات لبنان والأردن، إضافة إلى مليون يمني لجأوا للسعودية بعد اندلاع الحرب في اليمن.
هناك أمر يخفى على القائمين على كتابة التقارير الصحافية في الغرب، وهو أن السعودية لا تقدم مساعداتها الإنسانية للسوريين واليمنيين والفلسطينيين تنفيذا لواجبها الدولي الذي يحتم مساهمتها في التخفيف من الأزمات فحسب، بل من منطلق ديني وعروبي بشكل خاص، وهذا الأمر عرْفٌ وتقليد ثقافي موروث، وهي ترى أن العمل خلاف ذلك قلة في المروءة وإساءة للذات، وعدم الإعلان الدوري لهذه المساعدات يدخل ضمن هذه الثقافة التي تعيب التباهي بتقديم العون للآخرين وتعتبر ذلك من العمل الخيري الذي يتبعه أذى. والذين يدللون بهذا العمل على أن السعودية اختارت من الوافدين من يوافقونها سياسيا أو مذهبيا وبالتالي من حق الأوروبيين أن يشترطوا بدورهم لاجئين مسيحيين، هم في الحقيقة غارقون في استنتاجات غير صحيحة. الموقف السعودي لم يقم بفرز السوريين واليمنيين على أي أساس، واعتمد على موروث الاستجابة للمستجير ونصرة المظلوم وإكرام الضيف، تماما مثلما الديمقراطية وحقوق الإنسان مبادئ أساسية في أوروبا، وبالتالي هذه الدول الأوروبية الأربع التي رفضت دخول اللاجئين أو اشترطت ديانتهم هي من خالفت قيمها ووشمت نفسها بعار العنصرية التي تدعي أنها تحاربها. بشار الأسد نجح نجاحا ساحقا في جعل الشعب السوري مشردا في بقاع الأرض يستجدي الحياة على عتبات محطات القطار ونقاط العبور، أسوأ بكثير مما ارتكبته إسرائيل في حق الفلسطينيين. خمسة ملايين لاجئ سوري هجروا أرضهم فارين من قمعه وبطشه وأطماعه، لم يستقبل أصدقاؤه في روسيا سوى 400 لاجئ وعلى مضض، لم يستطع بعضهم مباشرة دراسة أبنائه إلا مؤخرا، لأن الدور الروسي مقيد بدعم الأسد عسكريا، وكذلك فعل الصينيون، أما الإيرانيون فكان لهم موقف أشد معاكسة للموقف الخليجي والأوروبي، حيث استقبلوا مئات الأسر من اللاجئين الأفغان والعراقيين ثم أرسلوا أبناءها إلى سوريا للقتال بجانب الأسد مقابل حياة واستقرار أهلهم. في الأزمات تنكشف النوايا، ويظهر الصدق، وتبطل الادعاءات، ويبقى الواقع هو المتحدث الرسمي باسم المنكوبين.
انهيار ثقافة الممانعة والكراهية للغرب
غسان الإمام/الشرق الأوسط/15 أيلول/15
أستعير «موسم الهجرة إلى الشمال» من الروائي السوداني «المهاجر» الطيب صالح الذي سكن الـ«بي بي سي». اللندنية أعواما طويلة قبل أن يعود إلى الوطن تائبا مستغفرا، لأقف متمهلا ومتأملا موجة هجرة السوريين إلى الشمال التي هي أكثر من مجرد استقالة من الوطن. هذه الهجرة أيضا تعبير شعبي عضوي عما أصفه بانهيار ثقافة الكراهية للغرب والعداء لأميركا التي أشاعها النظام الرئاسي العربي الوارث «لأمجاد» الناصرية، منذ أوائل سبعينات القرن الماضي. العداء الشخصي المتبادل بين صدام حسين وحافظ الأسد، لم يكن حائلا دون تغذيتهما المشتركة لثقافة العداء والكراهية للغرب، للتمكين لنظامهما التسلطي من العيش والبقاء. والقضاء على أي تلمس اجتماعي عربي، لفكر إنساني تعددي وديمقراطي. ارتكب صدام غلطة الشاه الإيراني المخلوع، فظن أن غدره بالنظام الخليجي باحتلال الكويت، سيقنع أميركا بالانسحاب لصالحه من مياه الخليج. أما حافظ الأسد فقد وصل تحت ظلال ثقافة العداء للغرب إلى الانكفاء عمليا عن مشروع البعث القومي الوحدوي، للتحالف مع نظام الملالي الشيعي، نظام خميني وخامنئي الذي استولد من شعار «الموت لأميركا» طاقة جديدة لتعميق ثقافة العداء للغرب، ونحت وتصنيع شعار «الممانعة». وكان إحياء الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لمشروع أحمد الشقيري الكلامي بإلقاء اليهود في البحر، مدعاة للسخرية من سذاجة وزيف شعار «الممانعة» الذي سقط فجأة مع شعار «الموت لأميركا»، ببصم الملالي الاتفاق النووي معها بالأصابع العشر. ومشاركتهم في ذبح السوريين. في تصفية صدام والأسد لقوى اليمين المحافظ واليسار الماركسي والاشتراكي في العراق وسوريا، فقد لجآ إلى نظرية «التخوين» لملاحقة المطالبين بالحرية والديمقراطية. وإدانتهم بالعمالة للغرب، أمام مجتمعات عربية غدا عقلها في آذانها، وهي تسمع وتردد ببغاوية شعارات المقاومة. والممانعة. والعداء الممل لأميركا والغرب. الشعوب لا تستطيع أن تعيش على أوهام وشعارات. يفقد الوطن قيمته إذا لم يوفر طعاما. وسكنا. وعملا. ومساواة. وكرامة. كنت قد حذرت في التسعينات من الفساد. وسوء التخطيط والتنفيذ في منطقة الجزيرة (شمال شرقي سوريا) الخصبة التي كانت تطعم قمحا. وتصدر قطنا. وتنتج نفطا. هاجرت أولا القبيلة العربية احتجاجا على الإهمال. فوجدت لدى أهلها وامتدادها العشيري في الخليج عملا وملجأ، تاركة الأرض للفلاحين والعمال. ومعظمهم من الأكراد الذين ما لبثوا هم أيضًا أن نزحوا إلى أحزمة البؤس حول المدن الكبرى، هربا من الفاقة. واللامبالاة. والإهمال. ثم تورط المتعصبون منهم في محاولة إيقاظ الذاكرة العنصرية للأسر الكردية المستعربة والمندمجة تماما في المجتمع العربي السوري. فاصطدموا مع النظام وعرب المدن الكبرى. ارتكبت مجازر دموية لم تكن كافية لتنبيه الأسد الأب والابن. كان هم الأب المصاب بوهن الذهن والعقل (dementia)، الحفاظ على خيول الفارس الابن المدلل (باسل) الذي اعتبر «شهيد» السمر واللهو بالسيارة «السبور» إلى آخر الليل في شوارع دمشق. تم استدعاء الابن الآخر، لتلقى بين يديه مفاتيح الدولة. والقرار، قبل أن يكمل دراسته. وتنضج أهليته. ويستكمل وعيه السياسي والاجتماعي. فألهته ثرثرته الإنشائية عن إدراك ومداراة التركيب المعقد للمجتمع السوري. وتفادي أزماته المهددة بالانفجار. النظام الحاكم يجب أن يتحلى بحد أدنى من كبرياء الحكم، وفضيلة التعامل مع المواطنين الأبرياء المحتجين. بدلا من ذلك، تعامل النظام مع الاحتجاج الشعبي السلمي بالشر. والقتل. والتعذيب حتى الموت في سراديب الاعتقال. بات بشار في النهاية بحاجة إلى مرتزقة إيران وميليشياتها لارتكاب المجازر في سوريا، وهم منتشون بثقافة الأضرحة التي أنعشتها عدائية التدخل والاختراق. وهكذا أصبح اللجوء المؤقت إلى الدول الشقيقة حلا للنازحين السوريين. ثم الاستقالة نهائيا من الوطن. والهجرة إلى الشمال (أوروبا) هربا من الموت والإبادة، لمجتمع مفكك في عراه الاجتماعية. ومحكوم بنظام جائر. بلا ثقافة. وبلا قيم إنسانية. أتفرس في سحنة هؤلاء المهاجرين. فأجد فيها ملامح متنوعة. غريبة: كردية. تركمانية. باكستانية. بنغلاديشية. أفريقية. عربية… متهادنة حينا ومتناحرة أحيانا. الخطر في هذه الهجرة الجماعية الهائلة كونها نسيجا غير منسجم في ثقافته. ووعيه السياسي. ولا أظن أنه قادر على الاندماج والذوبان، في مجتمعات أكثر تنظيما. وانضباطا في سلوكها الاجتماعي. وهذه الهجرة معرضة غدا للاضطهاد والتهجير، إذا ما اندست في طياتها عناصر العنف الديني، مستغلة أميتها الدينية والسياسية.
في هذه الفوضى الديموغرافية، أسأل عن مصير وطن عربي يجري تفريغه. وتغريبه. بل أسأل عن مصير النظام الرأسمالي المزدهر في ألمانيا وأميركا. هل هو قادر حقا على صهر ملايين المهاجرين إليه في بوتقته الرأسمالية التي باتت عاجزة عن الدمج. وعسيرة الهضم. والاستيعاب. وتغييب الهويات والانتماءات؟
تقاعس أميركا أوباما الذي لم يدرك، في انهزامية ثقافته السياسية، أن فرصة انهيار ثقافة العداء والكراهية صالحة للتدخل المباشر، لترحيل نظام فاجر يمارس إبادة شعبه، ربما لتوطين جماعات شيعية متخلفة مستوردة من أفغانستان. وإيران. مع ميليشيات «الحشد الشيعي» العراقية بقيادة ضباطها الإيرانيين.
لم يدرس علماء الاجتماع. والتاريخ. والسياسة. والإثنية في أوروبا قضية الهجرة السورية الجماعية. أجد النظام الأوروبي معتبرا لها، قضية اندماج. واستيعاب. وانتزاع شعب من أرضه. وبيئته. وانتمائه. فغدت سوريا «قضية تهجير» تستوجب الشفقة والرحمة، أكثر من كونها «قضية تحرير» ولو بالقوة الدولية.
ثمة ميل مغرض في الإعلام الغربي، لاتهام الدولة الخليجية بعدم استيعاب الهجرة السورية الجماعية لديها. ربما كان تقديم مزيد من العون المادي للمهاجرين ضروريا. لكن يبدو أن النظام الخليجي متنبه لخطر انتزاع كتلة سكانية عربية من بيئتها السورية، لدمجها كعمال في أعمال يأنف العامل الأوروبي من أدائها.
مع فورة النفط وتعريب موارده، استوعب الخليج العربي، وما يزال، أجيالا متعاقبة من ملايين العمال والعاملين العرب الذين يتمتعون بحرية تحويل مدخراتهم إلى بلدانهم، للمساهمة في إعمارها ولمساعدة أسرهم. لكن هناك ضرورة لفهم خوف المجتمعات الخليجية الصغيرة عدديا، من خسارة انتمائها القومي وهويتها المحلية، في بحر متلاطم من ملايين العمال الآسيويين والأفارقة. ليست هناك أرقام دقيقة لعدد العاملين العرب في الخليج. إنما هناك تقدير كيفي لعدد السوريين الذي يتراوح بين مليون ومليونين من المقيمين. وهم مرغوبون هناك لجديتهم في العمل، من دون تشكيل شلل تحتكر العمالة، كما تفعل «ثقافة الشلة» عند البعض من الجنسيات الأخرى. أما العاملون اللبنانيون فقد أساء إليهم استغلال «حزب الله» لبعضهم في أعمال تتنافى مع الأمن الخليجي. مع سذاجة التعليق السياسي العربي، بترحيبه الإعلامي بالسخاء الأوروبي في استضافة المهاجرين السوريين، أستغرب جمود وحيرة علماء السياسة. والاجتماع. والتاريخ العرب، إزاء هذه الاستقالة السورية الجماعية من الوطن. وظاهرة انهيار ثقافة الكراهية والممانعة. لا بد من تحرك أكاديمي علمي وفكري، لدراسة واستيعاب ما يحدث، لتنبيه النظام العربي، إلى خطر تهجير العرب، وإحلال أقوام بديلة لهم في المشرق العربي. وإسقاط الحدود، لإقامة أنظمة أعجمية. أو مذهبية غريبة عن الانتماء العربي. لعل نظام الاستقلال العربي يدرك، في أزماته الراهنة، أن المصير واحد ومشترك. لا فرق بين بلد ينعم بالثروة والاستقرار. وبلد يشقى بالموت والدمار.