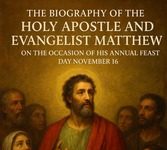LE PAYS DES CÈDRES
عقل العويط/النهار/1 آب 2015
لبنان ينحلّ. كشجرة أرزٍ عظيمة يأكلها السوس، وليس ثمة نارٌ تكوي هذا السوس. أخطر أنواع الانحلال هو انحلالنا الروحي، نحن كمواطنين. ليس الجسم المنحلّ، هو الذي يخطر في البال، بل العقل الانحلالي الذي يتسلّل عطبُهُ إلى كلّ ذرّة من ذرّات وجودنا، ويضرب سلّم القيم الجماعية والفردية، ويخلخلها، ويفتك فتكاً ذريعاً بكلّ ما يتصل بها من بنى أخلاقية. لم يبقَ عندنا شيءٌ جليلٌ يُعتدّ به، قيمياً وأخلاقياً. لقد انفرط عقد المهابة الروحية الذي يضع الخطوط الحمر، القادرة وحدها على الحؤول دون تجاوز ما لا يجوز تجاوزه، ودون كسر ما يُحرَّم كسره. كلّ شيء بات عندنا قابلٌ للإهانة والتمريغ. لا شيء محرَّماً البتّة، بعد الآن، قيمياً وفكرياً ودستورياً وقانونياً ومجتمعياً ودينياً وسياسياً. ففي غمرة ما ترتكبه عقولنا وأيدينا، ويحدث الكثير منه أمامنا، ما الذي يحول مثلاً دون انصراف مواطنينا اللبنانيين، سادةً ورعايا، رؤساء ومرؤوسين، إلى ممارسة النهب العلني العام، والاعتداء الفاجر على المؤسسات العامة والخاصة، أو مباشرة الخطف على الهوية، أو الخطف لقاء فدية، أو نصب المتاريس، وإعلان الحروب الأهلية أو الدينية مجدداً، أو إنشاء جمهوريات بلدية حيث تدعو الحاجة، أو حيث تتصاعد نبرات الغرائز، وحيث أيضاً يستدعي المزاج العصبي، في بعض المربّعات والمدن والدساكر والشوارع والأحياء ومناطق النفوذ، على اختلاف مستوياتها؟
* * *
إنه الانحلال. لا أجد وصفاً أدبياً أصف به هذا الانحلال، ويكون لائقاً بالأدب. يعزّ على الخيال أن يجد نفسه عاجزاً أمام عبقرية الواقع اللئيمة. الرواية التي تجري وقائعها ها هنا، ليست تلك التي يختلقها الراوي، بل هذه التي تشهدها الحواس، وتحياها. يقال عن الأدب العظيم إنه يخترع. بئس الأدب! ليس من اختراعٍ أعظم من “أدب” الواقع اللبناني، مرئياً ومعيشاً في السياسة، وفي المجتمع، وفي الدين، وفي ممارسة الشأن العام، وفي هلمّ، على السواء.
عبثاً يصنع المخرجون الأفلام. عبثاً يرسم الرسّامون الرسوم! أما الشعراء فالأجدى أن يفسحوا في المجال أمام هذا الشعر الذي تسطّره جحيمنا اليومية، بجمرها المتراكم جمراً فوق جمر.
إنه الأسى الأعظم؛ وهو من النوع الذي يقضّ مضاجع الروح، ويقتل الأمل، ويجرح العقل جروحاً لا شفاء منها. أحسب أن كثيرين من اللبنانيين – على قلّتهم – يضعون رؤوسهم بين أيديهم، في خلوات تيههم التراجيدي، وفي لياليهم البيضاء، ويروحون يبكون البكاء المرّ المذكور في تواريخ الشعوب والبلدان المندثرة. إنهم في الغالب من أولئك البشر الذين يرفضون أن يكونوا شهود زور على الانحلال الرهيب، فلا يجدون في قلوبهم المطعونة وعقولهم المشلولة، سوى إعلان اللاجدوى من الاعتراض، مؤثرين الرزوح والاستسلام والخنوع، أو التزام الصمت الذي يهشّل أصحابه إلى الجنون العظيم.
إنه الأسى، وهو من النوع يجعل الفكر المعطوب يتكئ الاتكاء العبثي على الهاوية، مفضِّلاً أن ينام نومته المميتة على أن يواصل المكابرة المجانية. في غمرة هذا الأسى الجماعي، أجدني أكاد أقول إن الأمل في استنفار انتفاضةٍ روحية لدى هؤلاء المضروبين بأخلاقهم وقيمهم وسلّم معاييرهم، لم يعد ذا فائدة. هل أكون أغالي إذا وقفتُ قليلاً أمام مشهد لبنان هذا، وقد آل إلى مصيره المقزِّز، متدثّراً ومضفوراً بالنفايات التي تغمر أرضه وبحره، وهي حصيلة عقود من التمرّغ في النفايات، نفايات السياسة والسياسيين، والمواطنة والمواطنين، لا محض مشكلة تقنية فحسب مع شركة جمع النفايات؟ وهل أكون أغالي إذا طلبتُ لا أن تُرفَع هذه النفايات، بل أن تزداد وتتراكم، إلى أن تأكل أمراضُها هذا البلد العظيم أكلاً نهائياً، وتبعث الفناء في تكفيرييه وإرهابييه وقراصنته وسرّاقه وناهبيه وفاسديه وسياسييه واقتصادييه ورجال دينه وأعماله ونخبته وطبقاته العليا والوسطى والدنيا على السواء؟!
هل أكون أغالي حقاً، إذا سمعتُ بعض مواطنيَّ يلعنون لبنان وأهله؟ لا. ليس من مغالاة. أنظروا معي إلى كارثة هذا السقوط المدوّي للمعايير، التي يُفترض أن المسؤولين والناس العاديين “يقدّسونها” وينتظمون تحت قوانينها وأعرافها، في الحيّز العام، وقد صارت خرافةً منسية، أو موضعاً علنياً للاستهزاء والغمز والانتهاك؟ وماذا أقول عن القتل لأقلّ الأسباب تفاهةً، على مرأى من الجمهور الكريم ومن عيون السلطات؟ وماذا أقول عن القتل المادي والمعنوي المنظّم، من خلال فضائح الفساد التي تضرب كلّ شيء، وفي كلّ مكان، وتتسرّب إلى الطعام والدواء والماء والهواء والبيئة، وتجعل لبنان برمّته أرضاً منكوبة، والحياة نفسها أمراً ميؤوساً منه؟
كلّ عيشٍ يُعاش هنا، إنما هو نوعٌ من الإذلال الذي لا يوازيه إذلال. لقد صرنا مزبلة العالم ومزبلة أنفسنا، حتى بتنا مسخرة الكرة الأرضية وموضع قرف الجميع.
لو أُخضِعنا لمعيار الفساد والرذيلة الوطنية، لفزنا بين المراتب الأولى في العالم. حياتنا الشخصية والعامة تتعرّض هنا لأبشع أنواع الاعتداء. وأكاد أقول لمواطنيَّ؛ أنا الذي ينبغي لي أن أتجنّب اليأس، وأتمرّس بالأمل، وأتمترس وراء أعتى صخور العناد وجبال الرفض، لأصون هذا الأمل، وأحرسه برموش العقل والكلام، من كلّ إرهاب وترهيب؛ إن العيش لم يعد يُحتمَل في جمهورية الموز اللبنانية هذه. لقادرٌ فقط أن يعيش في لبنان مَن ليس فيه دم، ومَن ليس في يده حيلة للانتحار، أو للهجرة إلى مكان آخر. لقادرةٌ خصوصاً أن تعيش أيضاً فيه، عصاباتٌ ومافياتٌ من كلّ نوعٍ وإسّ، ومن كلّ دينٍ وحزب، بالتكافل والتعاضد في ما بينها، موضوعياً، وبالتقاتل وإعلان العداء ظاهراً فحسب.
أنحن حقاً اللبنانيين الذين “ومن الموطن الصغير نرود الأرض نذري في كل شطً قرانا/ نتحدى الدنيا شعوباً وأمصاراً ونبني أنّى نشأ لبنانا؟”، أبلدنا هو حقاً هذا البلد الموسوم “لبنان الشاعر” و”وطن النجوم”، أم هو بلد الفضيحة الروحية العظمى والانحلال والزعران والقتلة والفاسدين؟
* * *
لا. لبناننا ليس “لبنان الشاعر” ولا “وطن النجوم”، بل هو هذا اللبنان المزبلة العامة. أما اللبنانيون فكاذبو أديان ومنافقو قيم. وها أنا أشهد غير هيّاب، فأقول بصوتٍ مزلزِلٍ، إنه لو كان للأديان أن تنفض يدها من المؤمنين بها، لكان عليها أن تنفض يدها من هؤلاء الذين “يؤمنون” بالإسلام وبالمسيحية في لبنان. لم أرَ شعباً يبلغ فيه الانفصام بين القول والفعل، بين الظاهر والباطن، هذا الحدّ المَرَضي المستفحل، مثلما هي حال هذا الشعب اللبناني العظيم، الذي يكذب الفرد منه ألف مرة في النهار، على نفسه، وعلى عائلته، وعلى القريبين منه والبعيدين، في حين لا يتورّع عن إطلاق أغلظ الأيمان بأنه إنما يجهر بالحقّ والحقيقة، حتى ليقتنع هو نفسه بأنه يقول الحقّ ويشهد للحقيقة. أيّ شعبٍ هو هذا الشعب، الذي يؤمن بأنه مهما ارتكب، هو وسياسيوه، من موبقات، فإنما يرتكبها لأجل غاياتٍ وأهدافٍ سامية، تيمّناً بالقول المأثور “الغاية تبرّر الوسيلة”؟ هذا الشعب الذي يصلّي في سرّه وفي علنه، ألف مرّةٍ ومرّة لمسيحه، وألف مرّةٍ ومرّة لمحمّده، من أجل أن يحظى بالمشاركة في نهب خيرٍ عام، أو من أجل أن ينصره هذا النبي أو ذاك الرسول على ابن ملّته، لكنْ من مذهب آخر، أو ينصره على مواطنه من الدين الثاني، لم أجده مرةً واحدة يصلّي دعاءً من أجل فقير، أو نصرةً لقضية عظمى، أو من أجل التكفير عن أخطاء وخطايا، أو من أجل أن يحبّ بعضه بعضاً، ويتكاتف بعضه مع بعض لدرء الأخطار التاريخية المخيفة التي تحدق بالبلد العزيز؟
يا لهذا الشعب “المؤمن”، الذي أراه في كل لحظة يلعن الكفّار والإرهابيين والتكفيريين والقتلة، في حين أني أراه بأمّ العقل والعين يمشي في ركابهم مشياً مهيباً، كأن غيره هو الذي كان يلعن هؤلاء لعناً مجلجلاً.
* * *
لا تبحثوا في لبنان عن حلول. لا الأديان هي الحلّ، ولا الديموقراطية، ولا الحقّ، ولا العدالة، ولا القانون، ولا القيم، ولا المعايير. صدِّقوني وحدها المزبلة الآن هي الحلّ. بعد قليل، يأتي أوان “الأرض المحروقة”. وفي الأخير الأخير، لا بدّ من وردة تطلع من الأرض الخراب! وسنكون في الانتظار! يسمّونه في بلاد الفرنسيس LE PAYS DES CÈDRES وهو اسمٌ على مسمّى.