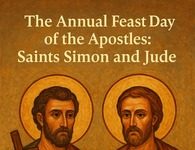زيارة بايدن… بين التوقعات والإنجازات
نديم قطيش/الشرق الأوسط/12 تموز/2022
عشية زيارته إلى الشرق الأوسط، كتب الرئيس الأميركي جو بايدن مقالاً مفصلاً في صحيفة «واشنطن بوست» يشرح فيه مقاصده من الزيارة، وتوقف في مقاطع كثيرة عند المملكة العربية السعودية، حتى حين لم يذكرها، حيث إن طرق الكثير من الملفات التي عرضها تمر في الرياض. لكن الرسالة الأهم هي عبارته اللافتة التي يتعهد فيها بـ«تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية»! هل نحن أمام مبالغة خطابية جديدة، ولكن في الاتجاه المعاكس تماماً للمبالغات التي أضرت بالعلاقات بين الرياض وواشنطن، أم أمام نقطة تحول حقيقية باتجاه «تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية»؟ في السياسة، تكاد تكون إدارة التوقعات، هي السياسة نفسها، في التعريف الأخير. هذه الإدارة للتوقعات هي أكثر ما يَلزم اليوم بإزاء متابعة زيارة الرئيس بايدن إلى المملكة ومشاركته في القمة الخليجية الموسعة التي تستضيفها مدينة جدة، بغية التفريق بين ما هو مشهديات احتفالية بكل ما تحمله من معانٍ رمزية مهمة، وبين ما هو نتائج سياسية عملية للحدث السياسي. تحتاج الزيارة، ولأسباب أميركية في الغالب، إلى الكثير من «إدارة التوقعات» بشأنها بعد ما نسب إليها من قدرات تغييرية على مستوى الشرق الأوسط برمته ما لم يكن على مستوى العالم.
على مستوى العلاقة الثنائية، لا خلاف على الأهمية الرمزية والسياسية للتغيير الذي طرأ على موقف الإدارة الأميركية من المملكة، والإدراك الواقعي والموضوعي لموقعها في الشرق الأوسط والسياسة الدولية. وأميركياً، يشير هذا التغيير إلى إدراك الحدود التي يمكن أن تذهب إليها سياسة خارجية تقوم بشكل مبسط وشبه حصري على مثاليات أخلاقية، لا سيما حين لا تكون السياسة الخارجية الأميركية ثابتة في تبني هذه المثاليات مع جميع الدول وفي كل الملفات… فهذا تغيير يصب في مصلحة أميركا أولاً لأنه يعيد الكثير من التوازن إلى دورها وقدرتها على المناورة وبناء التحالفات في عالم صاخب ومتوتر تحاصره استحقاقات وجودية حول أسئلة المستقبل في الاقتصاد والصحة والأمن. وسعودياً، تشكل الزيارة بلا أدنى شك انتصاراً سياسياً كبيراً لموقف المملكة، ولمعركة الهيبة والحضور والموقع التي خاضها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بكل هدوء ورصانة، خارج تقاليد «العنتريات العالمثالثية» العربية وغير العربية التي يعج بها أرشيف علاقات هذه الناحية من العالم مع الدولة الأولى فيه.
فحين تحدث الأمير محمد في أكثر من إطلالة، لا سيما في مقابلته في مجلة «ذي أتلانتيك» تحدث بلغة المصالح المشتركة ومعرفة كل طرف بها وما يريده من الآخر، مؤكداً على ما تراه وتريده الرياض من العلاقات الأميركية السعودية كما من علاقاتها بكل الأقطاب الرئيسية في العالم اليوم. الأهم أنه قسم حديثه ورسائله إلى قسمين؛ ما يتعلق منها بأميركا، وعظمتها السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، وبين إدارة محددة صاحبة موقف محدد، لها فيه ما لها وعليها ما عليها. في الأبعد من ذلك، يبدو لي أن ثمة خلطاً غير موفق في المقالة الرئاسية بين «تعزيز العلاقة الاستراتيجية الأميركية السعودية» وبين ملفات معقدة كحرب اليمن والسلام العربي الإسرائيلي والملف النووي الإيراني والتنافس الصيني الأميركي، وهي ملفات يحتاج التفاهم حولها مع واشنطن، إلى الكثير من المكونات والعناصر غير المتوفرة الآن، أو غير المكتملة، أو أن بعضها يتطور بمعزل عن واشنطن ودورها فيها.
لا تحتاج المملكة لدور أميركي يذكرها بضرورة انتهاء حرب اليمن. فهذه حرب اضطرار لا حرب اختيار من وجهة نظر الرياض، وانتهاؤها لا يقتصر على قرار تتخذه القيادة السياسية، من جانب واحد. قبل أيام فقط كشفت البحرية الملكية البريطانية أن إحدى سفنها الحربية صادرت أسلحة إيرانية، بما في ذلك صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز، من مهربين في المياه الدولية جنوب إيران في وقت سابق من هذا العام. وأشار بيان البحرية الملكية إلى أن صاروخ كروز من طراز 351 الذي يبلغ مداه ألف كيلومتر، كثيراً ما تستخدمه جماعة الحوثي اليمنية لاستهداف السعودية والإمارات!
يبدأ تعزيز العلاقات الاستراتيجية السعودية الأميركية من تطوير الفهم الأميركي لأزمة اليمن ونقلها من إطار «الأزمة الإنسانية» إلى إطارها الواقعي كجزء من «أزمة الدور الثوري الإيراني في المنطقة».
ولا تحتاج المملكة أيضاً لدور أميركي في تعزيز السلام في الشرق الأوسط، خارج الدور الأميركي الموضوعي في عملية السلام الإسرائيلي الفلسطيني. أما العلاقات السعودية الإسرائيلية فلها مسارها الذي ينطلق من مصالح الطرفين والرؤية التي عبر عنها الأمير محمد بن سلمان بلا قفازات حين وصف إسرائيل بالحليف المحتمل. وهذه العلاقة تتطور كجزء رئيسي من الهندسة الاستراتيجية الآخذة في التشكل في الشرق الأوسط تحديداً بسبب الانطباعات المتنامية عن ارتباك الدور الأميركي والنوازع الانسحابية التي تصيبه بين الحين والآخر.
كما أن المملكة لن تحشر نفسها في زاوية الخيار بين الصين وأميركا، كما كانت الحال إبان الحرب الباردة. فالصين ليست الاتحاد السوفياتي في فهم مصالح الأمن القومي السعودي. أما العلاقات التجارية والنفطية والشراكات المتعددة في مجال السلاح والتكنولوجيا وتطوير الموارد الطبيعية غير النفطية، بين الرياض وبكين، فليست من النوع المعروض للمقايضة، بل يشكل قاعدة استراتيجية لتنويع علاقات المملكة وصون موقعها في العلاقات الدولية، لا رد فعل مؤقتاً على موقف الإدارة الأميركية.
كل هذا يسير بمعزل عن سوء أو جودة العلاقة بواشنطن.
ما ينقص زيارة الرئيس بايدن إذن، هو الإحساس بأن الشراكة الاستراتيجية التي يتم الحديث عنها تنبع من كونها خياراً واضحاً بين بلدين يقوم على تحديد المخاطر وتعريف المصالح، ويغلب عليها الشك أنها تعبير عن ارتباك سياسي لحكومة تخفي أزمة مؤقتة.
واشنطن اليوم ليست في أفضل أحوالها، وهذا أمر يحزن حلفاءها في الشرق الأوسط العاقل، ويفرح الأعداء المشتركين معها.
فأميركا تواجه، مع العالم، أعلى مستويات التضخم في عقود، وحوادث إطلاق النار الجماعي شبه الأسبوعية تنال من روعة الحلم الأميركي حول العالم، وطبول الحرب الأهلية القيمية حول الجندر والعرق والجنس والإجهاض تصيب الأمة بمستويات غبر مسبوقة من القلق… أما التشاؤم فهو سمة المواطن الأميركي اليوم حيث تشير آخر الاستطلاعات إلى أن 10% فقط من الأميركيين يعتبرون أن البلاد تسير على الطريق الصحيح.
هذه ليست ظروفاً موضوعية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، بل فرصة جدية للبحث العاقل فيها بعيداً عن الأوهام التي أضاعت الكثير من الوقت والرصيد وبددت الكثير من مخزون الثقة.