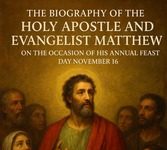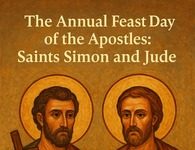عن مصير لبنان البلد المحتل
منى فياض/النهار
27 كانون الأول 2014
من الآخر كما يقولون: في هذه الاوقات الحرجة التي نرقص فيها على “حافة الهاوية” لا خلاص للبنان، ولا مستقبل، إلا في حب هذا الوطن والولاء التام له تحديداً: لبنان الدولة. لا يمكن أي مرجعية ولا أي دولة ولا أي سلطة أن تسبق أولوية هذا الولاء المطلق، أو حتى أن تشترك فيه. إن أي ولاء آخر يتشارك مع الولاء للوطن هو من أفعال “الخيانة العظمى”.
25 عاماً مرّت على توقيع اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية رسميا. مع ذلك، لم نعرف السلم، ولا نزال نعاني أنواعاً أخرى من النزاعات والصراعات والحروب الباردة والساخنة، الأهلية منها وتلك التي تتخطى الحدود. فما هي مشكلتنا إذاً؟
اعتاد المرجع القانوني والنائب السابق حسن الرفاعي أن يردّ على مَن يقول له أنت لا تريد وقف الحرب في لبنان، لمعارضته وثيقة اتفاق الطائف، بالسؤال: وهل صيغة الدستور اللبناني هي سبب الحرب في لبنان؟
بمعزل عن الجدال الذي قد يطول حول وثيقة الطائف وطريقة اتمامها وتوقيعها، أو حول التعديلات التي يجب أن تطالها أو تطال القوانين والدستور، يمكن الاشارة بسرعة إلى أن اتفاق الطائف يحوي جملاً وإشارات وعدداً من الأحكام الغريبة والأمور الملتبسة التي تحمل بذور التعطيل في داخلها، بحيث أدّت ممارستها الى شرعنة التغيب والمقاطعة والتعطيل لمجلس الوزراء. فالسعي الضمني كان يهدف الى تكبيل عمل السلطات وشلّها من الداخل عبر آليات تجعل سلطة الوصاية الجهة الوحيدة القادرة على الحسم. ذلك ما أدّى الى تسميم عمل المؤسسات وعدم انتظامها، بل وتعطيلها.
سأكتفي بمثال واحد لإظهار بعض تناقضات اتفاق الطائف؛ ففي المادة 69 يتم اللجوء، بحسب قراءة الرفاعي، الى تدبير عجيب بحيث تُربَط إقالة وزير بموافقة زملائه بنسبة الثلثين، في حين أن استقالة ثلث الوزراء زائداً واحداً تطيح كامل الحكومة. لكن ثلثي الوزراء ناقصاً واحداً، لا يكفي لإقالة وزير واحد!
هذا التدبير الذي أدّى الى ما سُمّي بالثلث المعطّل، والبعض سمّاه الضامن، لم يكن مطلبا لأيّ فئة، لا من المسلمين ولا من غيرهم، في أيّ يوم من الأيام. بل أُدخل بقدرة قادر على ما يبدو. وهذا ما يسمح بالاستدلال أن ما حصل في الطائف ليس توافقاً على الاصلاحات التي تمت، بقدر ما هو توافق دولي لإرغام المجتمعين على القبول بالوثيقة على عللها لتغطية جعل لبنان تحت الوصاية السورية بقبول وتواطؤ دوليين. على كل حال، عجز اللبنانيون عن تنفيذ الاتفاق كاملاً بسبب العرقلة السورية. وظل السلاح فالتاً خارج سلطة الدولة؛ فلم تُفد الاصلاحات في تأمين السيادة. ففي زمن الخضوع للهيمنة السورية كان القصد المحافظة على هشاشة التوازن الداخلي وغياب هذا التوازن في الكثير من الأحيان من أجل اللجوء إلى سوريا لحسم الخلافات في التفسير والتطبيق وخلافهما.
وبما أن المشكلة في الأصل لم تكن دستورية أو قانونية بل سياسية، وصراعاً على السلطة، فلن يمكن الخروج من هذا المأزق الا عندما ينال لبنان حريته واستقلاله بحيث يستعيد سيادته الحقيقية على جميع أراضيه من دون هيمنة فئة وطغيانها، حيث تقيم دويلة داخل الدولة وحيث يأتمر “جيشها” بأوامر دولة أجنبية، وتخضع في جميع أمورها الى إملاءات الخارج الالزامية التي يتم التعامل معها كفتاوى شرعية.
في السنوات التي تلت اغتيال الرئيس الشهيد الحريري وخصوصاً منذ ما بعد اندلاع الثورة في سوريا، لاحظنا انتقال الهيمنة والوصاية من النظام السوري الى النظام الايراني، وهما تتمّان بواسطة مكوّن محلي بدأ بتحويل سلاحه من مواجهة اسرائيل، العدو الاساسي المفترض، الى الداخل، فاحتل وسط بيروت لمدة عام ونصف العام، لإسقاط الحكومة، ونفّذ في أيار من العام 2008 ما عُرف بغزوة بيروت حيث تم الاعتداء على سكانها مما تسبب باستشهاد نحو 100 ضحية، مستكملاً ذلك بالاعتداء على “تلفزيون المستقبل” وصحافييه.
بعد هذه التمارين، كان يكفي لإسقاط حكومة الحريري في مطلع العام 2011 أن يسري خبر انتشار رجال بقمصان سود في عتمة الفجر على مفترقات الطرق في قلب بيروت لوقت لا يتعدّى 40 دقيقة، لكي ينتشر الرعب في المدينة، وخصوصاً أن الصحافيين فشلوا في التقاط أيّ صورة لأشباح بقمصان سود. سقطت قلوب اللبنانيين ومعها حكومتهم خوفاً ورعباً متخيلاً يفوق في قوته رعب الصورة الواقعية. فالخيال دائماً أقوى من الواقع وأعنف. وتربّع الرئيس ميقاتي على حكومة أتى بها أصحاب القمصان السود. بعد عامين تقريباً، كانت تكفي قراءة خبر انتشارهم أسفل الشاشة في شريط الأخبار كي يشعر زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي بالخوف ويغيّر وليد جنبلاط انتماءه من فريق 14 آذار الى فريق 8 آذار جاعلاً من هذا الفريق أكثرية نيابية! وتسقط بتداعيات ذلك، حكومة القمصان السود نفسها، التي فشلت في تحقيق أيٍّ من ادعاءات أصحابها ومزايداتهم.
فليعرّفنا أحد إلى معنى الارهاب!
خطف “حزب الله” الجنديين الاسرائيليين عبر الخط الأزرق، الساكن الراكد منذ الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000، وقتل عدداً من الجنود، مُدخِلاً لبنان في حرب مدمرة لا يزال يدفع أثمانها حتى الآن انقساماً وتشرذماً وتدهوراً على جميع الصعد، بعدما كان أمينه العام قد وعد بعدم القيام بأي خطوة تجاه اسرائيل منفرداً. خرج من الحرب ساخطاً ومخوّناً الجميع ومحوّلاً سلاحه، الذي تباهى بتحرير الجنوب بواسطته، الى الداخل “المُحرّر”.
بعد إسقاط حكومة الحريري والإتيان بحكومة موالية عند “تغيير” نتيجة الانتخابات وتحويل الأقلية الى أكثرية، دخل “حزب الله”، ربما مرغماً، وبأوامر عليا من المرشد الأعلى، الى جانب بشار الاسد، لقتال السوريين المطالبين بإصلاحات داخلية. فبدأت مرحلة جديدة من الرعب والتورط الدموي.
أما الآن، فيعيش لبنان في دوامة من الأزمات المتلاحقة عبر محاولات جرّه الى التورط في حرب إيران و”حزب الله” في سوريا. ترك الحزب جبهة الجنوب وتوجّه شرقاً، عابراً حدود سوريا في طريقه الى فلسطين! كان سبق لأبي أياد أن أعلن أن طريق القدس تمرّ في جونية، تماماً كما يحاول السيد نصرالله في خطبه إقناعنا بأن طريق القدس تمر في قتال السوريين دفاعاً عن نظام الأسد المقاوم الأول لإسرائيل،… عبر حفظه السلام والأمن، هو ووالده، على جبهة الجولان، لأكثر من أربعين عاماً!
تبدو الطريق الى القدس نزهة طويلة متعرجة عبر متاهات متعددة تقطعها طهران، التي تجرّ “حزب الله” في أذيالها، من عاصمة عربية الى أخرى (أربع عواصم حتى الآن). فما أبعد القدس!
وإلى أن يحدث أمر جلل ينبّه طهران الى خطل مسيرتها وزيف اعتقادها ان حدودها “أبعد بكثير من الحدود على الارض”، على حد زعم قائد عسكري ايراني في 29 أيلول الماضي، ويجبرها على الانسحاب الى داخل حدودها، أو أن تنوجد ظروف ترى فيها أن مصلحتها تقتضي انتخاب رئيس، سيظل لبنان مخطوفاً كرهينة وفاقداً حريته وسيادته ومحتلاً من طهران عبر أزلامها الذين لا يدينون بولائهم للدولة اللبنانية بل للدولة الإيرانية التي تشهر سيف مصالحها عدواناً مستمراً على العالم العربي. سيظل لبنان على حاله من دون رئيس للجمهورية ولا انتخابات، بلداً موقوفاً رهن الاستعمال لمصلحة إيران ولمصلحة حليف ممانعتها المتخاذل، قاتل شعبه.
كيف يمكن أن نوصّف ذلك؟ “حزب الله” لا يمثّل الطائفة الشيعية. “حزب الله” استولى على الطائفة الشيعية بفضل المال والسلاح والعصبية المذهبية التي عمل على تغذيتها بتأمين المصالح للبعض وبالبروباغندا وغيرها. “حزب الله” لديه جيش يفوق قدرة الكثير من جيوش المنطقة والعالم. “حزب الله” خارج الدولة، ويتصرف بمعزل عنها. جيش “حزب الله” يأتمر، متفاخراً، بأوامر رجل الدين الإيراني ومرشد ثورتها ودولتها خامنئي، مخضعاً لبنان واللبنانيين، شاؤوا أم أبوا، لإرادة بلد أجنبي.
مرّةً أخرى كيف نوصّف ذلك؟ وماذا ينتج من هذا التوصيف؟ وهل نحن بلد حرّ أم بلدٌ تحرّر حقاً؟
في كتابه، “الديموقراطية في أميركا”، لفت توكفيل، وأثار إعجابه، الشعور بحبّ الوطن لدى الأميركيين؛ ففي الولايات المتحدة، الوطن حاضر في المشاعر والأذهان أينما حللت. إنه موضوع اهتمام الناس، بدءا بالبلدة وانتهاء بالاتحاد كلّه. يتشبث المواطن بمصالح بلده، كما يتشبث بمصالحه الخاصة، وينهل من مجد وطنه مجداً ويفاخر بكل فوز له، لشعوره بأن فوزه صنيع يديه فيزداد زهواً. يغتبط للرخاء العميم الذي يحظى منه بنصيب. شعوره تجاه وطنه مماثل لما يشعره تجاه أسرته. حتى تطلّعه الى الذود عن مصالح بلده واندفاعه في هذا السبيل، إنما ينطوي على شكل من أشكال الأنانية، والتورط الشخصي.
حبّ الوطن، يبادر به الشعراء والروائيون والكتّاب الذين يساهمون في خلق أساطير مؤسسة. حبّ الوطن تتم تنميته بواسطة التربية والمناهج المدرسية المسؤولة عنها الدولة وحدها وليس الطوائف ولا الأديان.
“ما هو الوطن؟”، عنوان كتيب لأرنست رينان (1882)، يكتب فيه، أن الأوطان شيء جديد في التاريخ. عرف في القديم ما نسميه الآن ربما دولاً أو حضارات أو كيانات: مصر، الصين، أو الأمبراطورية الكلدانية. وهي لم تكن أوطانا. كان سكانها قطعاناً مسوقين من ابن الشمس أو الأمبراطور. لم يكن هناك مواطنون مصريون ولا صينيون. الأمبراطورية الرومانية كانت أقرب الى الوطن، لكن اتساعها الهائل منع جعلها وطناً.
توصلت كل من فرنسا، المانيا، انكلترا، وإيطاليا، بطرق ملتوية وعبر مغامرات عدة لكل منها، لأن تصبح وطناً حقيقيا كما نعرفها. فما الذي يميزها في الواقع ليجعل منها أوطاناً؟
إنه اندماج السكان الذين يشكلونها. في البلدان التي ذُكرت، لا شيء فيها يشبه ما وجد في السلطنة العثمانية، حيث الأتراك واليونان والأرمن والعرب والأكراد يتميزون اليوم مثلما كانوا إبان وجودها.
الانسان ليس أسير عرقه ولا لغته ولا دينه ولا مجرى نهر أو اتجاه سلسلة جبال. الوطن تجمّع كبير من البشر، سليمو الفكر ودافئو القلب، يخلقون وعياً أخلاقياً يسمّى وطناً. وطالما أن الوعي الأخلاقي يثبت قوته عبر التضحيات التي يتطلبها تنازل الفرد لمصلحة الجماعة، فهو شرعي. وله حق الوجود. واذا ما حصل نزاع حول الحدود، تُسأل الشعوب المتنازعة.
الوطن هو روح ومبدأ فكري. شيئان يؤلفان شيئاً واحداً في الواقع هو روح هذا المبدأ الفكري. أحدهما في الماضي والآخر في الحاضر. أحدهما هو امتلاك تراث مشترك وغني من الذكريات؛ والآخر هو التوافق الراهن والرغبة في العيش المشترك، وإرادة الاستمرار في اعتبار هذا التراث الموروث غير قابل للاقتسام. الانسان لا يصنع نفسه. الوطن كالفرد، هو نتاج ماضٍ طويل وجهود وتضحيات وتفانٍ. الإخلاص للأجداد شرعي تماماً؛ فالأجداد هم الذين جعلونا ما نحن عليه. إن الماضي البطولي للرجال الكبار، والمجد، هما الرأسمال الاجتماعي الذي ترتكز عليه الفكرة الوطنية.
امتلاك أمجاد مشتركة في الماضي وإرادة مشتركة في الحاضر؛ انجاز أعمال كبيرة معاً، والرغبة بإنجاز غيرها أيضاً؛ هذه هي الشروط الأساسية لكي نكون شعباً.
نحن في لبنان شعب منقسم. من هنا، تتعلق الأسئلة التي علينا مواجهتها، بالأخطار التي يمكن أن توصلنا اليها الممارسات الراهنة:
– اذا كانت الهوية الوطنية هي الشعور بالانتماء الكلي لكيان جامع يقوم على التماسك الاجتماعي، يصبح ممكناً اعتبار الوضعية الحالية مهدِّدة (بكسر الهاء) للوطن ووجوده.
– إن استمرار مظاهر الانقسام وعوامل استجلاب الثقافات المستوردة والطارئة التي تريد فصل بعض الفئات عن المجموع الوطني، تصبح مهدِّدة (بكسر الهاء) هي أيضاً.
– لم يكن غيدنز في تعريفه يتصور وجود وطن خارج إطار الدولة. إن وضع سيادة الدولة موضع تساؤل يهدد الهوية الوطنية القائمة في الأصل على المواطنية.
لحماية لبنان والمحافظة عليه، لا تكفي أي اصلاحات دستورية ولا التطبيق الأفضل لاتفاق الطائف. المحافظة على لبنان تكون باستعادة السيادة والاستقلال التامين وباحتكار الدولة وحدها لاستخدام العنف. أي لا سلاح غير سلاح الدولة الشرعي. وإلا فلا أمل في وقف الانهيار.