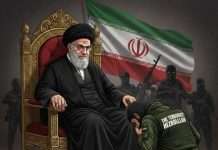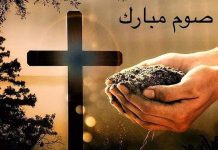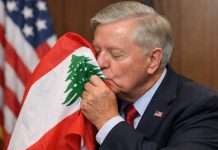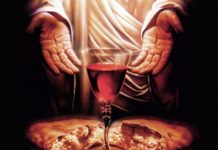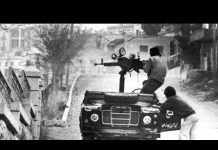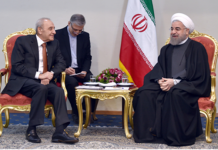آن الأوان لتحرير سيرة كربلاء من العقل الانتحاريّ؟
نديم قطيش/أساس ميديا/11 آب/2025
عندما يقول النائب محمد رعد إنّ قرار الحكومة حصر السلاح قبل نهاية العام، “فتح لنا طريق كربلاء”، فهو يستدعي رمزاً عميقاً في الوجدان الشيعي، أُعيد توليفه، بعد الثورة الإيرانية، عبر الشعار الخميني “إنتصار الدم على السيف”، ليجعل من التضحية القصوى والمظلوميّة التاريخية برهاناً على نصر إلهي حاسم، حتى لو كانت النتيجة في الواقع هزيمة ميدانية كاملة.
ليس خافياً أنّ الحسين بن عليّ خرج من مكّة متوجّهاً إلى الكوفة مدفوعاً بمشروع سياسي واضح، يهدف الى إسقاط شرعية يزيد بن معاوية ومنع تثبيت الحكم الوراثي في الدولة الأمويّة، مراهناً على تعبئة أهل الكوفة وإستنفارهم معه. بيد أنّ قوّة الدولة آنذاك وخدلان أنصار الحسين له أجهضا هذا الرهان، لينتهي الأمر بمواجهة غير متكافئة، قضت على القيادة السياسية والميدانية لجماعته، وثبّتت حكم يزيد في لحظة مفصلية من تاريخ الدولة الإسلامية، ودفعت الجماعة العلويّة، أي أنصار علي بن أبي طالب الذين يشكّل جزء كبير منهم قاعدة الحسين، إلى موقع الأقليّة المعزولة سياسيّاً.
لا يكتفي النائب رعد بدعوة اللبنانيين، لا أنصاره وحسب، الى تكرار هزيمة مكتملة الأركان مثل هذه، بل يتعمّد، كما جرت العادة، في تزوير السيرة الحسينيّة، تغيّيب أهمّ ما في سلوك قائد كربلاء نفسه. فالحسين بن علي، في لحظة الحقيقة، لم يكن انتحاريّاً ولا مفرّطاً بأرواح أصحابه، بل دعاهم إلى الانسحاب لئلّا يدفعوا الثمن الذي قرّر هو أن يدفعه.
في هذا السياق يشير الباحث حسن المصطفى، الى أنّ الحسين، في ليلة العاشر من شهر محرّم، حين أدرك أنّ المعركة خاسرة وأنّ الكوفة لن تنهض، جمع أصحابه وخطب فيهم:
“أمّا بعد، فإنّي لا أعلمُ أصحاباً أولى ولا خيراً من أصحابي ولا أهل بيت أبرَّ ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكُم الله عنّي جميعاً خيراً. (…) إنّي قد أذنتُ لكم، فانطلقوا جميعاً في حلٍ ليس عليكم حَرجٌ منّي ولا ذمام، هذا الّليلُ قد غشيكم فاتّخذوه جَمَلاً، وليأخُذ كلُ رجلٍ منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرّقوا في سَوادِكم ومدائنكم حتّى يُفرجَ الله، فإنَّ القومَ إنما يطلبونني ولو قد أصابوني لَهوا عن طلب غيري”.
حقائق جوهريّة
يكشف هذا النصّ، حقائق جوهريّة ثلاث:
1- وعي الإمام الحسين بالهزيمة الوشيكة، دفعه إلى أنّ لا يبالغ في تقدير فرصه، وإن كان مدركاً، بسبب فهمه لشخصية يزيد بن معاوية، أنّ الصدام حاصل ولا رجعة فيه. هذا المعنى الحقيقي لشعار “هيهات منا الذلّة”. ولو قيّض للحسين خيار تسوية سياسية لأخذه بلا تردّد.
2- رفضه التضحية العشوائيّة، كما تُثبت دعوته لأصحابه بالانسحاب، ورفعه عنهم أيّ التزام شخصيّ لقراره.
3- إستعداده، لأسبابه الخاصّة والعامّة، أن يتحمّل المسؤوليّة منفرداً، وأن يحيِّد مرافقيه عن سداد الثمن الدمويّ الذي تيقن من دنوّه، محاولاً حصر المواجهة بينه وبين السلطة التي كان يرى فيها، خطراً على الدين والعقيدة.
تنسف هذه الثلاثية التي يختصرها موقف الحسين، استسهال “التضحية الكربلائيّة” كما تروّج له سيناريوهات التعبئة المعاصرة التي يتبنّاها “الحزب”، والتي تكاد تجعل من “الانتحار الجماعي” فضيلة قائمة بحد ذاتها.
يكشف هذا السياق أنّ ما جرى للسرديّة الكربلائية هو إعادة ترميز للهزيمة، أيّ تحويل الفشل الميداني إلى رأس مال رمزيّ ضخم، عبر إحياء درامي سنوي للطقس العاشورائيّ جعل من المأساة والمظلوميّة ركنيْن من أركان الهويّة الجمعيّة لـ”أمّة الحزب”، وأعاد تعريف البطولة بأنّها الثبات حتى الموت بصرف النظر عن أيّ مكاسب عمليّة أو انتصارات واقعيّة.
ّالتّوظيف الإيراني
وظّف الخميني هذه السرديّة لتحقيق هدفين استراتيجييّن متلازميّن:
1- ترسيخ “الثبات حتّى الموت” كبديل للنصر الميداني في مواجهة نتائج غير مضمونة، وتحويل الصمود إلى انتصار رمزيّ يبرّر استمرار الصراع مهما طال أو ارتفع ثمنه. وقد كان هذا المعنى حاضراً في الصراع مع الشاه قبل 1979 كرمز للمظلوميّة السياسيّة والحشد الشعبي، لكنّه بلغ ذروته في الحرب مع صدّام حسين، حين تحوّلت كربلاء إلى عقيدة بقاء تبرّر إطالة الحرب ست سنوات بعد استعادة الأراضي، وجعلت المواجهة نسخة معاصرة لـ”معسكر يزيد” في مواجهة “معسكر الحسين”.
2- بناء هويّة جمعيّة عابرة للحدود، لتكون منصّة سنوية لتجديد الولاء لمشروع “تصدير الثورة” وتوحيد جمهور شيعيّ متنوّع من الخليج إلى المتوسّط تحت راية “أمّة الحزب”.
مأساة مضمونة النتائج
عليه، فإنّ توظيف كربلاء، في هذه اللحظة الوطنية في لبنان، وبالشكل الذي عبّر عنه النائب رعد، هو دعوة لتحويل حاضر اللبنانين الى مأساة مضمونة النتائج، وأن يقبل الناس أنّ مآسيهم ليست سوى أثمان هامشيّة لـ”وقفة العزّ” و”ملحمة الصمود”، تماماً كما أعيدت صياغة كربلاء بنسختها المعاصرة.
يخدع هذا الخطاب، أوّل من يخدع، الطائفة الشيعية في لبنان. فلم يتجاوز معسكر الحسين نتائج كربلاء، التي يدعوهم محمد رعد إلى سلوك طريقها، إلّا جزئيّاً، وبعد نحو سبعين عاماً، مع الثورة العباسيّة، التي ما كانت بقيادة أنصار عليّ ولا حملت أجندة الحسين نفسها. فالعباسيّون، أيّ أبناء العبّاس عمّ النبي محمّد، قادوا حراكاً سياسياً واسعاً ومشروعاً سلطويّاً إستحضر مأساة كربلاء والمظلوميّة الحسينيّة كأداة تعبئة، لكن بمجرد أن استقرّ لهم الحكم، همّشوا آل الحسين وأقصوهم، بل لاحقوهم وقتلوا بعضهم.
ّيعني هذا، أنّ كربلاء لم تكن حتّّى بذرة انتصار مؤجل، يدارى بالصبر والثبات، بل مأساة طويلة الأمد، استغرق تجاوزها الجزئي الطفيف جيلين كاملين على الأقل.
بصرف النظر عن معاني النبل التي تنطوي عليها السيرة الكربلائيّة، فإنّها في جوهرها، لا تصلح قطّ لأن تكون نموذجاً للعمل السياسي الرشيد أو للإستراتيجيات العسكرية.
استدعاء هذه المأساة في الأزمات المعاصرة، ينتحل صفة تخليد التضحية المشرّفة، لكنه في الواقع ليس سوى استراتيجية واعية لتبرير مُسبق للفشل، بعد أن تبيّن أن لا مفرّ من تسليم السلاح، وقناعٌ تاريخي يُلَفُّ حول الهزائم المُتتالية.
لا يقود هذا الاستدعاء جمهور “الحزب” نحو النصر، بل يُخدِّره بخطاب العزاء، ويُعلِّمه كيف يتقبل الهزيمة كقَدَرٍ، ويُزينها كبُطولة.