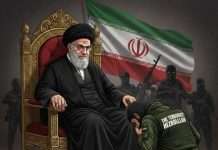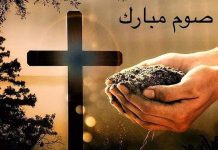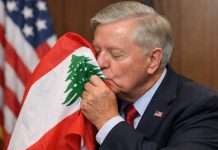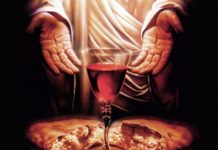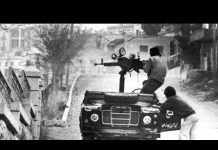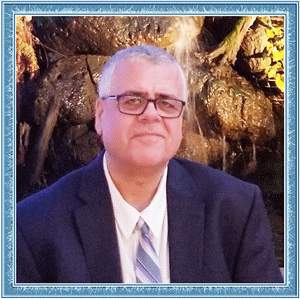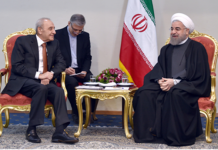Home تعليقات ومقالات مميزة ادمون الشدياق/العبودية المختارة، العصيان المدني، والحركات التحررية اللبنانية: تحليل فلسفي-سياسي في ضوء...
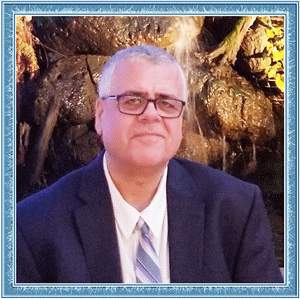
العبودية المختارة، العصيان المدني، والحركات التحررية اللبنانية: تحليل فلسفي-سياسي في ضوء لا بويسي وثورو
ادمون الشدياق/فايسبوك/07 آب/2025
منذ أن صاغ إتيان دو لا بويسي مفهوم “العبودية المختارة” في خطابه الشهير سنة 1574، أصبح هذا المفهوم حجر الأساس في فهم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لا كعلاقة قسرية محضة، بل كنوع من التواطؤ الطوعي على استمرار منظومات الاستبداد. وقد جاء هنري ديفيد ثورو في منتصف القرن التاسع عشر ليُحوِّل هذه الفكرة إلى منهج عملي من خلال مفهوم “العصيان المدني” كوسيلة لمواجهة السلطة الجائرة عبر اللاطاعة الواعية. بين هذين القطبين، لا بويسي في التأصيل الفلسفي وثورو في التطبيق الميداني، تقف التجربة اللبنانية كحالة نموذجية لمعركة دائمة بين الخضوع الإرادي لمنظومة استبدادية مركّبة، ومحاولات التحرر من قيودها عبر حركات عصيان مدني متكررة.
العبودية المختارة: النظرية والواقع اللبناني
يؤكد لا بويسي في خطابه أن الطغيان لا يمكن أن يستمر إلا بقبول الطاعة من قبل الرعية. إذ لا يملك الطاغية من القوة الذاتية ما يكفي لإخضاع الناس كلها، لولا أن الناس أنفسهم يسلّمونه مفاتيح سلطتهم. في السياق اللبناني، يتجلّى هذا المفهوم بوضوح في المنظومة الطائفية التي تحوّلت إلى نظام عبودية طوعية جماعية. فالمواطن اللبناني، وإن كان يشكو من الطائفية، غالبًا ما يستمر في تكريسها من خلال ولاءاته السياسية-المذهبية، وتبعيته للزعيم الطائفي كمرجعية أولى، حتى حينما يكون ذلك على حساب مصلحته كمواطن في دولة.
المنظومة اللبنانية ليست فقط نظام محاصصة طائفية فُرض بالقوة، بل هو نظام توافق عليه جزء واسع من اللبنانيين، في نمط من “العبودية المختارة” التي تجعل الفرد رهينة طائفته، لا بسبب القهر العسكري، بل بفعل ثقافة التبعية ذاتها [1].
ثورو والعصيان المدني: اللاطاعة كفعل تحرر
في مقاله الشهير “العصيان المدني” (1849)، دعا ثورو الأفراد إلى ممارسة اللاطاعة حينما تتعارض قوانين الدولة مع العدالة الأخلاقية. فالقانون، في فلسفة ثورو، ليس مقدسًا بذاته، بل يكتسب شرعيته من عدالته. حينما يصبح القانون أداة لاستدامة الظلم، يصبح واجبًا أخلاقيًا على الفرد أن يعصي.
في الحالة اللبنانية، يجد هذا المبدأ تعبيره الأوضح في أشكال العصيان المدني التي برزت في محطات مختلفة: من الثورة الوجودية التي أطلقها الشيخ بشير الجميل في السبعينات الى مقاطعة الانتخابات الصورية، وصولاً إلى الى الانتفاضات الشعبية الكبرى التي كسرت جدار الخوف الطائفي والسياسي [2].
من بشير الجميّل إلى 17 تشرين – العصيان اللبناني ضد الاستتباع والعبودية الطائفية
إذا كانت فلسفة إتيان دو لا بويسي حول “العبودية المختارة” تركّز على إرادة الشعب في رفض الطاعة، فإن التجربة اللبنانية في نهايات القرن العشرين وبدايات الحادي والعشرين شهدت محطات بارزة جسّدت هذا الرفض بتمردات سيادية كبرى. بشير الجميّل (1976-1982) يُعدّ من أبرز رموز هذا العصيان اللبناني ضد الاستتباع للخارج، وضد نظام الاستعباد الطائفي الذي تمّ فرضه على لبنان من خلال تحالفات داخلية وخارجية أنتجت واقعًا استسلاميًا أشبه بـ”العبودية الطوعية” التي تحدّث عنها لا بويسي [3].
بشير الجميّل: ثورة فردية في وجه الاستتباع
في سياق الحرب اللبنانية، لم يكن ترشح بشير الجميّل لرئاسة الجمهورية سنة 1982 مجرّد فعل سياسي عابر، بل كان تمردًا علنيًا على منطق الهيمنة السورية-الإقليمية، التي فرضت وصايتها على القرار اللبناني بحجّة “التوازن الطائفي” و”حماية السلم الأهلي”. الجميّل، في خطابه السياسي، واجه ثقافة الخضوع هذه، ورفع شعار “لبنان أولًا” كتمرد سيادي على منطق التبعية، وكمحاولة لإعادة الاعتبار لفكرة الدولة اللبنانية المستقلة السيدة [4].
ترشحه للرئاسة كان بحد ذاته فعل عصيان مدني سياسي – فالرجل لم يأت من صلب النظام الطائفي التقليدي القابل بالمحاصصة والوصايات، بل جاء ليواجهه من الداخل، عبر منصة الرئاسة، ليقلب قواعد اللعبة. بشير دعا اللبنانيين إلى “عدم انتظار الخارج” و”عدم تحميل سواهم مسؤولية مصيرهم”، وهو بذلك كان يكرّس عمليًا الفكرة التي طرحها دو لا بويسي: الطاغية يسقط حينما يكف الناس عن خدمته [5]. وفي مواجهته للهيمنة السورية، وللخضوع السياسي الداخلي، كان بشير يُمارس شكلاً من العصيان المدني الجماعي، قوامه رفض النظام الاستتباعي القائم.
رغم اغتياله بعد انتخابه، بقي إرثه كمثال عن ثورة فردية ضد العبودية المختارة التي ارتضاها جزء من النظام اللبناني، وهو ما جعل من تجربته رمزًا للسيادة الفردية والجماعية في مواجهة قوى القهر [6].
ثورة الأرز 2005: إسقاط الوصاية عبر العصيان الشعبي
بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005، انفجر الشارع اللبناني في واحدة من أوسع الانتفاضات الشعبية السلمية، التي عُرفت بـ”ثورة الأرز”. كان هذا الحراك الشعبي تجسيدًا عمليًا لمبدأ العصيان المدني على وصاية النظام السوري – ليس فقط من خلال المظاهرات، بل عبر مقاطعة الانتخابات الصورية، والاعتصامات السلمية، والتحرك القانوني والدولي لاستعادة السيادة [7].
اللبنانيون في ثورة الأرز مارسوا العصيان بالامتناع عن المشاركة في خطاب الخضوع، برفضهم الخنوع الثقافي والسياسي، وبمطالبتهم بانسحاب الجيش السوري من لبنان. لم يكن السلاح هو وسيلتهم، بل سحب الشرعية الشعبية عن السلطة الجائرة، وفقًا لمنطق لا بويسي الذي يقول: حينما يكفّ الناس عن خدمة الطاغية، يسقط من تلقاء نفسه [8].
ثورة الأرز إذًا كانت امتدادًا لروح تمرد بشير الجميّل، لكنها ارتقت بها إلى مستوى الحراك الجماهيري اللاعنفي، المتعدد الطوائف، الذي اعتمد على العصيان الجماعي كأداة لإسقاط الاستتباع.
17 تشرين 2019: الثورة ضد العبودية الطائفية والاقتصادية
لقد بلغت حالة العبودية المختارة في لبنان ذروتها مع تفكك مؤسسات الدولة أمام هيمنة حزب الله، الذي تحوّل إلى الذراع الإيرانية القابضة على مفاصل القرار اللبناني. فقد تنازلت الأحزاب السياسية كافة عن دورها السيادي، وارتضت بدور التابع أو المتواطئ، إمّا خوفًا وإمّا حفاظًا على مصالحها الخاصة ضمن نظام الغنائم. بهذا التواطؤ، تُرك حزب الله يقتنص الدولة تدريجيًا، مُحكماً قبضته الأمنية والسياسية، حتى أصبحت الجمهورية اللبنانية في حالة انهيار شبه كامل. المواطن اللبناني، وسط هذا المشهد، يعيش خضوعًا مزدوجًا: خضوعًا لهيمنة خارجية تمثلها إيران عبر حزب الله، وخضوعًا داخليًا لمنظومة حزبية متواطئة وعاجزة عن المواجهة.
أمام هذا الواقع، لم يعد القهر خارجيًا فقط، بل بات يُمارس عبر موظفين حزبيين وقيادات محلية تمارس استعباد المواطن من خلال شبكات الزبائنية والفساد، مغلقة الأفق أمام أي فعل مقاوم حقيقي. فالأحزاب التي كان من المفترض أن تدافع عن سيادة الدولة، إما تواطأت مع حزب الله، أو رضخت له تحت شعار الواقعية السياسية، مما جعل من المواطن اللبناني رهينة لمنظومة استعباد داخلي وخارجي في آن واحد.
انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 جاءت في سياق انهيار اقتصادي واجتماعي كامل، ولكنها لم تكن فقط انتفاضة على الأوضاع المعيشية، بل كانت ثورة على نظام الطاعة الطائفية، والذهنية الاستعبادية التي تجعل من الزعيم الطائفي “قدرًا” لا يمكن كسره [9].
في 17 تشرين، كان العصيان المدني هو السلاح: إضرابات عامة، قطع طرقات، مقاطعة مؤسسات الدولة، محاكمات شعبية لرموز السلطة في الساحات، وكسر هيمنة الإعلام الحزبي عبر منصات رقمية حرة. كل هذه الأشكال كانت تعبيرًا عن العصيان المدني بالمعنى الذي أراده ثورو: انسحاب أخلاقي وسياسي من دعم منظومة فاسدة وظالمة [10].
لكن الأهم و بالرغم من انها تهاوت من الداخل ولم تؤدي الى تحرير لبنان واللبنانيين ، إلا أن هذه الانتفاضة كسرت واحدة من أعقد أشكال العبودية المختارة في لبنان: الولاء الطائفي. فقد تجاوز المتظاهرون انقساماتهم التقليدية، ورفضوا الدفاع عن زعمائهم التاريخيين، وهو ما اعتُبر بداية تحرر من نظام العبودية الطائفية الذي تكرّس لعقود.
من بشير الجميّل إلى ثورة الأرز وانتفاضة 17 تشرين، يتجلى مفهوم العبودية المختارة في البنية العميقة للنظام اللبناني، كما يتجلى في المقابل العصيان المدني كفعل تحرري أخلاقي وسياسي. كان كل تحرك لبناني في وجه الوصاية أو الطائفية أو الفساد، شكلًا من أشكال كسر الطاعة العمياء، وتمردًا على واقع الاستتباع الذي قبل به جزء من المجتمع.
إذا كان لا بويسي قد دعا الناس إلى الكفّ عن خدمة الطغاة، وثورو قد طبّق ذلك عبر العصيان الفردي، فإن اللبنانيين، في محطات تاريخية مفصلية، مارسوا هذا الرفض عمليًا، مؤكدين أن الحرية ليست مجرّد حق، بل مسؤولية، تبدأ بقرار الفرد في أن يقول “لا”.
لكن السؤال يبقى: هل يمكن أن ينتفض اللبنانيون مرة أخرى الآن بعصيان مدني وكسر قيود عبوديتهم الطوعية، بثورة حقيقية فاعلة مؤثرة قد تحرر لبنان؟
إن التحرر الوطني لا يتحقق عبر انتظار الخارج ولا بمهادنة منظومات القهر الداخلية، بل يبدأ بقرار فردي واعٍ بالامتناع عن خدمة الطغاة، ورفض الطاعة العمياء لكل سلطة تمارس الاستبداد باسم الطائفة أو الأمن أو الاقتصاد. وفي مقدمة هذه المنظومات، يقف حزب الله كأداة إيرانية تخنق الدولة اللبنانية، وتحكم قبضتها على مؤسساتها الشرعية، محوّلاً الدولة إلى كيان تابع، فاقد للسيادة وللإرادة الوطنية.
إن العصيان المدني لم يعد خيارًا نظريًا، بل أصبح ضرورة وجودية للبنان كدولة، وللبناني كإنسان حر. كل لبناني مدعو اليوم إلى إسقاط نظام العبودية المختارة بالانسحاب من لعبة التبعية، وخلق فعل جماعي واعٍ عنوانه: لا طاعة لمن يستعبدنا باسم الطائفة أو المال أو السلاح. استعادة السيادة لم تعد ممكنة إلا من خلال عصيان مدني ثوري شامل، يحرر إرادة اللبنانيين من نير حزب الله ومن دولة تابعة لمشروعه الإيراني.
إنها ليست دعوة إلى الفوضى، بل إلى الثورة الأخلاقية عبر اللاطاعة، كما أرادها لا بويسي وثورو، وكما تفرضها مسؤولية الحفاظ على وطن حر وسيد ومستقل.
الهوامش:
[1] Étienne de La Boétie, “Discours de la servitude volontaire”, 1574.
[2] Henry David Thoreau, “Civil Disobedience”, 1849.
[3] Antoine Sfeir, “Liban, la guerre de trente ans”, 2005.
[4] Farid el-Khazen, “The Breakdown of the State in Lebanon”, Harvard University Press, 2000.
[5] La Boétie, op.cit.
[6] Sfeir, op.cit.
[7] Ussama Makdisi, “The Culture of Sectarianism”, University of California Press, 2000.
[8] Hannah Arendt, “On Violence”, Harcourt, 1970.
[9] Mohja Zreik, “Civil Resistance in Lebanon’s 2019 Uprising”, Journal of Middle Eastern Politics, 2020.
[10] Thoreau, op.cit.
المراجع:
La Boétie, Étienne de. “Discours de la servitude volontaire”, 1574.
Thoreau, Henry David. “Civil Disobedience”, 1849.
Arendt, Hannah. “On Violence”, Harcourt, 1970.
Foucault, Michel. “Discipline and Punish”, Pantheon Books, 1975.
Makdisi, Ussama. “The Culture of Sectarianism”, University of California Press, 2000.
Sfeir, Antoine. “Liban, la guerre de trente ans”, 2005.
Zreik, Mohja. “Civil Resistance in Lebanon’s 2019 Uprising”, Journal of Middle Eastern Politics, 2020.
Farid el-Khazen. “The Breakdown of the State in Lebanon”, Harvard University Press, 2000.