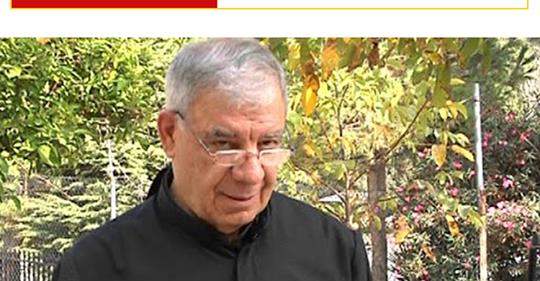السياسة والدين
الأب سيمون عساف/فايسبوك/11 شباط/2022
أ-الموازنة بين السياسة والدين
ليست الكنيسة المارونية فى لبنان على ملتقى حضارات وثقافات متعددة فقط ؛ بل هى ايضا فى صميم اهم المسائل المطروحة على المسيحية المعاصرة؛ وبخاصة مسألة العلاقات مع الدنيوة ومع التعدد الدينى فى العالم. كذلك نرى انه لا يمكن التطرق لموضوع المارونية من دون الغوص فى مسألة العلاقة بين الدين والسياسة؛ وهى مسألة لازمت عمليا تاريخ المارونية التى حاولت ان تجد لها اجابة خاصة (تختلف عن اجابة الكنيسة الرومانية التى لم تجد بعد شكلها النهائى).
ان العلاقة بين النبوة ومجال السياسة هى ايضا مشكوك فيها وعلينا الاقرار بأنها مسألة صعبة كسائر المسائل المتعلقة بالتداخل بين الدين والسياسة. من الواضح بالطبع ان النبوة تستطيع وعليها احيانا ان تصطبغ بالسياسة. فالنبى إذ يرجع الى الاخر؛ هو ايضا من يعلن التحرر من الاستلاب على انواعه. إن تحليل دور النبوة فى تكوين الهوية السياسية المارونية يدخل فى مشكلة اوسع؛ ألا وهى مشكلة العلاقات العميقة بين السياسة والدين. حول هذة المشكلة تحديدا تتمحور طروحات مرسال غوشيه(3) وماكس فايبر(4) وريمون لوميو(5)؛ وهى تفتح أفاقا جديدة لتحليل النبوة وعلاقتها بحياة الموارنة الاجتماعية والسياسية.
أن نجمع بين جوهردين معيّن و”مصدر ممكنات” او مجموعة فرضيات؛ وأن نرى فى شكل التطور الذى يتخذه هذا الدين نتيجة تحول ليس بالضرورة محتما؛ يشكل ذلك بالنسبة إلينا إطارا تصوريا لا يخلو من الطرافة لاستكشاف المارونية فى منابعها الاساسية وفى مؤهلاتها المكونة؛ من غير ان ننحصر فى مقاربات موجزة توفق بين موضوع الدرس وفرضيتها المسبقة؛ ولا فى طرق إستقرائية تبالغ فى التركيز على جانب معين من الموضوع وتنتهى الى نتائج مغلوطة.ان التجربة مشروعة لأنها تسمح بألا نبقى مدينين لرؤية تعتبر الاحداث التاريخية كما حصلت والأطر التى تبلورت فيها؛ بمثابة إجابة على منطق وحيد للربط ؛وكنقطة ارتكازوحيدة ومرجع وحيد ينبغى أن يبنى عليها أى تحليل. بكلام اخر؛ يمكن ذلك من تفادى أى توفيق؛ بحسب مبدأ السببية؛ بين الفكرة والحدث. ليست الاخطار بقليلة؛ واهمها الانتقال من منطق مبنى على السببية الى اخر مبنى على الفرضية.
والقول مثلا بأنه لو لم تضمحل الامبراطورية الرومانية لما ظهرت الدنيوة فى الغرب .لا يمنع ذلك من اللجؤ عند الضرورة إلى ادوات البحث المتوفرة فى تلك الطرق والتى ربما تكون بالغة الفائدة :” إن اعتبار عنصر البنية فى مبدأ تاريخ الظاهرات الدينية؛ مع ما يقتضى من اختزال وتبسيط جذريين؛ لا يؤدى إلى إهمال الكثرة اللامتناهية للاحداث. إنة على العكس؛ يوسع لاحقا شبح وعدد الاحداث التى يمكن اغتبارها ذات معنى” (6)
قد تساعد مقاربة غوشيه على إعطاء إجابات سريعة على مثل تلك الأسئلة؛ إذإنها تمتاز بإدخالها إلى الديانات والمجتمعات إسهامات مجالات متعددة. لايمكن فهم الدين من خلال الوجه الذى يظهر فية ولا من خلال ما كان عليه ؛بل من خلال ما سيصبح. كتب جورج بالندييه:”تسهم جميع المؤسسات فى المحافظة على خداع الرؤية الاجتماعية. فهى تكتسب فى استمراريتها طابعا موضوعيا وتبدو مستقلة عن الاشخاص الذين انشأوها؛ وتفرض نفسها كما لم تكن إجابة؛ من بين اجابات اخرى ممكنة؛ على مشكلات يطرحها كل وجود جماعى.”
ب- قدرة الدين والسياسة
“إن الدين فى شكلة الاكثر نقاء والاكثر منهجية هو فى البدايةفى هذا العالم الذى يسبق الدولة”(7).فى امتدادة لعشرات الالآف من السنيين وفى عدم تبدل وظيفتة الاجتماعية؛كان الدين فى بداياتة الطويلة ضد السياسة بنوع خاص؛ بقدر ما تعنى تعديل المفاصل المكونة للبناء البشرى، على العكس؛ منذ خمسين قرنا من النمو التاريخى اومن السياسة المعادية للدين؛ يستمر الدين فى فقدان حيويته الجماعية لصالح دور محدد اصبح اكثر فاكثر خارج المجتمع فيما يتعلق بالدين؛ إن التطور الى زوال.
بغية فهم ما يدفع الى هذا التراجع يجب ان نعود الى “مصدر الخيارات”الكامن وراء الخيار الدينى. يستخدم غوشيه كثيراَ هذة العبارة للدلالة على استعدادت العمل عند الانسان الموجود دائماَ فى”ماهو حاصل” و”ما لم يحصل بعد”. ولكن ماهى هذة الخيارات؟ يحددها غوشيه بمفاهيم مؤمنة كالاتى:
“إماخيار أسبقية البشر ونشاطهم الخلاق؛ وإما الرضوخ لنظام مفروض كلياَ ومحدد مسبقاَ وخارج عن إرادتنا؛ وإما مسؤولية نظام نقر بصدوره عن ارادة أفراد عرفواَ بأنهم وجدوا قبل العلاقة التى تربطهم بعضهم ببعض”(😎
لا تعكس هذة الخيارات مطلقاَحريةَ شبيهة بتلك التى ننسبها لإله خالق الأساطير الدينية والذى يعبر عن الارادة والرغبة المطلقتين اللتين تخلقان من الفراغ وجوداَ يكون الأساس، وكما لا تعكس حرية اختيار عن شروط الاختبار البشرى؛ ولكنها تحدد أيضا حقيقة ذلك الاختبار من دون ردة الى سبب يقرر تفوقه.
فى هذة النقطة وفى منظور وجود تاريخى لا يتخطى العمل البشرى؛ يشكل فهم”الكائن فى العالم”و”الكائن معا”جوهر تحليل غوشيه للدينونة.لا يمكن للحركة إلا ان تكون دينية ؛ ليس لأن الدين عنصر مكون للطبيعة البشرية؛ بل لأنه يتحكم بتركيب”الكائن معا”. فال”الممكنات”تتجمع حول محور التنظيم الجماعى هذا وتحدد فى جوهرها بالنسبة إلية. غير انه فى المعنى اياه وبحسب المنطق اياه تتأكد تاريخية الدين وقدرته على التغيير:”الدين…تلك الطريقة التى تؤسس الانسان ضد ذاتة؛ أى حقيقة تنظيم الانسان بصفتها الاكثر تمييزاَ؛ ألا وهى وضع المواجهة لما هو موجود الذى يعذر عليه فى تكوينه أن يستوطنه ويتعود عليه. إنه وضع يدفعه بشكل لا يقاوم الى عدم القبول”
بالنسبة لغوشيه؛ ارى ان العمل البشرى الاجتماعى الذى هو نتيجة او( سبب) “الالتباس المكون لاختبار الزمن”لايؤسس التاريخ (منظور ماركس) ولا يعبر عنه (منظور هيغل)؛ انه امكانه ووجهته.لا يجعل غوشيه من هذا الاعتقاد إديو لوجية للتاريخ او للتغيير؛ بل إن تحليله يبدو كمقاربة ظواهرية للتطور الاجتماعى والدينى(9) إنه يحاول؛ خارج أى بنيان تصورى؛ أن يبرز المثولية التاريخية التى تولد الممكنات (وليس الممكن) والتى ندمج تكاثرها بممكنات جديدة إذا كانت”الممكنات” المادة التاريخية التى تتكون من جديد إلى مالانهاية؛ هل لا يكون”الاختيار”البشرى سوى ترابط العناصر المكونة لهذه المادة أو الآلية التى تتحكم بتركيبها.
هكذا يتحاشى غوشيه الانزلاق نحو أية فرضية دائرية لا تدل إلا الى ذاتها وتدعى اكتشاف الحقيقة المؤسسة سواء على الصعيد السوسيولوجى أو الصعيد السيكولوجى. إن “حقيقة” تتعلق بالعمل البشرى –وبالتالى بإمكانية غير خاضعة لأية حتمية كانت وفى الوقت عينه غير تعسفية وهى فى حالة بناء دائمة.
إن الدين الذى يؤسس والذى يبدل ايضاَ ؛ لم يكن يستطيع العمل إلا بعلاقة سلبية مع ذاته(10).غير ان ذلك لا يحدد ماهية الدين الصرفه التى تضع هذة الطاقة السلبية أثناء إنتاجها لها فى خدمة الثابت وتجديد القانون القائم “ان الماهية الاولية للظاهرة الدينية تكمن بكليتها فى ذلك الاستعداد المعاكس للتاريخ .إن الدين الصرف ينحصر فى تقسيم الأزمنة الذى يجعل الحاضر فى تبعية مطلقة للماضى المثيولوجى ويضمن الوفاء التام لمجمل النشاطات البشرية للحقيقة الأولية والذى يوقع؛ فى الوقت عينه؛ التنازل النهائى للبشر عما يعطى المادية والمعنى لأحداث وجودهم ومآثره.”
كيف نفسر اذا ذلك الحضور المشترك لقوة معاكسة للتاريخ ولقدرة على التغيير ملازمة لطبيعة الدين؟(11)لا يدّعي غوشيه حل هذه المشكلة ولكنه يعزوها إلى أسباب انثروبولوجية عميقة سابقة للدين ؛ أو بتعبير آخر؛ الى عملية خلق الانسان بالذات حيث يكمن سر “التآمر الأولى على الذات”. إن ما يدفع إلى الوجود أسباب عدم الابقاء فى الوجود”(12). إنه التعبير الأمثل ؛ سواء للمعنى الذى يعطيه غوشيه للدينامية التاريخية الدينية أو للبنية البرهانية الكتابية.
إزاء ما توحى به المظاهر وما تظهره تحاليل كثيرة ؛ يبنى غوشيه أن تقوية صورة اللة الكلى القدرة والكلى الاختلاف تتفق فى الواقع وتقليل مهمة الدين الاجتماعية المنظمة . لم يكن تعاظم الآلة على حساب الاستقلالية الاجتماعية بل فى صالحها. لو كان الدين الصرف –دين المتوحشين أو دين المجتمعات البدائية –دين التنازل التام ؛ لوجبت قراءة تاريخ الأديان وكأنه استعادة للملكية.
إن استعادة الملكية هذه لاتندرج فى عملية مشاركة وموجزة. إن الحدود الفاصلة بين”ماهو حاصل “و”الممكن”المحقق؛ تلك التى يقيمها المؤرخون وعلماء الاجتماع لتحديد مواضيع دراستهم ؛ غير موجودة فى الواقع التاريخى .يختلط التطور والتراجع بشكل وثيق ولا تزال “بقية” من الماضى المؤسس فاعلة باستمرار فى الواقع الجديد القائم. وهكذا فإننا نجد آثارأديان مشركة فى الدين التوحيدى اليهودى؛ وسمات أساسية لليهودية وللفلسفة اليونانية فى الديانة المسيحية؛ وأوجة شبه ظاهرة بين الايديولوجيات العلمانية للعالم الحديث وأنظمة الفكر اللاهوتية….إن الثورات التى يذكرها غوشيه (ظهور الدولة؛ تعالي اللة؛ قلب التدبير الدينى القديم للمجتمع ) ليست مطلقاَ قفزات تعسفية فى التاريخ-حتى لو لم يتم اكتشاف سر اندلاعها . كما وانها ليست نتائج تسلسل متمم يتحكم بتدبيرها الزمنى .”إنها جزء من حرية غريبة تعمل وسط الصيرورة ويكون الناس من خلالها أسياد أنفسهم بطريقة لا واعية ؛ وبخاصة يعون ذواتهم .إنها حرية غريبة بقدر ماهى إدارة الإرغام بامتياز؛ إنها هى التى تجعلنا ما نحن عليه . إذا كان هناك من غموض فى عمق التاريخ فهو فى مكان محدد ولا يمكن فهمه إلا من داخل اتحاده الوثيق مع ماهو محدد”(13)
هذه الحرية- هذا الاستعداد (الانثروبولوجى) ربما لقيام الإكراه- كيف ظهرت فى اختبار المقدس؟ وبالتالى فى اختبار ما يشكل التعبير الأولى للإكراه؟ كيف كان حقل التاسيس والإكراه هذا(حقل اختبار المقدس) حقل الإلغاء والتحويل فى آن وبشكل متلازم؟ ذلك ما يقدمه التاريخ السياسى للدين الذى وصفه غوشيه .نبدأ بظهور الدولة وهى “الزعزعة الكبيرة وربما الذبذبة الروحية الأهم فى التاريخ”(14) إن المجتمع الذى تتحقق فيه وحدة العالم من خلال اختبار واقع واحد؛ ويتعايش فيه الآلهة والبشر دونما تداخل أو تعد بين الطبعييتين؛ يحتوى فيه ظهور الدولة على ثلاثة عناصر للتغيير: الهيمنة والفتح والتسلسل . ويكون لظهور الله الحى (الوسيط) فى عالم البشر (الجماعة) فعل ضخ المقدس فى العلاقة بين البشر؛ أى فى المجال الاجتماعى .يؤدى ذلك إلى جعل القوى المقدسة شخصية؛ كما إلى مراجعة جذرية للمقترحات الإلهية (يصبح الوسيط أكبر وأقدر وأقدس؛ وتنتفى العودة الى الآلة من أجل الهيمنة – من خلال توتر قسرى مع باقى المجتمع، يخضع الوسيط هذا الآخر لقانونه)
إن اندماج غيرية المقدس فى جوهر الرابط الاجتماعى يضع حكماَ الجهد الاجتماعى من اجل الهوية فى قبضة السلطة . وما كان يؤمنه العمل الشعائرى وحده؛ يقوم به ايضا؛ بشكل اساسى ومكمل؛ الأسمى بين البشر. إن تجسيد الآخر أو تشخيصه يشكك فى عملية التعرف ويزيد ابتعاد المقدس كما ويوحى بغيابه. إن التقسيم الدينى الذى كان بين النظام البشرى والأساس فى مجتمع معاد للشخص؛ ينتقل الى ما بين البشر ويكرس “انفصالاَ “فيما بينهم .إن أول “الممكنات” الذى ينتج من هذا التغيير هو الانشقاق السياسى؛ إذ عندما يفرض الطغاة سلطتهم يجعلونها موضع نزاع لأنها تنتقل من سجل الوارد الى سجل المطلوب. مع مجئ التوحيد؛ يبدأ تغير البنية الانطولوجية عندما ينتقل الانقسام الدينى الى داخل البشر. إن تصور إله واحد لا يملكه العالم ويشكل واقعا مختلفاَ؛ يولد إمكان تحريك؛ أو بأقصى حد اكتشاف ذات أخرى . والآخر (المغذى الاساسى) لن يكون بعد من المسلمات بل نتيجة مسيرة داخلية تولد نوعاَ من الغرابة تجاه الذات؛ انشقاقا فى الكائن .هذه هى لعبة “الممكنات”عند غوشية: إما تخطى هذة الازدواجية بالنزعة الى وحدة العالم (لا شخصية الآخر الجذرية )وإما الإمعان فى تعميقها بفصل الموضوعية عن القدرة الشخصية (إزدواجية اللامتناهى وتشخيصه). فى كلا الحالتين؛ إن تغيير نهج التفكير هو فى اتجاه واحد. ويشكل التوحيد “الزمن- المحور” أو المنعطف المحورى لتاريخ الانسان السياسى. إن ضرورة تخطى مقتضيات التعددية للوصول الى الواحد والجهد الهادف الى فصل الشمولى عن الفردى؛ والمجرد عن المحسوس؛ يولدان ما يسمى بالفكر النظرى.
إن التفاوت بين مراتب الوجود يصبح انشقاقاَ داخل الواجب الوجود. ويصبح عيش الآخر غير ممكن من خلال الرتب الاجتماعية؛ إنما يصبح فى عملية الرضوخ والتماهى مع تصميم الآخر. وما إن يظهر كتصميم فريد؛ حتى تكثر إمكانات اكتشافه وتفسيره. من هنا الانفتاح الكبير الذى تسمح به تلك الازدواجية الموجودة فى ذاته : تعدد الخيارات لتأمين الهوية؛ من الفردية التقشفية الى الشمولية الجامعة. بالتالى فإن الطابع الأساسى للتوحيد هو تسجيل الهرطقة كإمكانية فى الارثو ذكسية بالذات .
ليست دينامية التسامى دينامية دينية وحسب. إنها ايضا وبشكل مترابط؛ سياسية. إن ما يدعم السلطة قد ينقلب ضدها بسبب استقلالية معتقد لاتنتهى حتى ولو كانت سريه .هنا تكمن قوة التغيير الملازمة للدين : بالنسبة لذاته وضد ذاته (عودة الدفق الذى يجب ايجاده ) وبالنسبة للسياسة (اذا كانت صلة الإكراه الجماعى بالواجبات تجاه المقدس ثابتة ودائمة فهى تبقى موضع شك لايمكن ضبطه لأنها تمر بالضرورة بالفرد نفسه) (15)
على عكس ألوهية الماضى التى كانت جزءاَ من العالم؛ فإن الألوهية المتعالية تمسك العالم. إنها المصدر والمسؤولة فى آن؛ توحد الاصلى والحالى؛ الماضى والحاضر(الخالق). إنهاوساعة الآلوهية الجديدة وانفصالها؛ وكذلك حضور غير مباشر مواز وخفى. لايعود المعنى مجرد شئ يعطى اويقبل؛ بل يصبح شيئاَ يجب تركيبه (الفصل بين الشخص والشئ)؛ ويؤدى تعمق الغيرية الخيالية الى خفض الغيرية والى تعزيز السريرة.
فى هذا المنظار؛ يصبح الانتقال من الواحد الانطولوجى الى الثنائية النهائية أساساَ لتغيير شروط المعرفة. ما إن يصبح تعالى الإله الشخص فى المقدمات؛ يصعب إيقاف تحوله إلى إله يدرك بواسطة العقل. بالتالي؛ يكون لتحول المطلق الإلهي ليس فقط دور محرك ومرآة لتطور العقل البشرى؛ بل دور الحاضر الأساسى لاستقلاليته. وهكذا يمكن القول إن الفكر المستقل؛ سواء كان موضوعه الله او العالم؛ يتمتع بجوهر زرعى فى التوحيد اليهودى؛ فى فكرة إله يعلو على اية قدرة إرضية وعلى أية سلطة وأى تجسيد ملموس. ولكن ظهور تلك الفكرة التوحيدية داخل شعب صغير هامشى؛ هل هو نتاج اختراع صرف؟ أو غموض تاريخى؟ يجيب غوشيه ويتكلم عن ازدواجية يبدو أنها مكونة: من جهة ؛احجية اصل غير محتمل؛ ومن جهة ثانية ضرورة داخلية بصفتها “تحول بنيانى نتيجة تدخل عنصري السيطرة والاحتلال “.
انتصرت الفكرة على اثر زعزعة غير مسبوقة للأمبراطوريات (الأنتشار الرومانى والفارسى واليونانى….).تحقق التحول الدينى وفرض نفسة حيث كان فى الذروة اختلاط المتغاير وإزاحة التطلعات البشرية عن مركزها. فى الواقع؛ ولد إله إسرائيل فى محيط ديانات امبراطورية مجاورة (ديانة ما بين النهرين؛ الديانة المصرية…) حيث كانت النزعة الى اختصار الآلهة والسيطرة الامبريالية القصوى ؛وبحثاَعن إله مخالف لآلهة القمع؛ يتبنى التوحيد اليهودى النزعات الى الوحدانية والفصل بالنسبة لله وهى موجودة داخل التنظيم الجماعى؛ ويقوم ببلورتها فى تعبير جذري(16).
إذ يفترض غوشيه أن مصدر التوحيد هو المواجهة بين الضعيف والقوى؛ يعطى الدوافع السياسية مرة ثانية ؛دوراَ مركزيا فى إعادة تحديد الإلهى. على العكس؛ وفى تحليلة للصياغة الجديدة للتوحيد فى المسيحية؛ يشير الى التطور الدينى الجوهري والى المستلزمات الداخلية المحضة للدين التى أوجدت التحول الثورى .هل يحد ذلك ميزة أساسية أخرى للمسيحية تقضى بإظهار إستقلالية المعتقد- اى النتيجة الكبرى لدينامية التعالي؟
“ليس الأعلى بل الوحيد؛ ليس فى سجل المقارنة بل فى سجل الحصري؛ لا يوجد فى عنصر الاستمرار بل فى عنصر الفصل؛ لا يمكن فهمه بعبارات التكامل مع عالم البشر بل بعبارات التناقض”(17).غير أن صورة الله تلك تفرض نتيجة هامة: وحدها إرادة يهوه قادرة على أن تكون فى أساس الشر الذى يصيب شعبه ؛ووحدها قادرة على إلغائه.من هنا:
(1)-ضرورة العودة الى الذات (“ماذا فعلنا لنستحق العقاب؟”) إن الأخلاقية التى كانت بكليتها إيجابية هى فى طريقها إلى أن تصبح بشكل أساسى إستفهامية وموضع شك.عندئذ .يبرز الفارق بين الوجود والواجب الوجود الذى يتحكم بتدبير الوحى ومعنى النبوة.
(2)-رجاء تدخل خلاصى يحمل معنى مزدوجاَ. من جهة؛ جديد فكرة الله ؛ ومن جهة ثانية؛ حضور التدبير الدينى القديم ومبدؤه الذى يحافظ على الواحد فى الاختبار الجديد لله من خلال العهد المقطوع بين الإله الجديد وشعبه. الجمع بين المنظور وغير المنظور؛ بين هذا العالم والعالم الآخر.
من خلال هذا العهد؛ يبقى الإله الواحد والمنفصل على علاقة وثيقة بهذا العالم. كيف نوفق بين الدعوة الجامعة لهذا الإله الذى تعده قدرتة الكلية ووحدتة لجميع البشر واختياره الحصري لإسرائيل من بين الأمم كافة؟ كيف ستنقطع تلك العلاقة التى كانت تجمع بين الواقعين المنفصلين؟ ربما يأتى يسوع ؛ إله الجميع ؛ بالإجابة ويساعد على الانتقال النهائي الى زمن القطيعة والثنائية النهائية؛ زمن التعالى الكامل واللاهوت. يسوع يحرر كما إله موسى.هو يعتق الناس من سيطرة القيصر وظلمه. إنما هناك فارق مهم:لا يقضى عمله التحريرى بأخذ المؤمنين إلى أرض ميعاد كائنة فى مكان ما من العالم؛ بل بإخراجهم كلياَ من العالم. لن ينتظر حضور الله قيام امبراطورية العالم الجديدة؛ إنه يظهر فى كل حين فى وجوب رفض العالم .” لم يعد الايمان فقط ما يشرع معارضة الجميع على نحو شعائري ؛ إنه يصبح هنا ما يبرر الشعور باللحمة الوثيقة مع العالم بكليته”. إن التعارض بين إله إسرائيل ويسوع جد كبير. ونذكر من اوجهه هنا ما يعتبره غوشيه عناصر تغيير فى البنية : قلب التراتبية بالكامل؛ قيام اللحمة بين الإنسانى والإلهى بعيداَعن السلطة وفى رجل عادي؛ يتم الارتقاء من منطق التعالى الى منطق الغيرية الذى يعمق لا بل ينجزفصل الوقائع؛ والذى يدمر أيضا صورة الملك المسيحانى الذى يدعو الى الحرب والى تجمع البشر كافة تحت حكم أوحد يجمع السماء والارض. إن فى دعوة يسوع الى الحب قوة تحرر الفرد من إرث الواجب الاجتماعى؛ من تضامن المجموعة والضريبة ؛من أولية ما هو جماعي .”الحب؛ فى الحقيقة؛ هو المسافة الداخلية بين الفرد واللحمة مع المجتمع؛ هو حل الرباط من الداخل مع الواجب الجماعى الأساسى”(18)
يخلق مجئ المسيحية شروطاَ جديدة لإمكانات التفكير والفعل؛ و”مصدر خيارات” آخر سيقوم بتأوينه الفعلي التاريخى بأكمله : من بولس الذى يكشف المدى الشمولى لبشارة يسوع ويحرر هكذا الإله الواحد من قيوده الأصلية؛ الى النقاش حول المسيح الذى يولد منطقاَ ميتافيزيقياَ صرفا للغيرية ينقض الفهم الموحد/غير العادل للكائن (غير الحاسم باتجاه هدم مبدأ التراتبية )؛ ثم الى مرور الامبراطورية وانتشار الأنظمة الإقطاعية (إعادة التوازن بين المبدأ الجماعي والمبدأ الفردي مع ما يفتح ذلك من إمكانات من أجل فردية جد خاصة؛ إذ هى داخلية بحتة؛ خارجة عن العالم وقد نقلتها رسالة يسوع بالذات)؛ ثم الى التوتر بين الكنيسة والملوك الذى هو فى الشكل نابض الدنيوة الفعلية؛ وأخيراَ الإصلاح الدينى وسائر الانقلابات الهامة فى العصر الحديث.
إن الوجود- فى- العالم الجديد الذى أقامه يسوع ليس فقط نهج وجود فردى. فالانسان الذى يكون على علاقة –مباشرة- مع- اللة يبقى كلياَ كائنا َإجتماعياَ له واجبات تجاه القيصر لا تقل قدسية عن واجباته تجاه الله . هناك أمر غريب :البقاء خارج عالم ينبغى القبول بالعيش فيه.
يبدو لى أن ميزة المسيحية تعود الى غياب تحديد حسى للسلطة. فالقيصر يبقى كلياَ خارج الإطار المكون للواجب.”أطيعوا السلطات”و”كل سلطة تاتى من الله “(رسالة بولس الى الرومانيين).إننا نجد هنا فكراَ غير مبال بالسلطة (كل سلطة وليس سلطة معينة). إن المسيحية تجعل السلطة مطلقة لكى تمنعها من أن تفعل الشئ نفسه بشرعيتها الدينية إن الواقع الدينى ؛فى كمونه التغييرى؛ ينظم هنا السياسة؛ لابل يحث عليها. المهم هو أن السلطة لم تعد فى صلب التشكيل الدينى ولا حتى داخلة (كما هى الحال فى الاسلام). واذا كانت لها مع الدين علاقات تبعية شديدة التوتر؛ فهى علاقات تقوم دائما عبر حركة بين نقطتين جذب منفصلتين تماماَ . نقطتان إحداهما ذات جوهر محدد والأخرى تحدد بطبيعتها دائما بالنسبة للأولى التى هى مصدر شرعيتها .هذة الحركة – التى ظلت ديناميتها فاعلة فى الغرب لغاية القرن السادس عشر – سوف تقود تدريجيا الى إعادة قولبة طبيعة السلطة السياسية فى علاقتها بالدين.
لا يعير غوشيه أى انتباه خاص للدين لجهة تركيب الشعائر الدينية. إن الأساس عنده والجديد يكمنان فى تدبيره العام للظاهرة البشرية؛ وفى بنيته للحياة المادية والحياة الاجتماعية والحياة الفكرية. يبقى آلهة العصر الميثولوجى – السحرى داخل هذا العالم عاجزين عن التأثير عليه بكليته ولا تهم قدراتهم المؤثرة على الدورة المتحركة للأحداث (المرض والموت والنيازك) التى تجتاز المشهد الثابت والمتكرر منذ التأسيس. على عكس ذلك؛ فإن الخصوصية المجددة للوحدة الدينية إنما تتمركز فى فكرة الخلق الجديدة . إن الإله الخالق يملك ؛من خارج العالم ؛ سلطة مطلقة على الاشياء كافة وهو يراقب مسارها اليومى كما تركيباتها الاكثر عمقاَ(19).
يسكن العالم آلهة يؤثرون عليه بنسب متفاوتة ولكنهم لايتحكمون قط بمساره.لا يكون العالم مقدساَ (بامكنته وآلهته ) إلا بقدر ما يشكل انعكاسا صادقاَ للماضى المؤسس؛ لما هو اولى؛عوضا أى لماضى يكون الاحتفال به من خلال الطقوس؛ إعلاناَ لابتعاده الذى لا يعوض. فى حين أن آله التعالى الخالق والمسؤل فى كل حين عن العالم يمثل تماما إمكانية الوصول الى الأساس وتوحيد هذين البعدين المنفصلين فى البداية : الأولى والحالى.(“تفترض الملازمة فى الواقع الانشطار عن الاصل ؛ فى حين ان التعالى يقربه ويجعله فى متناول اليد”). فى هذة النقطة تحديداَ؛ تبدو رؤية غوشيه وكأنها الاجابة الأفضل على المقترحات السوسيولوجية التى تظهر الدين كمرادف لمهمة رمزية ثابتة وذات مضمون متبدل وفقا لكيفية تطبيقة.
خاصة وأن التعالى يشكل قطيعة مع الديانة الأولى وهو ايضاَ تجسيد لإحدى إمكانياتها ؛ أى أحد “ممكناتها” ألا وهو الاتحاد مع ما هو أولي وتخطى ما يحول دون تصور العالم متحداَ فى كل نقاطه مع أصوله ومطابقاَ فى اى مكان لذاته (خصائص الفكر المثيولوجى/الرمزى).
إن الهوة الفاصلة بين الصيغتين المتناقضتين ل”دين المعنى”؛ تبدو وكأنها لا تأتى من مجرد الظهور الخلاق لنظرة دينية لا علاقة لها فى نهاية المطاف بسابقاتها؛ بقدر ما تأتى من تحول منضبط لتنظيم سابق، فالمهمة الدينية بالذات هى التى تتكون ثانية وتتجدد وفق حركة دائرية لا وفق منطق متقطع . هكذا يمكننا أن نفهم كيف جاء التعبير عن اختبار الغيرية الجديد هذا شديد الارتباط بالكون الرمزى الذى يحيط به. (هل يمكن أن نتصور عكس ذلك؟).
إلا أن الانتقال الى “الممكن” لا يجد بالضرورة؛ دافعه التاريخى وما يكونه فقط فى اختبار المقدس (إن يهوه فى التوحيد اليهودي هو جواب على تحد وعلى مواجهة بين الضعيف والقوي؛ أكثر منه على ضرورة دينية داخلية). وحيث أن على هذا الدافع أن يجد ظرفا تمكينياَ دينياَ؛ فقد تكون إله الخروج من مصر على عكس آلهة مصر؛ ولكنه؛ وبفعل ذلك؛ يشكل الاستفادة الجذرية من الامكانات الروحية الكامنة داخل المصدر الاستبدادي (الإله الحي؛ النزعة الى الوحدة؛ شخصنة القدرات المقدسة).
يتحتم علينا أن نكشف فى منطق هذا الانتقال ترجيعاَ رمزياَ/شعائرياَ فى الرسالة التى أعطاها النبي اليهودي وفى الشعائر التى مارسها . ولكن تجدر الاشارة أولا الى أن وضع الرسالة؛ وحتى وضع الشعائر؛ لم يعودا كما كانا فى السابق بالنسبة للمتلقين. إن الكاهن/الساحر يعمل من داخل غابة الكائن؛ يقرأ العلامات ويلج الرسائل الخفية؛ يتواصل مع الارواح التى تحييه؛ يكشف المستقبل ويعطى إنذارات القوى غير المنظورة وتمنياتها. فى كافة الاحوال؛ تبقى هذه الرسائل منتظمة وخاصة. إن الكاهن / الساحر وسيط من عالم البشر يتوصل إلى قوى من العالم؛ فى حين نجد النبي اليهودي تقريبا َ فى الجهة المقابلة؛ يتكلم باسم تدبير شامل لسلوك البشر ولما يجب أن يكون في المطلق؛ يتكلم من خارج الجماعة باسم إرادة عليا خارج العالم. إنها إحدى مهام المقدس؛ تختلف جذرياَ عن سجلات الاجتماعي و الفردي؛ وتتخطى القربى الرمزية والشعائرية مع الديانات الاولى؛ وقد رأينا نتائج تغييرها الجسيمة.