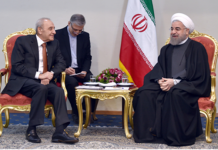الانسحاب الأميركي يخلّف «شرقين» أحلاهما مر
سام منسى/الشرق الأوسط/12 تموز/2021
بعد 19 عاماً على غزو أفغانستان إثر هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، لا بد من وقفة أمام ما سيترتب على انسحاب أميركا بالطريقة المستهجنة التي يحصل بها؛ ويلفتنا أمران: الأول هو محاولة «طالبان» الاستيلاء على مزيد من الأراضي، وهذا ما يحصل فعلياً بعد أن كثفت هجماتها، وسيطرت على جنوب البلاد باستثناء المدن الكبرى، وأحرزت تقدماً في شمال شرقها على الحدود مع طاجيكستان، وانتشرت في غالبية الأقاليم حتى باتت تسيطر على نحو 75 في المائة من مساحة البلاد. الأمر الثاني هو توقع استيلائها على السلطة، وعودة نظام الإمارة الإسلامية الطالباني، مع ما يعنيه ذلك من تهديد للسكان الذين عاشوا حتى الآن فترة زمنية من الحرية والانفتاح في ظل حماية أميركية، ولو هشة، واجتياح التطرف لنواحي الحياة كافة، من اجتماعية وتربوية وثقافية. أضف إلى ذلك قلق جيرانها الأقوى والأقل قوة لجهة استشراف موجات نزوح وهجرة، وتصاعد الأنشطة الإرهابية ونزاعات الحدود. ولعلها بترك أفغانستان لـ«طالبان»، سوف تستولد حالة من الفوضى تضعضع عبرها الدول المعادية لها استراتيجياً، كروسيا والصين، وحتى المنافسة كالهند.
بداية، صحيح أن واشنطن هي الجهة الأقل تضرراً من الانسحاب، على العكس من دول جوار أفغانستان، إنما الصحيح أيضاً أن غزوها لهذا البلد والحملة الدولية ضد الإرهاب التي قادتها لم تسفر عن أي مكاسب استراتيجية، واقتصرت مآلاتها على نجاحات تكتيكية محصورة ضد «القاعدة»، ومقتل أسامة بن لادن في مخبئه الباكستاني. ولا يمكن فصل مسار انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عن سياسة انسحابها من المنطقة ككل، وهو مسار يبدو أنه لا تراجع عنه، في محاولة للخروج من حروبها «التي لا تنتهي» على حد قولها، بدءاً من انسحابها على رؤوس الأصابع من العراق بعد حرب مكلفة بشرياً ومادياً، في استنساخ لانسحابها من لبنان عام 1983 بعد تفجير مقر المارينز في مطار بيروت، ومقتل 241 جندياً أميركياً. ولن تكون الحال في سوريا أفضل في نهاية المطاف، رغم وجودها المتواضع جداً. واشنطن ستترك المنطقة ودولها تقلّع شوكها بيدها، في وقت تحاول فيه من جهة أخرى إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وهذا أقصى ما ستقدمه الإدارة الأميركية الديمقراطية الحالية للمنطقة، وهو يصب في إطار مواصلة إدارة جو بايدن سياسة سلفه دونالد ترمب؛ أي أميركا وأمنها القومي أولاً، باستثناء حماية أمن إسرائيل التي باتت حذرة في علاقاتها المتقلبة مع واشنطن، لا سيما مع إدارة بايدن.
إن هذا الانسحاب، معطوفاً على الانسحابات الأخرى، دليل آخر على فشل الحروب الأميركية التي تنتهي قبل أن تبدأ، وهذا الفشل ليس فشلاً عسكرياً وأمنياً بقدر ما هو فشل سياسي واستراتيجي، بحيث تبدو المحصلة السياسية لتدخلاتها العسكرية في المنطقة صفراً مكعباً. فمحاربة واشنطن لـ«طالبان» على مدى 19 عاماً انتهت بتوقيعها اتفاقاً تاريخياً مع الحركة في الدوحة عام 2020، أهم بنوده عدم تهديد «طالبان» لأمن الولايات المتحدة وحلفائها، وعدم سماحها أيضاً بذلك لأي جماعة أخرى، لا سيما تنظيم «القاعدة». وغني عن القول أن تدخلها في العراق أجج طموحات إيران التوسعية، وفتح أمامها باب المنطقة على مصراعيه، وبات وجودها في هذا البلد تحت رحمة هجمات الميليشيات الموالية لطهران بالصواريخ والمسيّرات المفخخة. وتركت بشار الأسد في سوريا يجدد لنفسه في انتخابات هزلية، ولن نتحدث عن لبنان حيث «حزب الله» الإيراني يصول ويجول على غاربه حتى رمى البلاد في الهاوية.
ما المتوقع بعد الانسحاب الأميركي والأطلسي من أفغانستان، لا سيما إذا كرّت سبحة الانسحابات من دول أخرى؟ وما البدائل المتوقعة في الوقت الذي تتردد فيه كثيراً في الإقليم أصوات تدعو إلى التوجه شرقاً؟
بمعزل عن حجة وواقعية هذا الخيار أو عدمه، ينبغي معرفة عن أي شرق نتحدث؟ وأي شرق هو المقصود؟ الشرق المشبّع بحضارة عربية وفارسية وإسلامية وسمت المنطقة لقرون، أم أننا أمام شرق آخر متخيل افتراضي، هو في الواقع شرق متوحش لا يمت بصلة إلى حنين رومانسي لشرق حضاري قديم أصبح من الماضي؟
انسحاب أميركا، ومعها الغرب، يعني ببساطة ترك الساحة لاجتياح محورين:
الأول تمثله روسيا والصين، وهما دولتان محكومتان بديكتاتوريات، ولو متباينة، جامعها المشترك عداؤها لليبيرالية والديمقراطية الغربية، وهما أقرب الأنظمة إلى الإنسانية. ديكتاتوريات باتت غير مؤدلجة بالكامل، لا سيما روسيا، بينما الصين تتمسك بقشرة من آيديولوجيا الحزب الشيوعي ستاراً لحزب استبدادي يحكم نظاماً رأسمالياً تديره الدولة. وما سوف تحمله الأيام هو بصمات التيار الروسي الأوليغارشي والصيني المستبد في الاقتصاد والسياسية والثقافة والاجتماع وغيرها.
المحور الشرقي الثاني تمثله أفغانستان تحت حكم «طالبان»، وإيران تحت حكم الملالي، وإلى حد أقل بكثير تنظيم «الإخوان المسلمين»، إذا قدر له أن يحكم مستفرداً ويطبق إسلامه السياسي. والتيار الثاني الذي تمثله إيران الإسلامية «الشيعية المتشددة»، و«طالبان» السنية الأصولية المتشددة، يقدم في المحصلة آيديولوجيتين أصوليتين متشددتين عنيفتين. والمعضلة أن هذه النماذج مجتمعة غير قادرة على، ولا حتى راغبة في، أن تقدم لمجتمعاتها ما تحتاج إليه وما تتطلع إليه.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن النموذجين الروسي والصيني من جهة، والإيراني والأفغاني من جهة ثانية، ليسا على وئام، بل إن التوجس الروسي والصيني من إيران وأفغانستان معاً ليس بالأمر اليسير، وهو يحمل في طياته مخاوف على أكثر من صعيد، دينية وعرقية ومذهبية واجتماعية وأمنية لا مجال لتفصيلها في هذه المساحة. وفي الوقت نفسه، كل من أفغانستان وإيران تخشيان من سطوة وتأثير روسيا والصين اللتين تتمتعان بقوة اقتصادية وعسكرية وسياسية لا مجال لمقاربتها بقوتهما ونفوذهما.
الإشكالية في هذا الشأن أن الروس والصين معاً يخشون التهديدات الآتية من أميركا والغرب أكثر من خشيتهم من الآيديولوجيا التي تحكم إيران وأفغانستان، وجميعها تسلطية إقصائية كارهة للحريات.
موسكو وبكين تعدان عن حق، أو من دون حق، أن الديمقراطية والليبرالية الغربية هي التهديد الوجودي لهما نظاماً ومجتمعاً، وهدفهما الرئيس هو خروج الولايات المتحدة من المنطقة، لتبقى ساحة لهما في السياسة والاقتصاد والأمن، لذلك تستخدمان حالتي أفغانستان وإيران والمنظمات خارج الدولة بشكل خاص في مواجهة أميركا وحلفائها لتثبيت مواقعهما في الإقليم. ويعيدنا ذلك إلى مخاطر الأصوات المنادية بالتوجه شرقاً، وهي كثيرة، وفي أكثر من مكان من المنطقة، ولعل معظمها – باستثناء حلفاء إيران وأدواتها – لا يعي ولا يدرك نتائج هذه المناداة.
إن في ملامح ما آلت إليه أحوال الدول المتحالفة أو تلك المرتهنة للسطوة الإيرانية يكمن الجواب الكافي الواضح لهؤلاء، وأقربها نتائج سطوة «حزب الله» في لبنان، وحلفاء إيران وأدواتها في العراق، ونتائج التدخل الإيراني في كل من سوريا واليمن.
اللهم إلا إذا باتت هذه النماذج قدراً لا مناص منه لشعوبنا التي استسلمت بعد أن أرهقت ويئست من سياسات واشنطن، فهل هذا المصير البائس المقبل على دول كثيرة مهمة في الإقليم في صالح أميركا والغرب وقيمهما؟ لعل الإجابة تكمن في مراجعة ضرورية نقدية شفافة لسياسات واشنطن على مدى أكثر من خمسين سنة مضت، وحصادها في داخل أميركا المتأرجحة في تحمل مسؤوليتها في النظام الدولي ومنطقتنا.