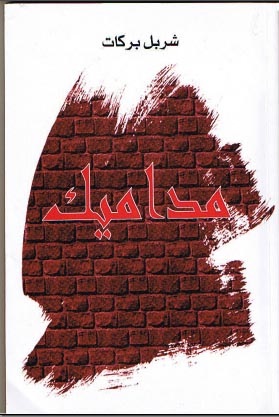كتاب الكولونيل شربل بركات “مداميك”/الفصل الثالث/الحلقة الرابعة
09 تشرين الثاني/2020
في هذا الوقت كان ابو صقر الذي نزل من ضهر العاصي محملا وقد نزف حتى فقد الوعي، يستلقي في القبو بين “رفقة” و”يوسف” الأعمى وقد كانا الوحيدين اللذين بقيا هناك بعد انسحاب المدافعين. وكانا قد سحبا أبو صقر إلى القبو لأنه لا يزال فاقد الوعي. وكانت رفقة ترطب راسه بخرقة تغسلها من حين إلى آخر بسطل ماء كانت قد تمكنت من تعبئته من البئر قبل نزولها. وكانت صلاتهما وتضرعاتهما تتلاحق كلما سمعا أحدا يقترب من باب القبو. وبعد حوالي الساعة من نزولهما فتح أبو صقر عينيه فشكرا الله على بقائه حيا ثم سأل أين هو فقالا له أنه في قبو العلية وأن الجماعة قد تمكنوا من الدخول وإشعال النيران. فجلس في مكانه وتحسس جرحه وقد كان ربط بشدة فبدا بوضع جيد فسأل عن سلاحه وكانت رفقة قد سحبته معها للدفاع عن النفس في حال حاول أحدهم الدخول إلى القبو، فوجده محشوا وقد كان لا يزال متزنرا بجناده وفيه ما يقارب عشرين خرطوشة، فقال لهما يجب علينا الرحيل وسوف آخذكما معي لأنهم عاجلا أم آجلا سوف يدخلون إلى القبو فلم نموت دون المحاولة؟ فقال يوسف الأعمى:
– لقد اصبحت شيخا وفقدت نظري منذ زمن طويل ولا حاجة لي بعد ولن أندم إذا ما مت الآن وقد أعيق سبيلكما فتسهلا ولا تحسبا لي اي حساب.
فابت رفقة وقالت أنها لا تستطيع الخروج ولا الركض وسوف تبقى مع يوسف مهما جرى “أما أنت فالله يسهل أمرك فقد يكون لك حاجة في مكان آخر إذا ما قدر لك النجاة”.
وقف ابو صقر واستند على سلاحه ثم اقترب من الباب واستطاع أن يرى من شق بقرب الحائط وعلى ضوء النار المشتعلة رجالا ونساء برمون أمتعة بالنار وسط أهازيج و”زلاغيط” وينقلون اشياء أخرى بايديهم، فاستغل التهاءهم بالنهب وفتح الباب وخرج محتميا بالحائط، وما أن وصل قرب الحاكورة حتى تسلق السلسال وأصبح في الظلام، ولم يرى إلا أولئك المنهمكين بالسرقة والنهب فأطلق النار على أحدهم فوقع من الطابق الثاني وسط النيران وصرخ صراخا شديدا فهرب الباقون وصوت النساء يلعلع:
– رجعت النصارى… رجعوا… أهربوا… أهربوا…
وتمكن أبو صقر من التوجه إلى منطقة “البخينق” وهي منطقة حرجية كثيفة ومنها باتجاه الجنوب متنقلا بين الأحراج، أما رفقة ويوسف فقد تمكنا من الخروج بعد هرب الذين كانوا في العلية وتابعا السير إلى خارج البلدة محتمين بالظلمة.
كان “ابو روفائيل” من وجهاء البلدة الذين يشاركون في كل مشورة وقرار، لا بل كان أحد المخاتير في مرحلة ما، وكان من الحازمين في قرارهم وقد بقيت له عدة صداقات مع الجيرة و”مونة” على الكثيرين فالقبضايات كانوا ينزلون عنده في كثير من الأحيان، ولم يجرؤ أحد مرة على التعدي على قطعانه أو أجرائه، فوهرة “أبو سعيد” شقيقه قد عمت المنطقة منذ خمسين سنة. وقد كان هو كريما في استقبال الضيوف و”دعيسة” الليل. وكان “روفائيل” ولده البكر قد ناهز العشرين في أول شبابه وقد حمل السلاح مثل كل الشباب للدفاع عن القرية. أما “أبو سعيد” فلم يشارك في القتال بل كان اقسم ألا يطلق رصاصة بعد أن رفض اقتراحه قبل ستة اشهر بقيادة مجموعة من شباب البلدة والتوجه إلى عقر دار “صادق حمزة” والقضاء عليه وإراحة الناس من شر أمثاله. ولكن التخوف من التعدي على الناس في قراهم، لأنه يعطيهم حافزا للاجتماع والمهاجمة، وراء عدم الموافقة على اقتراح “أبو سعيد” الذي اعتبر ذلك جبنا وتخاذلا. وعندما نُعت بالتهور لم يقبل تلك الأهانة فاقسم على ألا يشارك في الدفاع عن البلدة حتى ولو هوجمت. لذلك كان قد غادر القرية قبل عدة ايام من الهجوم ولم يعرف أحد أين كان في ذلك النهار…
كان روفائيل في الجهة الشرقية عند بدء الهجوم ولم يعرف إذا كانت والدته وأخوته قد غادروا المنزل أم لا، ولذا عندما وصل المهاجمون إلى العلية قرر أن ينزل إلى البيت للتأكد من وضع العائلة، فوالده سيكون منشغلا بأمور الناس أكثر من أمر بيته، ولما كانت الشمس قد غابت وأسدل الليل ستاره وصل إلى البيت وإذا ببعض المسلحين قد سبقوه من جهة العين، وقد لمح أحدهم على الدرج فنهره وما كان من رفيقه الذي كان يحتمي بحائط “الصيرة” إلا أن بادره بطلق ناري أرداه على الفور، فوقع على المدخل مضرجا بدمه. وبعد قليل وصل والده الذي كان قد عرف أن العائلة خرجت من المنزل وتوجهت “ماري” ووالدتها مع الصغار إلى الجنوب ورافقتهم “يوسفية”. ولكنه لم يتأكد إذا كانوا قد أخذوا “بولس” الصغير معهم، فقد كان عند بيت جده كما قالت له جارتهم “ندى”، لذا فقد أراد التوجه إلى المنزل للتأكد من وجوده أو رحيله. وهكذا عندما وصل إلى هناك كان أول ما شاهد جثة “روفائيل”، وما أن رآه، وقد غطى دمه الأرض ووقع على وجهه وسلاحه لا يزال بيده، حتى صعق وانكب عليه يحركه ويحاول أن يجد فيه بعض نفس ولكن دون جدوى، فقام كالمجنون يصرخ بأعلى صوته:
– يا خونة يا مجرمون قتلتم ولدي… أقتلوني…
وسمع حركة قرب البير فركض باتجاهها فإذا به أحد المهاجمين فانقض عليه غير آبه يسلاحه وأمسك ب”خناقه” محاولا خنقه لكن أحد رفاقه وصل فاطلق عليه عدة طلقات وأصابه بكتفه وفخذه وظهره ولكنه لم يترك رقبة الأول حتى لفظ أنفاسه ثم استدار إلى جثة ولده وقال:
– أخذت بتارك يا روفائيل… وهلق صار فيي موت…
وانحنى على جثته وأسلم الروح…
كانت “نفجي” وبعض النسوة في بيت “أبو الياس” في الجهة المقابلة لبيت “الحاج” وقد راين ما جرى فهرعن باتجاه كرم الدير، وقد كانت رصاصة أصابت ابهامها فلفت يدها بمنديل كانت تحمله وربطتها جيدا لوقف النزيف وهرولت مع النسوة إلى خارج البلدة…
في هذه الأثناء كان “يعقوب” لا يزال يربض في متراسه منتظرا فإذا بحركة المهاجمين تقترب وقد دار النهب في منازل مجاورة ولكنه لم يطلق النار إلا عندما تأكد من محاولة أحدهم فتح الباب الخارجي لداره، فصوب سلاحه وأرداه بطلق واحد. ثم قدم رفاقه على صرخته فاصاب ثلاثة منهم قبل أن يعرفوا مصدر النار وتراجع الباقون. ولم يعد أحد يجرؤ على التقدم باتجاه داره…
كان “مارون”، ابن الخوري “انطانس”، صاحب ثروة وشأن في البلدة، فقد كان منظورا بين الناس وكان بيته أحد البيوت المفتوحة، وقد كان ولده “الياس” هاجر إلى أميركا وعاد وزاد على ثروة أبيه، وكانت أيضا ل”مارون” صداقات في كل المنطقة، وكان لأبيه الخوري “انطانس” معارف واسعة وتاريخ في العلاقات زمن الأتراك. فلم يرد “مارون” أن يترك البيت، واتكل أنه أصبح شيخا طاعنا ولن يجرؤ أحد على التعرض له. وكانت العائلة قد رحلت ولم يبق سوى شقيقته “مجيدي” التي تكبره سنا. وكانت تربطه أخوة قديمة مع إحدى العائلات الكبرى في الجوار، فظن أنه لن يتعرض للأذى ولازم بيته. ثم حضر صديقه “محمود” الذي كان يدعوه أخا، فاستقبله وتودد إليه “محمود” وطمأنه بأنه لن يمس، واستنطقه عن موضع المال ليحفظه له من الرعاع. فما كان من مارون إلا أن أحضر له صرة من الليرات الذهبية كان يخبئها في المنزل، وعندها قال محمود لولده “عقيل”، الذي كان يرافقه:
– نيّح عمك وعمتك يا ابني…
فما كان من “عقيل” إلا أن أطلق النار على الشيخ فأرداه في داره وشقيقته العجوز بقربه…
ظل أبو يوسف وبعض الشباب في جوار المحفرة بينما كان أبو سالم وفرقته قد التحقوا بعناصر “شرتا” لقطع الطريق الشرقية ومنع التسلل من هناك حتى تأمين خروج الجميع وعندما وصلت نظيرة وأولادها إلى المحفرة سألت عن زوجها فقيل لها إنه قد رافق فرقة “بسبسة” وقد تجده في طريقها عند “السوباط”. وعندما وصل “بطرس” ووالدته والصغار إلى “تين الميدان” ونزلوا باتجاه “الرباع”، تنفس أبو يوسف الصعداء خاصة بعد أن علم بأن زوجته لم تضع بعد وأنها وجدت ما تركبه في رحلتها الطويلة هذه، فقال في نفسه؛ بأن الله لا يزال يحن علينا في أقسى الظروف. ولكنه ، وهو البعيد النظر، بدأ “يعتل هم” الأيام القادمة فلم يكن يملك ذهبا مثل البعض لكنه مكفي الحاجات وبيته ممتلئ. ولكن في مثل هذه الظروف لم يكن من السهل نقل هذه الحاجات. وفكر بأن الأصدقاء في الجش وصفد وغيرها من قرى فلسطين المجاورة سوف يستقبلونهم، ولكن ماذا لو طالت الحالة؟ وهناك أشياء لا بد أن يحتاج المرء فيها إلى مال، ويصعب عليه أن “يمد يده لأحد”، ومن كان لديه بعض المال من أبناء البلدة سوف يكون هو بحاجته في هذه الأثناء. وبينما هو يفكر إذا بجارهم “الأخ” يسأل عنه ليخبره بأنه رأى فدانه قرب “عين طربنين”. وكان “زهير” و”صبحى” بقيا بالدار بعد أن شربا وقد ذهب أبو يوسف فرقدا هناك، ثم عندما بدا الرصاص يقترب جفل زهير فنطح الخشبة التي كانت في باب الدار وأوقعها وولى هاربا ورفيقته الصبحى تتبعه إلى أن وصلا إلى خارج البلدة حيث توقفا قرب “عين طربنين”، فنزل أبو يوسف إلى العين واقتادهما وقد فكر أنه في اسوأ الأحوال سوف يبيعهما ما قد يساهم في بعض مصاريف التهجير إذا طال، ثم عاد ينتطر بعض الهاربين قبل أن يكمل طريقه إلى فلسطين…
في تلك الأثناء كانت فلول الهاربين تتجمع في وادي كفر برعم وكان أبو بركات بعد أن نزل من العلية وتفقد البيت ولم يجد أحدا، تزل إلى بيت “عبد الأحد” ليستفهم عن نظيرة الأولاد، فقال له عبد الأحد الذي كان بقي وحيدا أن الأولاد كانوا عنده وذهبوا باتجاه الدير فنصحه ابو بركات بالرحيل معه فلم يرض وقال له إذهب أنت وابحث عن الأولاد أما أنا فمن سيفتش علي هنا وماذا يريدون من رجل عجوز مثلي. فتركه وانطلق لأن همه كان أن يعرف ما حل بالأولاد فابنه بركات كان مع المقاتلين ومن سيهتم بعائلته؟.. وعندما وصل إلى المحفرة التقى بأخيه أبو يوسف فطمأنه بأنهم قطعوا باتجاه كفر برعم وأصبحوا في امان، عندها ارتاح باله قليلا فوقف مع أبو يوسف والشباب وسأل عن بقية أولاد البلدة وهل يعتقد بأن كثيرين ظلوا فيها وهل عرف من قتل ومن جرح؟..
كانت هذه التساؤلات هاجسه الأكبر، فكيف ستتحمل قرية صغيرة مثل هذه الكارثة، وقد بدا واضحا أن الهم الأساسي للمهاجمين كان القتل والتهب، فهل سيقضى على أحلام هذا الشعب؟ وهل سنقتلع من هنا؟ وأين سنذهب؟ وما هو المصير؟ وكيف وصل الحال بنا إلى هنا؟..
كانت هذه هموم أبو يركات الذي كان يرى البلدة تصبح “زهرة بلاد البشارة”، ومركز إشعاع ومعرفة، وصاحبة جاه وعز، وحاضرة بكل معنى الكلمة. فهل سيقضى على أحلام الأجيال القادمة؟ وعلى كل الجهد الذي قامت به سواعد ابنائها منذ مئات السنين؟ وما هو الوطن إذا لم يكن طمأنينة واستقرار؟
بعد أن تأكد أبو يوسف وابو بركات أن كل من يستطيع الهرب قد فعل وأنه لم يعد من داع للبقاء هناك أرسلوا إلى أبو سالم الذي كان لا يزال يرابط في شرتا مع فرقته، أن ينسحبوا، وتوجه الجميع إلى كفر برعم، وقد أخذوا بطريقهم مجموعة “السوباط” التي كان التحق بها ايضا عددا من المقاتلين بينهم من تبقى من مجموعة أيوب التي كانت قاتلت قتالا مشرفا خاصة في داخل البلدة وبعد دخول الغرباء إليها وقد استعملوا في عدة مرات خناجرهم والسكاكين حتى أنه لم يخل زاروب من إحدى الجثث. وكان أيوب الذي رابط أخيرا على سطح الكنيسة قد قفز من الدرج الجنوبي للسطح، بعد أن استعمل كل ذخيرته، وسقط وسط مجموعة من المهاجمين الذين ذهلوا من هبوطه بينهم، وقد تمكن وسط ذهولهم من الهرب، واضطر لاستعمال خنجره بعد ذلك…
عندما اسدل الليل ستاره على عين إبل، وكانت البلدة اصبحت تعج بالغزاة، ولم يزل هناك بعض المقاومين الفرديين ومن لم يتمكن من الخروج، حاول البعض العودة لأخذ ما كان يخبئ، مثل “العبدوش” الذي كان خبأ كيسا من الليرات العثملية في المعلف، وعندما رجع وجد المعلف منبوشا وقد سرق الذهب، ولكنه كان وضع تنكة صغيرة في طاقة عالية بين خشب السقف لم ينتبهوا لها فاسقطها وأخذ ما فيها، لسد حاجة العائلة في التهجير، فقد كانت جماله سرقت ونهب البيت بما فيه، ولكنه لم يكن قد اشتعل بعد…
بعد أن ثقل الظلام لم يبقَ في البلدة إلا بعض العجزة أو الذين قرروا البقاء حتى الاستشهاد، وكان يعقوب لم يزل يرابط في داره، وقد خف ضجيج المعركة، واقتصرت الحركة على الغزاة الذين لا يزالون يطوفون بمجموعات صغيرة، وعلى بعض الأهالي الذين يحاولون العودة خلسة للتفتيش عن قريب لا يزال في البلدة. وكان “خليل” يرافق والده فهو ومع أنه لم يبلغ التاسعة من العمر، إلا أنه كان تعلم من والده الرماية وركب الخيل، وعندما رحلت أمه، اختبأ في برميل الطحين حتى فقدت الأمل بالعثور عليه واعتقدت بأنه رحل من بيت عمه قبلهم، وبقي مختبئا حتى عودة أبيه من القتال عندئذ خرج ولكن الوالد أنبه على عدم مرافقته لأمه ثم قال:
– جهز بندقيتك، وقد كان اشترى له بندقية فرنسية من صور في أول السنة كهدية لأنه كان أصبح ماهرا في استعمالها، وأكمل، لن أغادر قبل أن ياتي صديقي “حمد” وإذا ما حدث لي اي مكروه لا تبقى هنا ولا تحاول الظهور بل انطلق فورا والحق والدتك في “ابو سنان”…
وكان “حمد” هذا صديقا ل”يعقوب” وقد سبق وأظهرا صداقتهما ومساندتهما الواحد للآخر في عدة مناسبات. وكان يعقوب في قرارة نفسه يريد أن يتاكد هل أن هذه الصداقة يمكن أن تستمر أم لا؟ فهذا الوضع هو المحك، والقضية اليوم بين جماعته وجماعة حمد، وهو سوف يدافع عن حقه وبيته، فماذا سيكون وضع صديقه في هذه الحالة؟ هل سيتفهم وضعه ويقف موقفا مشرفا؟ أم أنه سوف يلتحق بجماعته وينسى ما بينهما وتصبح الغريزة الجماعية هي المحرك الأساسي لكل اعماله؟ وهل سيستطيع مواجهته أم ماذا؟..
كانت هذه الأفكار تدور في راسه وتدفعه إلى الصمود أكثر من التعنت في الدفاع عن بيته، وهو ليس اهم من حياته، ولا عن قريته، وقد كادت تفرغ من سكانها والبقاء فيها يعتبر انتحارا.
وفي ساعة متأخرة سمع وقع حوافر خيل صاعدة على الطريق من جهة العين، وهذه الطريق تمر تحت متراسه، فانتظر ليرى من يكون هؤلاء القادمون، وبعد أن اصبحوا قرب بيت “بو مطر” توقفت الحركة ثم سمع صوتا يناديه:
– يا “بو يوسف”…
فعرف به صوت صديقه حمد فتنفس الصعداء ثم قال:
– يا هلا بك…
ونزل من مكمنه ففتح الباب الخارجي، وكان صاحبه قد وصل وترجل، فتعانقا ودخل حمد، ولكنه لم يسمح لأحد من مرافقيه بالدخول إلى الدار وانتظروا في الخارج ولم يترجلوا، وقال حمد:
– جيت لأخدك وين ما بدك تروح… على صور، أو لعندي.
فأجاب يعقوب:
– جينتك عزيزي يا “بو علي” وبتمون، بس كنت بفضل ضل ببيتي…
فأجاب حمد “أن الأيام قاسية على الجميع وأننا دخلنا في تيار لا نعرف اين سيأخذنا” وأنه لم يعد يؤمن “أننا من يتحكم بالأمور”، ولكن المهم أنه جاء خصيصا ليرافقه ليلا، لأنه نفسه لا يستطيع مخالفة التيار. فاعتذر يعقوب عن مرافقته. وكانت همهمة في الخارج بين مرافقي حمد، فقد كانوا رأوا الجثث التي لم يجرؤ أحد على سحبها بعد، ثم دخل أحدهم ونادى على حمد، فخرج وتحادث معهم وقد رفع صوته، وسمعه يعقوب في الداخل يقول:
– إذا حدا بيتعرضلو كأنو تعرضلي… ما برضى أبدا…
ففهم يعقوب مجرى الحديث وخرج إلى باب الدار وقال لحمد:
– له يا بوعلي… لا تعيط عالشباب… هيدي بارودتي بقدملك ياها، خدا، انت بتعرف إني ما كنت بسلم سلاحي لحدا وأنا طيب، بس معك بعتبر حقي وصلني… جينتك أهم من كل اللي صار…
فأخذ حمد بندقية صديقه وفهم مقصده في عدم احراجه أمام رجاله، وقال له:
– اعتبرها أمانة يا بويوسف…
– ثم ركب حصانه وانطلق وجماعته يتبعونه.
وكان خليل يختبئ على “السدة” وقد سمع كل ما جرى من حديث، وكان يمسك بسلاحه وقد قرر أن يساند والده إذا ما أضطر لذلك، وعندما سلم والده سلاحه لصديقه كبادرة منه أمام مرافقيه، فهم خليل أن بندقيته أصبحت الآن سلاحهم الوحيد. ولكن والده ناداه أن يحضر الفرس، “فلم يعد هناك داع للبقاء”. ووقف في باب الدار يشيع بنظره صديقه ومرافقيه، ولكنه لم ينتبه إلى ذلك الذي كان يراقبه من جهة بيت “شحادة”، وما أن تأكد هذا من ذهاب الخيالة وبقاء يعقوب بالخارج وبدون سلاح حتى اقترب بهدوء بين السناسل وأطلق عليه النار فسقط على الفور وولى هو هاربا باتجاه بيت “الحاج”، وكان خليل قد فك الفرس وأخرجها فلمح شخصا يركض بعد سماعه الرصاص، ولكنه لم يعلم أن والده أصيب، لأنه كان اعتقد أنه قد دخل إلى البيت، فتوجه إلى باب الدار ليستطلع الأمر، فإذا بوالده مضرجا بدمه على الباب الذي لم يزل مفتوحا، فلم ينظر إلى الجثة بل ركض إلى الخارج لاحقا بذلك الرجل الذي رأه يهرب، وما أن وصل إلى بيت “بومطر” حتى لمحه ثانية ينزل باتحاه العين، فتقدم إلى حيث أمكنه أن يرى الطريق، وقد كان القمر بدا يعطي شيئا من ضوئه، وانتظر أن يمر أمامه، وقد صوب سلاحه على نقطة من الطريق سيمر فيها دون شك، وما هي إلا لحظات حتى كان الطلق يستقر بذلك القاتل فيرديه. وعاد خليل يتفقد والده فوجده وقد لفظ أنفاسه، فأدخله إلى الدار وأغلق الباب وركب الفرس وانطلق يجري باتجاه الجنوب.
أما حمد فكان عندما سمع أول طلق “نقذه قلبه” وفكر بالرجوع، ولكنه حسب حساب مرافقيه الذين لم يكونوا كلهم على رايه، وخاف من العاقبة، وقد بدا أن التطرف سيد الموقف الآن، ولكنه عندما سمع الطلق الثاني أحس بالارتياح نوعا ما، فنعر فرسه وأكمل طريقه…