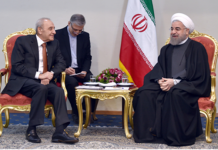هل تختفي جماعة «الإخوان المسلمين»؟
محمد شومان/الحياة/13 كانون الثاني/16
تواجه جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر أزمة داخلية تعتبر الأخطر في تاريخها، وهي أزمة متوقعة بالنظر إلى الجمود الفكري والتنظيمي الذي أصاب الجماعة وحال بينها وبين التجديد والتطور، وأدى إضافة إلى عوامل خارجية إلى سرعة وصول «الإخوان» إلى حكم مصر، وسرعة إطاحتهم مشهداً تاريخياً كشف بوضوح عن ضعف أداء النخبة التي قادت الجماعة، وجمودها، وانغلاقها على ذاتها، وإنكارها الأزمة، وتعاليها على شباب «الإخوان»، وعلى القوى السياسية كافة، بل وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع في مصر. الجمود الفكري والتنظيمي هو السمة الأهم من وجهة نظري في تاريخ الجماعة منذ تأسيسها الثاني في مطلع السبعينات من القرن الماضي، وضمن هذا الجمود الفكري والتنظيمي قوة الجماعة وقدرتها على الاستمرار والانتشار في المجتمع عبر أنشطة اجتماعية واقتصادية عدة، وظفت لصالح العمل الدعوي والذي اختلط ببعض السياسة، فالجماعة لم تمارس السياسة بالمعنى الحقيقي وإنما اختزلتها في خوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات النقابات المهنية واتحادات الطلاب في الجامعات، بينما ابتعدت من النقابات العمالية والمجالس البلدية. تمسكت الجماعة بأفكار وتوجيهات ونصائح مؤسسها حسن البنا (1906- 1949) في ظل واقع متغير، ما حقَّق عزلة فكرية وشعورية لكوادر الجماعة وعناصرها ساعدت في وحدتها وتماسكها، عبر إذعان الأعضاء للقيادة التي لها حق السمع والطاعة. ولا شك في أن عمومية أفكار حسن البنا وغموضها ومثاليتها وادعاءها تمثيل الإسلام، فضلاً عن ادعاء المظلومية وأدبيات المحنة، ساعدت على تماسك الجماعة وقوة تنظيمها في وقت عانت القوى والأحزاب المنافسة من صراعات فكرية وانقسامات تنظيمية. وأعتقد أن نجاح الجماعة في الانتشار والتجنيد ودخول البرلمان منذ الثمانينات دعَّم مسلّمة «الإخوان» الشهيرة: «التنظيم قبل التفكير»، فأصبحت وحدة الجماعة وقوة التنظيم أولوية شبه مقدسة تفوق ممارسة الفكر والتجديد، والدعوة والعمل بين الناس. من هنا لم تطرح مبادرات فكرية أو سياسية تخرج عن أفكار حسن البنا التي أنتجها ومارسها في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي. ولم تتبنّ قيادة الجماعة أفكاراً جديدة، بل اعتبرت أي تجديد فكري أو تنظيمي نوعاً من الخروج عن وحدة الجماعة ومحاولة لشق الصفوف. من هنا إطاحة بعض رموز «الإخوان» من جيل الوسط، أمثال أبو العلا ماضي، ومختار نوح، ومحمد حبيب، والزعفراني وعبد المنعم أبو الفتوح. إطاحة هؤلاء لم تكن فقط للحفاظ على وحدة التنظيم، وإنما ارتبطت أيضاً بصراع على السلطة والهيمنة على مكتب الإرشاد، والذي انتهى إلى مجموعة المرشد محمد بديع، والتي تعرف بجمودها وضيق أفقها، وعدم قدرتها على احتواء أجيال الوسط وشباب «الإخوان» الذين أصبحوا يمثلون أغلبية أعضاء الجماعة. ولكن تقليدية الإطار التنظيمي والروح الأبوية في مؤسسات الجماعة، والشعور الدائم بالاضطهاد والمطاردة من سلطة الرئيس مبارك كفلت وحدة الجماعة وقدرة القيادة على تأجيل الصراعات أو تجميدها أو التحايل عليها، أو ربما إبعاد العناصر المتمردة بأقل قدر من الخسائر. وأتصور أن وصول «الإخوان» إلى السلطة والسعي للهيمنة على مؤسسات الدولة كان من شأنهما تمتين وحدة الجماعة وتماسكها في ظل رغبة أو طموح كثير من عناصرها للحصول على المكاسب بعد سنوات من المعاناة والمطاردة. وربما يفسر هذا الطموح جموح «الإخوان» للهيمنة على مفاصل الدولة. لكن إطاحة محمد مرسي والجماعة بدَّدت هذه الطموحات، ونقلت الجماعة إلى مربع المحنة والابتلاء الذي عاصرته غير مرة منذ تأسيسها عام 1928. لكن المحنة الأخيرة كانت الأقسى والأكثر مرارة، حيث تدخل الجيش مدعوماً بتأييد شعبي واسع من أغلبية المصريين، الذين نزعوا عن جماعة «الإخوان» الدعم والتعاطف. وبالتالي واجهت بعد 30 حزيران (يونيو) 2013 الملاحقة الأمنية والإعلامية مدعومة بتأييد ودعم أغلبية المصريين. وأعتقد أن هذا التحول هو الجديد في الصراع بين الدولة المصرية ممثلة بالجيش من جهة و «الإخوان» من جهة أخرى.
يمكن القول إنه في أدوار الصراع السابقة كافة، سواء في العصر الملكي أو أيام عبد الناصر، كانت غالبية المصريين تقف إما على الحياد أو تتعاطف مع الدولة أو مع «الإخوان». لكن في الصراع بين «الإخوان» ونظام الرئيس السيسي شاركت غالبية المصريين وللمرة الأولى في الإطاحة بـ «الإخوان»، نتيجة فشلهم في إدارة الدولة والكشف عن نياتهم الحقيقية التفرد بالحكم و «أخونة» الدولة والمجتمع. ويبدو أن تورط بعض عناصر «الإخوان» في حوادث إرهابية أشهرها تفجير أبراج الكهرباء والإضرار بمؤسسات الدولة حافظ على طاقة العداء والرفض الشعبي لـ «الإخوان»، وحرمهم من الحاضنة الشعبية التي تمتعوا بها أيام حكم مبارك، والتي كفلت لهم الفوز بغالبية مقاعد برلمان 2012 ورئاسة الجمهورية. وأتصور أن التعاطف مع المظلوم هو المدخل الرئيس الذي جعل غالبية المصريين تختار «الإخوان» في كل الاستحقاقات الانتخابية بعد الثورة. غير أن هذا التعاطف تحول إلى نقيضه بعد وصول «الإخوان» للحكم في واحدة من أهم مؤشرات التحول في الرأي العام المصري.
القصد أن الصدامات الدموية بين «الإخوان» ودولة السيسي، والملاحقات الأمنية والمحاكمات التي يتعرضون لها، لم تساعد الجماعة حتى الآن في تجنب معادة غالبية المصريين أو إقناعهم بالوقوف على الحياد. ما يعني أن المحنة أو المظلومية التي يتحدث عنها «الإخوان» في مواجهة النظام لم تنتج الآثار نفسها التي وظفتها الجماعة لمصلحتها في الصدامات التاريخية السابقة مع الدولة، فغالبية المصريين ما تزال ضد «الإخوان»، كما أن التنظيم لم يحافظ على تماسكه ووحدته كما كان يحدث في المواجهات والصدامات السابقة مع الدولة، وإنما على العكس ضربته الصراعات والانقسامات، وهي تحولات مهمة لمصلحة الدولة في المرحلة الراهنة. لكن تلك الأوضاع قابلة في المستقبل للتغيير وفق قدرة نظام السيسي على تحقيق إنجازات في أرض الواقع تستفيد منها غالبية المصريين. والفرضية التي أطرحها هنا، أن زوال الحاضنة الشعبية لـ «الإخوان» ونهاية التعاطف معهم وتحوله عداءً، سارعت في تفجير الخلافات والانقسامات داخل الجماعة، فالعزلة وفشل خطاب «الإخوان» في التأثير في الشارع في ظل حكم السيسي، ولّدا مناخاً داخل الجماعة شجَّع على الاختلاف والصراع، والذي ظهر بوضوح أثناء الانتخابات الداخلية لاختيار لجنة لإدارة الجماعة في شباط (فبراير) 2014، بعد أن غيَّب السجن أو السفر غالبية أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة. ومع استمرار الصراع مع نظام السيسي، والفشل في تغيير موقف الشارع، تفاقمت صراعات الجماعة، وظهرت على السطح في الأسابيع الأخيرة انقسامات خطيرة تهدد وحدتها وتماسكها. ومحور الخلاف يدور بين فريقين: الأول يضم عناصر من جيل الوسط وشباب الجماعة، مدعوماً ببعض «إخوان» الخارج. والفريق الثاني يتكون من القيادة القديمة وأنصارها، ومعظم هذا الفريق من كبار السن. ويرى الفريق الأول ضرورة تصعيد أعمال الاحتجاج والمقاومة ضد النظام الجديد قبل استقراره، في محاولة للإطاحة به، ويتطلب ذلك من وجهة نظرهم الاعتراف بأخطاء القيادة السابقة لـ «الإخوان»، والانفتاح على قوى ثورية رافضة لنظام السيسي، والعمل معها في ضوء شراكة حقيقية تختلف عن النهج البراغماتي التقليدي لـ «الإخوان» والذي ظهر في تعامل محمد مرسي مع القوى المدنية بعد وصوله إلى الرئاسة حيث لم يلتزم بوعوده السابقة بإشراكهم في الحكم.
في المقابل، يرى الفريق الثاني أنه لا بديل من المنهج السلمي الإصلاحي لـ «الإخوان» والابتعاد من ممارسة العنف أو التلويح به، ومن ثم التخلي عن التظاهرات والاحتجاجات الدورية والتي تكبد الجماعة خسائر هائلة وتفقدها تعاطف الشارع. ويتطلع ممثلو القيادة القديمة إلى تحقيق مصالحة مع نظام السيسي تكفل للجماعة وجودها واستمرارها، وتخفف من أحكام الإعدام على المرشد وقيادات الجماعة وراء السجون. ومن الواضح أن الحرس القديم تحركه خبرات المصالحة بين «الإخوان» والسادات، والتعايش مع نظام حسني مبارك، علاوة على فقه المحنة والمواءمة، وربما التقية.
وعلى رغم الاستقطاب الشديد بين الفريقين، إلا أنهما يتمسكان بمقولات الشرعية ونتائج الانتخابات، واستراتيجية السلمية المبدعة، مع اختلاف في تأويل المعاني وتوظيف المفاهيم والمصطلحات، فالحرس القديم مع الشرعية التاريخية والمؤسسية، بينما يؤكد جيل الوسط والشباب على شرعية الانتخابات الأخيرة عام 2012، وعلى شرعية الوجود والفعل المستمر في الشارع ضد نظام السيسي. كما أنه يؤوّل السلمية المبدعة إلى حق الدفاع عن النفس والعنف لتعطيل مؤسسات الدولة والقضاء على استقرار النظام. إن الصراع لا يتعلق فقط بالسلمية مقابل ممارسة مستويات من العنف، أو السلمية مقابل الثورية، وإنما بتقييم أداء مكتب الإرشاد بعد الثورة، بخاصة مرحلة وصول الجماعة إلى السلطة، وقواعد إدارة الجماعة وعملية اتخاذ القرار، والموقف من نظام السيسي ومستقبل الجماعة. وقناعتي أن «الإخوان» فشلوا في صيغة السلمية المبدعة، كما أن الثورية أو ممارسة مستويات من العنف للدفاع عن النفس ستؤدي حتماً إلى الإرهاب. وقناعتي أيضاً أن الصراع لا يدور حول اجتهادات فكرية أو سياسية، وإنما هو صراع أجيال وبحث عن السلطة وربما مصالح. بكلمات أخرى، يظل الخلاف تنظيمياً وإدارياً يتعلق بأساليب التعامل مع نظام السيسي ولا يتطرق إلى مراجعة أساليب التعامل مع الناس، فالدعوة لدى الفريقين ما تزال هي المدخل الرئيسي، إضافة إلى استغلال المحنة والمظلومية التاريخية لـ «الإخوان» للحفاظ على وحدة التنظيم وكسب تعاطف الرأي العام. لذلك فشلت جهود الوسطاء من «إخوان» الخارج والداخل للتقريب بين الفريقين المتصارعين. والسؤال: من يحسم الصراع لمصلحته؟ وهل سينجح الحرس القديم كما نجح من قبل في إقصاء المعارضين له، أم ينجح جيل الوسط وشباب «الإخوان»، وتتغير طبيعة الجماعة ومنهجها في العمل نحو مزيد من التشدد والإرهاب؟ وهل صحيح أن من تتوافر لديه موارد مالية أكثر سيكون أقدر على حسم الصراع لمصلحته؟ في كل الأحوال فإن إطالة أمد الصراع لن تكون في مصلحة جماعة «الإخوان»، التي قد تنفجر من الداخل إلى جماعات عدة تحت مسميات جديدة.
الكارثة السورية الإنسانية
رندة تقي الدين/الحياة/13 كانون الثاني/16
مشهد أطفال مضايا المحاصرة منذ أشهر وهم يظهرون كهياكل عظمية بسبب الجوع هو مشهد مريب ومعيب للأسرة الدولية والعالم. تركت الأمم المتحدة هذه الكارثة الإنسانية تحصل من دون التحرك منذ أشهر واستيقظت بالأمس. اين مسؤولية هذه المنظمة العالمية التي تدّعي أن لها مهمة انسانية؟ سمعنا أن بان كي مون لم يكن راغباً في عرقلة المفاوضات في جنيف لذا تأخر في التحرك حرصاً على إبقاء نظام بشار الأسد على قرار المشاركة في المفاوضات. روسيا تقصف المدارس والأطفال في سورية بحجة أنها تحارب الإرهاب. ويمر الخبر من دون أي رد فعل عنيف. إدارة السيد أوباما الكارثية للوضع في سورية لا تبالي بصور أطفال مضايا المحاصرين. إن بلدات أخرى في سورية محاصرة من المعارضة السورية وهذا خطأ ولكن الحصار فيها تخرقه طوافات النظام التي تبعث الى المدنيين المحاصرين المواد الغذائية في حين أن حصار مضايا مأساة. لقد انتظرت الأمم المتحدة حتى أمس لإدخال المساعدات الإنسانية بعد ستة أشهر وموت أكثر من خمسين شخصاً من الجوع ومحاصرة المئات. كان في إمكان طوافات التحالف الدولي او الأمم المتحدة أن تنقذ أهل مضايا من المجاعة وترسل لهم المواد الغذائية من الجو. معيب رد فعل العالم على هذا الحصار الانساني. إن الحرب السورية أظهرت منذ بدايتها أن أطفال سورية هم ضحايا بشار الأسد ونظامه. وكيف ننسى حمزة الخطيب ابن الـ 13 سنة الذي تم تعذيبه وقتله في درعا في بداية الإحداث على يد شبيحة النظام السوري في حزيران (يونيو) 2011. حمزة كان في عمر أحد أبناء بشار الأسد. كيف يرى هذه الصور المريعة لجرائم النظام الذي يحكمه ويديره؟ وكل هذا القتل والتجويع في سبيل بقائه واستمراره في القتل والتهجير للبقاء على رأس بلد خربه ومزقه وأدخل اليه قوات أجنبية، في الجو روسيا وعلى الأرض ايران و «حزب الله». لم يعد بشار وحده صاحب قرار الإجرام والقتل فله شركاء عازمون على إبقائه، روسيا لأنها تبحث عن بديل يؤمن لها مصالحها وبقاءها في المنطقة ولم تجده بعد. وإيران و «حزب الله» وكيلها على الأرض في سورية ولبنان لأنهما في حاجة اليه للمزيد من التخريب والهيمنة وزعزعة دول المنطقة. إن مفاوضات جنيف لن تؤدي الى نتيجة طالما أن الأوضاع الدولية لم تتغير. فإدارة أوباما ووزير خارجيته جون كيري تتنازل للجانب الروسي باستمرار لإظهار أنها تتحرك وتعمل لإنجاح مفاوضات لا يمكن ان تؤدي الى نتيجة طالما هي بعيدة كل البعد عما يحصل على الأرض في سورية. ووحدها بعض الدول الغربية من اصدقاء سورية وفي طليعتها فرنسا لها مواقف مميزة وناشطة لدعم المعارضة والتغيير في سورية. ولكن هذه الدول غير قادرة على تحريك ديبلوماسية جون كيري المستعجل لأي حل لدفعه الى اتجاه صحيح. فبان كي مون ايضاً وهو في السنة الأخيرة من ولايته مستعجل لتسجيل أي انجاز ديبلوماسي عبر مبعوثه المرموق ستيفان دي ميستورا. فكارثة سورية ستستمر ولا أمل من مفاوضات جنيف التي سيقودها من الجانب الأميركي كيري المتفائل الساذج وسيرغي لافروف ثعلب الديبلوماسية الروسية المحنك.
أي تطبيع تريده إيران مع السعودية؟
زهير قصيباتي/الحياة/13 كانون الثاني/16
إذا كانت الأحكام القضائية الكويتية أمس، تعكس إصراراً خليجياً على حماية دول مجلس التعاون ومجتمعاتها من الاختراقات الإيرانية، فالإصرار الإيراني على اتهام بعض دول المجلس، والسعودية خصوصاً، بما ترتكبه طهران سراً وعلناً، قد يكون دليلاً على أن الأزمة بين المملكة وإيران لن تكون عابرة.
والمشكلة مع جمهورية المرشد علي خامنئي ما زالت كما هي، لم تتبدّل منذ 1979. فالعلاقات بين الدول تقتضي بداهةً قنوات ديبلوماسية، تبدو غير موحّدة في طهران، أو غير منسجمة في أحيان كثيرة مع رغبات «الحرس الثوري» والأصوليين المتشدّدين و «الباسيج»، وغيرهم من أجنحة النظام التي تتوهّم هيمنة كاملة على منطقة الخليج، بذريعة حفظ أمنها «بلا أجانب». حادث الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، وقنصلية المملكة في مشهد، أثبت ما كان يخشاه أهل الخليج منذ ما قبل توقيع طهران الاتفاق «النووي» مع الدول الست: إيران تحت الحصار والعقوبات، تهدّد وتتوعّد وترشق الجميع بالاتهامات، وتتدخَّل في دول عربية تعاني صراعات داخلية فتؤججها… إيران ماذا عساها تفعل بعد رفع العقوبات الدولية والغربية عنها؟ لن تبادر طهران حتماً إلى الاعتراف بأنها جنّدت إيرانياً لتنفيذ مخطط يمسّ أمن الكويت مثلما تنصّلت من أي رابط بين التحريض الرسمي الإيراني والاعتداء على السفارة السعودية. والغريب مرة أخرى أن النظام الإيراني الذي كان ولا يزال يكرر رغبته في التطبيع مع السعودية وفتح حوار، يحرّض الحوثيين في اليمن على مواصلة قتال الشرعية ومَنْ يدعمها. ويمارس الأسلوب ذاته بعد حادث السفارة ومبادرة الرياض إلى قطع العلاقات مع طهران: يعاقب مسؤولاً أمنياً إيرانياً، لكنه يوزّع الاتهامات لتبدو حكومته «معتدلة» والآخرون ساعين إلى التوتر، في منطقة باتت على بركان «داعش» والتطرُّف. وبعد ما كتبه وزير الخارجية محمد جواد ظريف في صحيفة «نيويورك تايمز»، ابتكر وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي تهمة جديدة، وجّه أصابعها إلى «أيدٍ خفية سعودية وأجنبية» ضالعة بالاعتداء على سفارة المملكة في طهران. لكن فضلي الذي انتهز فرصة وجوده في دمشق، ليبرّئ حكومته من الحادث، معتبراً إياه «عملاً عفوياً لبعض المواطنين»، استدرك، متّهماً السعودية بأنها وراء مهاجمة سفارات إيران في لبنان واليمن وباكستان. كيف تذهب طهران الى حوار وتطبيع فيما لا تزال تتعامل مع دول كبرى في المنطقة بمنطق الأحزاب والفصائل والعقائد؟… يُدرك الجميع أن إرهاب «داعش» وسواه، يقدّم خدمة كبرى للطروحات الإيرانية التي تنتهي عند نقطة وحيدة تسعى إلى تكريسها لدى الغرب: كل إرهاب «سنّي»، مثل مموّليه، ولا قوة غير إيران التي تستتبع الشيعة العرب أو تدّعي وصاية عليهم لتعزيز حقوقهم، قادرة على احتواء هذا «الإرهاب»، من الخليج إلى العراق وسورية ولبنان. الإيراني يقاتل بدماء السوريين في سورية، ويقاتل «داعش» كما يقول، بدماء العراقيين، ويدافع عن «المظلومين» في اليمن بدماء اليمنيين، بعدما دافع طويلاً عن المقاومة والممانعة بدماء اللبنانيين شيعةً وسنّة ومسيحيين. يلعن الفتنة المذهبية، ويضخّ لها دماءً مدفوعة «الكلفة» من نفط العراق. لا غرابة، بفضل «حكمة» باراك أوباما، إذا توهّم المرشد أنه قادر على ملء الفراغ في النظام العالمي: الأميركي خائف على رأسه، الإيراني يضحّي برؤوس عرب، الروس يوسّعون مظلة الحماية.
المؤسف في تجارب التطبيع مع إيران، ان حقبة رفسنجاني- خاتمي مُحِيَت بجرّة من قلم خامنئي. ما بعد رفع العقوبات «ازدهار» يَعِد به الرئيس حسن روحاني شعبه، ولكن لا أحد في القيادة الإيرانية يُطمْئِن الجيران الى فتح صفحة من التعقُّل… مزيد من الصواريخ الباليستية بديلاً من البرنامج النووي، و «الرفيق» الكبير فلاديمير بوتين يجرّب هل يُلحِق الأرياف السورية بشبه جزيرة القرم!… لئلا يفاجئه الإرهابيون في الساحة الحمراء. أبعد بكثير من وصف حال مأسوية، درس إمكانات تمايز الشيعة العرب عن الوصاية الإيرانية المفروضة تحت أجنحة «الممانعة»، فهل يرفعون صوتهم ضد الاختراقات التي تفكِّك المجتمعات في المنطقة بسلاح الدفاع عن «المظلومين»؟ هل يكفي اتهامنا بطعن إيران من الخلف، لنستسلم أمام انهياراتنا الكبرى: بين إيران تنحرنا غيرتها على حقوقنا، وإسرائيل الشامتة أمام فصول القتل المتوالية… والغرب الذي يشكو أنه ملّ الدموع ومشاهد البؤس الوافدة إلى بيته؟
لا أحد في الخليج يصدّق أن «الحرس الثوري» وصواريخه، مجرّد عرض عضلات، قبل توزيع ورود المصالحة، من شط العرب إلى باب المندب.
المُمانعون أصدقُ من المُمانعة
زيـاد مـاجد/لبنان الآن/13 كانون الثاني
تُثبت “الممانعةُ” حكوماتٍ وأحزاباً أنها تكرّس يوماً بعد يوم منظومةً أخلاقية لا تحتكر الوضاعة، إذ ثمّة بين خصومها من قد يجاريها فيها، لكنها تُحوّلها الى سمةٍ لقسمٍ كبير من جمهورها ومُريديها.
وليس أشدّ دلالةً على الأمر سوى تعاطي معظم المُمانعين منذ سنواتٍ مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام الأسد، والتي صار لحزب الله بعد تجويع مضايا نصيبٌ من المسؤولية المباشرة عنها. فبعد نفي الحزب مُحاصرتَه البلدة السورية واتّهامِه “المروّجين” للموضوع بالسعي “لتشويه صورة المقاومة”، وبعد تحويل نفيِه الى اتّهامٍ للمسلّحين المُحاصَرين بالتسبّب بِالحصار، راح إعلامُه يبحث عن صُوَر مزوّرة أو منسوبة زوراً الى مضايا ليُبرزَها، علّه يخفّف بواسطتها هَولَ الجريمة أو يُرخي ظلال شكٍّ على حدوثها. ولم يكن من الصعب الوقوع على هكذا صُوَر منشورةٍ في مواقع التواصل الاجتماعي. فهي كثيرةٌ، ويظنّ مركّبوها – إن لم يكونوا مخابراتيّين – أنهم في استخدامها (البائس) و”تدويرها” كلَّ فترةٍ قد يستدرّون عطفاً إضافياً تجاه الجِياع الحقيقيّين. على أن جزءاً واسعاً من الجمهور المُمانع لا يكترث بِكلّ هذا. فلا النفي يهمُّه، ولا مقولة “تشويه صورة المقاومة” يأخذها على محمل الجدّ، ولا حتّى الصور المزوّرة تستثيره ليُكذّبَ خصومَه. فهو يعرف جيّداً أنها جميعُها مجرّد ردودٍ إعلاميةٍ لِمُعسكرهِ لا أكثر، ويعلم أن التجويع واقعٌ ويشمتُ بضحاياه، ويردّ على حملات التضامن معهم بحملات دعمٍ لحصارِهم مُرفقةٍ بصُوَرِ أطعمةٍ وبرّاداتٍ مليئةٍ بالمآكل، للهزء بوجعهم وبموت أطفالهم البطيء.
وتُذكّرنا خِسّتُه السافرة والصريحة هذه، بمقولاتٍ ردّدها مُمانعون آخرون مجّدوا ألوف البراميل المتفجّرة التي يقذفها طيران الأسد على المدنيّين السوريّين، في الوقت الذي كان الأسد نفسه ينفي امتلاك طيرانه لها. وتذكّرُنا كذلك بمسيرات طلّاب “البعث” السيارةِ في دمشق احتفالاً بالقصف الكيميائي للغوطتين الشرقية والغربية صيف العام 2013، رغم أنه قصفٌ نفاه أركان نظامهم يومها وقالت الناطقة باسمه إن الأطفال المخنوقين بسببه هم أطفالٌ اختطفهم “الإرهابيّون” من قرى الساحل السوري واقتادوهم الى الغوطتين حيث قتلوهم وعرضوا جثامينهم لاتّهام النظام بخنقهم وتشويه سمعته. هكذا، تحوّل احتفاء معظم المُمانعين بالجرائم الى طقسٍ دائم، الى منظومةٍ أخلاقية تُوالي القتل بوصفه رداً سياسياً على الخصم، لا همّ إن حاولَ فاعلُه التنصّلَ منه لاحقاً أو حاول حتى نفيَ وقوعه. فكذبُ القاتل قبل القتلِ وبعده ليس سوى “ديكور” ضروريّ لمهمّته أو مسرحةٍ خطابيّة ترافق فعلتَه. والأخيرة، مهما سفكت من دماء، لا تروي غليلَ هؤلاء الممانِعين كفايةً، إذ يُريدون إبادة شاملةً لِخصومِهم. أو بالأحرى يُريدون، تماماً كما قالوا بصدقٍ وفجور منذ اليوم الأول، تطبيقَ شعار “الأسد أو نحرق البلد” معطوفاً على “الجوع أو الركوع”. فهذه هي بالتحديد أخلاقهم وأخلاق من يناصرهم. أما الباقي كلّه، من جيوستراتيجيا ومقاومة وإمبريالية ومؤامرات وأقلّيات وتكفيريّين، فلا تغدو كونها تفاصيل، أو عدّة شغلٍ إعلامية