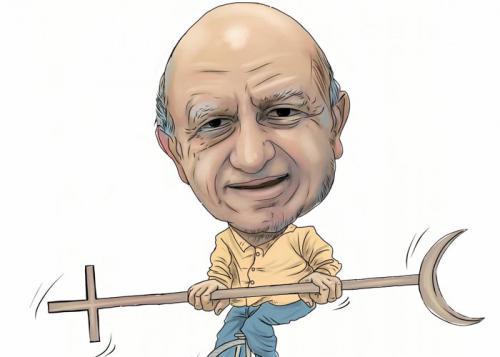سمير فرنجية: 14 آذار بلا مشروع.. و”السياسة” انتهت
يوسف بزي/المدن/السبت 09/01/2016
سمير فرنجية: 14 آذار بلا مشروع.. و”السياسة” انتهت لا أرى إمكانية لتقسيم المنطقة، كما لا أرى عودة إلى ما قبل الانتفاضة السورية
عشر سنوات من التحولات الصعبة. عقد مليء بالوعود الكبيرة والمفاجآت التاريخية، كما بالصدمات والخيبات الشديدة. انعطافات حادة، وانقلاب أحوال، وكوارث هائلة متتالية، هي بحجم التطلعات والأحلام التي حركت شعوب المنطقة ومواطنيها.
هي أولاً سنوات الأفكار والعناوين والشعارات التي طالبت بالتغيير، فتحولت ثورات سلمية أو انتفاضات عنيفة وحروباً أهلية – إقليمية، وفوضى متمادية ومدمرة. لكنها بالإضافة إلى ذلك، هي زمن التحولات العمرانية والاقتصادية و”السوسيولوجية”، والدخول في عوالم شبكات “التواصل الاجتماعي”، ومظاهر لا حصر لها لمستجدات العولمة…
بمزيج من اليأس والعناد، نحاول أن “نفهم”، أن نقرأ ونقيم “مراجعة” شخصية، مع مثقفين لهم صلة حميمة ومؤثرة بالشأن العام، ولهم إسهامهم الواضح في صياغة “الرأي العام” ولغته.
انطلاقاً من حيواتهم الخاصة وسِيَرهم، ومن المكان اللبناني وخصوصيته، إلى مشهد منطقتنا عموماً، وسجالاً مع أسئلة الثقافة والأيديولوجيات والسياسة والأحداث “التاريخية”، التي شهدناها في السنوات الأخيرة، نحاور عدداً من الباحثين والمفكرين والكتّاب اللبنانيين.
هنا نص الحوار مع سمير فرنجية، ونشدد على أن أجوبته هنا أتت شفاهية، وتم في ما بعد التدقيق في إملائها وتحريرها من غير تعديل:
* منذ عشر سنوات، انتقلت من ظل العمل الفكري السياسي إلى واجهة “انتفاضة الإستقلال”، كواحد من مهندسيها، واليوم تعود – ربما اختيارياً – إلى الظل. أين أنت الآن؟
– أنا اليوم خارج الأضواء، للسبب التالي: منذ فترة أقول، في جميع المناسبات التي تحدثت فيها، أن 8 آذار قد خسرت، ولكن 14 آذار لم تربح. والسبب أن 14 آذار لم يعد لها مشروع لمستقبل هذا البلد. هذا الكلام جعلني أكتب في آخر وثيقة لـ 14 آذار (بمناسبة ذكراها العام 2012)، أن علينا الانتقال من “انتفاضة الاستقلال” إلى “انتفاضة السلام”. علينا أن نبحث عن مشروع لطي نصف قرن من الصراعات شبه المتواصلة.
هذا الكلام لم يقنع رفاقي في حركة 14 آذار، فاستمرت الحركة بسياسة رد الفعل على أفعال الآخرين. صحيح أني انتُخبت رئيساً للمجلس الوطني لمستقلي 14 آذار، وكان من المفترض أن ينعقد مؤتمر عام في تشرين الأول الماضي، لانتخاب أعضاء إدارة المجلس.. لكن ما حصل في الصيف الماضي، جعلني أؤجل الدعوة إلى أجل غير مسمى، والبحث عن إطار عمل مختلف.
السبب السياسي لهذا “الانسحاب” (إذا صح التعبير)، هو أن شهري آب وأيلول شهدا انهياراً للسياسة، التي باتت موقوفة في قفص الاتهام. وكان هذا بفعل الحراك المدني، الذي تجاوز انقسام 8 و14 آذار، كاشفاً الانفصال بين السياسة والواقع.
* استكمالاً للسؤال الأول، كنت أنت ممن ساهموا في الحدث الذي فرض تحولاً كبيراً في لبنان، بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واندلاع “انتفاضة الاستقلال” (حركة 14 آذار). كيف تنظر اليوم إلى تلك التجربة اللبنانية، التي يصفها البعض بأنها كانت مقدمة “الربيع العربي”، أو أنها “فرصة مهدورة” وحسب؟
– لا شك عندي أن 14 آذار 2005، شكّلت الإشارة الأولى لـ”الربيع العربي”. صور اللبنانيين في ساحة الحرية ملأت شاشات التلفزيون في كل العالم العربي، وبات الناس يتعرفون عليك في الدول العربية من خلال هذه المشاهدة. هذه المتابعة كان لها أثر أساسي في التعرف على قوة الناس وتعبيرهم السلمي والمدني. ففي جانب آخر، كان للحظة 14 آذار وجه عجائبي، شهد العالم العربي مثلها بعد خمس سنوات إثر استشهاد محمد البوعزيزي، إذ كان موت إنسان فرد كافياً لإشعال النار في قسم كبير من العالم العربي، وبات اليمنيون يرددون شعار التونسيين (Degage).
لحظة 14 آذار 2005، باتت بالتأكيد “فرصة ضائعة”، ولن أحمّل الآخرين والمناوئين لها مسؤولية ضياع الفرصة. لم نكن جاهزين لهذا التحول الكبير. وعندما بدأنا نشعر بأن أطرافاً سياسية توظّف هذه الحركة لأغراض حزبية وفئوية ضيقة، لم يعد بوسعنا أن نمنع أو نكبح هذا الأمر. وأريد التذكير بأن سمير قصير كتب مقالته الشهيرة “انتفاضة في الانتفاضة” رفضاً لهذا الانحراف. وفي تلك الأيام، كنا نجتمع مع سمير قصير ونواف سلام ومحمد مطر وفارس سعيد والياس عطالله وحكمت العيد ونصير الأسعد وآخرين، للبحث في كيفية إخراج هذه الحركة من الدوامة السياسية التي برزت قبيل الانتخابات النيابية العام 2005. أذكر أني عدّدت بمحاضرة لي الأخطاء التي وقعنا فيها: العودة إلى السياسات التقليدية، عدم الأخذ بالاعتبار أن 14 آذار فعل الناس وليس الأحزاب، وهي بالتالي ليست جبهة أحزاب، بل هي أول حركة ما بعد انتهاء المنطق الطائفي الذي ساد منذ ستينات القرن الماضي.
ثم لماذا لا أريد تحميل الآخرين مسؤولية إهدار فرصة 2005؟ لأن 14 آذار واجهت أيضاً حملة من الاغتيالات، جعلتنا منذ ذاك العام في موقف صعب جداً. كان الجميع يبحث عن أمن مفقود مع استمرار التهديدات. وكانت وسائل الإعلام تعمم باستمرار ما كان يُسمى “لوائح القتل”. في هكذا ظروف ترهيبية، كان من الصعب جداً القيام بأي مبادرة. وإضافة إلى هذا كله، باتت 14 آذار تراهن على المحكمة الدولية، وكأن هذه المحكمة هي التي ستتولى حل كل المشاكل. لم تتمكن 14 آذار من انتزاع المبادرة السياسية إلا في العام 2007، عندما طرحت الجمع ما بين إنجازين: إنجاز “التحرير” (من الاحتلال الإسرائيلي) وإنجاز “الاستقلال” (من الوصاية السورية). لكن بقيت المبادرة من دون أي جواب من “حزب الله”.
في العام 2008، عقدت الحركة أهم مؤتمر لها في يوم 14 آذار، وطرحت أفكاراً جديدة، لكن أتت أحداث 7 أيار من ذاك العام وأطاحت كل شيء. وآخر “إنجاز” (إذا صحت التسمية) كان الانتصار في الانتخابات النيابية العام 2009. وأيضاً لم تتمكن الحركة من توظيف انتصارها، بسبب المبادرة التي قامت بها السعودية باتجاه سوريا، وما سُمّي “س.س”، التي أدت إلى الدعوة، العام 2010، إلى مؤتمر مصالحة ومسامحة بين اللبنانيين والسوريين، غير أن النظام السوري انقلب على وعوده وأسقط حكومة الرئيس سعد الحريري.
* على ضوء تجربتك في “الحوار المسيحي – الإسلامي” والسينودوس الخاص بلبنان، لماذا عادت سرديات الطوائف وانتصرت على “المراجعات” التي ظهرت في تلك الفترة؟
– هناك لحظة مهمة جداً، هي لحظة ما بعد آذار 2005. الانتفاضة أعادت الأحزاب المسيحية إلى الواجهة، وهي كانت خارج المعادلة السياسية كلياً. التيار العوني كان مضطهداً وزعيمه في المنفى، حزب “القوات اللبنانية” كان محظوراً وقائده في السجن، حزب “الكتائب” كان مصادراً لصالح حليف سوريا كريم بقرادوني. لكن مع عودة هذه الأحزاب المسيحية إلى ممارسة السياسة، أعادونا في لحظة واحدة إلى العام 1990، وكأن شيئاً لم يحدث ولم يتغير طوال 15 عاماً، لتستأنف هذه الأحزاب صراعاتها وضغائنها. وفي خضم تجديد هذه الصراعات، جرى مثلاً البحث عن مقابر جماعية على أوتوستراد “حالات”. كان نبش القبور يتم مجازياً وفعلياً، وعودة عقيمة إلى أجواء “حرب الإلغاء”.
في العام 2006، جرى تنظيم المجمع البطريركي الماروني، بعد سنوات من التحضير، وأصدر وثيقة بالغة الأهمية في المجال السياسي، داعياً المسيحيين إلى العمل على بناء الدولة المدنية على قاعدة “التمييز حتى حدود الفصل بين الدين والدولة”. وهذه الدعوة لم تلق أي تجاوب من قبل السياسيين المسيحيين، إذ ظلوا مهتمين فقط بصراعاتهم على السلطة، بأساليب قائمة أساساً على التهييج الطائفي… إلى أن شهدنا تحولات لم يكن أحد يتوقعها، منها إقدام العماد ميشال عون على توقيع “ورقة التفاهم” مع “حزب الله”، وزيارته إلى سوريا بحجة البحث عن مقبرة مار مارون، ثم إشهار فكرة “حلف الأقليات”، وتالياً الدفاع من هذا المنطلق عن النظام السوري “حامي الأقليات”.
* يؤخذ عليكم في “ثورة الأرز” الأداء السيء في مخاطبة الشيعة اللبنانيين، ثم ازداد الأمر سوءاً بعد حرب تموز 2006، إذ برزت “الشيعية السياسية”، كقوة لا ندّ لها متمثلة أساساً في “حزب الله”، كجهاز عسكري وأمني محترف، له سطوته على المجتمع والدولة. أنت ممن طرحوا إشكالية المواطنة والولاء في الكثير من ورشات التفكير وأوراق العمل والندوات، كيف يمكن “مخاطبة” الشيعة اللبنانيين بغير الفلكلوريات الوطنية؟
– كنا في أيام الجامعة، كيساريين، نتبنى شعار كارل ماركس “يا عمال العالم اتحدوا”. واليوم أرى أن الشعار المناسب هو يا معتدلي لبنان، في كل الطوائف وكل المناطق، اتحدوا.
والمعتدل بنظري هو الذي استخلص دروس الحرب، وأدرك أهمية الوصل مع الآخر المختلف. هذا هو المعتدل، أما المتطرف فهو الذي يعتبر الاختلاف مصدر خطر ينبغي مواجهته. وهذه القاعدة تصلح في لبنان وفي العالم العربي وفي العالم الأوسع. الدعوة المجدية اليوم هي التقاء بين المعتدلين، أولاً لمنع الفتنة المذهبية السنّية – الشيعية، والبحث في تجديد التسوية التاريخية التي رسمها “اتفاق الطائف”.
ودور الشيعة في هذا المجال أساسي، لأن المساهمة الشيعية في الحركة الاستقلالية الأخيرة كان حاسماً، فتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي هو الذي أفسح في المجال لتحريره من الوصاية السورية. وبالطبع، أخطأت 14 آذار عندما بحثت عن تسويات صغيرة مع القوة الشيعية القائمة، متجاهلة المساهمات الشيعية التي مهدت لانتفاضة الاستقلال، وأقرّت بحصرية التمثيل الشيعي للثنائية المعروفة: “حركة أمل” و”حزب الله”.
* في الفترة الأخيرة كررت خوفك على “الصيغة اللبنانية”، وبت تردد كلمة “السلام”، هل السبب هو ما نراه من مظاهر انفراط الشعب اللبناني إلى وحدات اجتماعية متذررة من الصعب تآلفها على المواطنة الواحدة. هل هي حقبة من الإنحطاط للفكرة اللبنانية، أم هي نهايتها التامة؟
– إلحاحي على الدعوة إلى السلام جاء متزامناً مع الأحداث التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في سوريا. الجريمة التي تُرتكب في سوريا، وسكوت المجتمع الدولي عنها، لا بد أن يولد عنفاً متفاقماً في كل المنطقة وصولاً إلى الدول الغربية نفسها. لبنان ليس محصناً ضد هذا العنف لأسباب عديدة، خصوصاً بعدما دخل فريق من اللبنانيين في الحرب الدائرة في سوريا، وبعدما تمّ تهجير مئات الآلاف من الداخل السوري إلى لبنان. أمام هذا الوضع لم يعد للسياسة المحلية أي معنى. فالكلام مثلاً عن قانون انتخاب جديد أو عن أي تفصيل سياسي يصبح في جانب منه سوريالياً. نحن على مسافة عشرات الكيلومترات من حرب عالمية، تشارك فيها كل الدول الكبرى باستثناء الصين، ومعها 40 دولة أخرى. في هكذا حال، ولحماية لبنان يتوجب إنشاء شبكة أمان عنوانها سلام لبنان. وهذه الشبكة لن يشكلها إلا المعتدلون، بالمعنى الذي أشرت إليه سابقاً. كل الأمور الأخرى المتعلقة بالصيغة اللبنانية أو باتفاق الطائف ليست اليوم مواضيع بحث. المهم هو كيف يمكننا بناء جسور بين المعتدلين في لبنان، وبينهم وبين أشباههم في العالم العربي، وبين كل هؤلاء والذين يشبهونهم في الغرب.
أما بخصوص “الفكرة اللبنانية”، فهي قائمة بقوة، خصوصاً مع تداعيات الأحداث الجارية في المنطقة. التجربة اللبنانية هي تجربة “العيش المشترك”، ولم نكن ندرك أهميتها إلى حين بدأنا نكتشف أن لبنان هو البلد الوحيد في العالم حيث يتشارك فيه المسلمون والمسيحيون في إدارة الدولة، وهو الوحيد في العالم الإسلامي الذي يتشارك فيه السنّة والشيعة في إدارة الدولة الواحدة.
اليوم، تبدو الصيغة اللبنانية نموذجاً، ويمكن إعادة تظهيرها في أكثر من مكان، خصوصاً عندما نشهد الصعوبة التي تواجهها المجتمعات الغربية في إدارة التنوع الإثني والديني.
* نشهد اليوم تفككاً واسعاً لـ”الدولة الوطنية”، خصوصاً في المشرق العربي. وإذا كان فشل مشروع “الدولة الوطنية” مديداً وتاريخياً، ما هو المستجد برأيك الذي جعل الفشل انفجارياً إلى هذا الحد؟
– التفكك والفشل اللذان نشهدهما في المنطقة، هو نتيجة انهيار نمط من السلطة، كان يؤمّن الوحدة الداخلية بواسطة القمع، كما النموذج العراقي مع صدام حسين، والنموذج السوري مع حافظ الأسد ووريثه بشار الأسد، والنموذج الليبي مع معمر القذافي. ففي مرحلة امتدت من الخمسينات حتى اليوم، جرى اختزال شعوب بأكملها في أحزاب، وجرى اختزال الأحزاب في قيادة، ثم في شخص واحد. على هذا النحو بات الكلام عن سوريا أنها “سوريا الأسد”، وكأنها ملك شخصي لحافظ الأسد وعائلته. هكذا لم يكن أحد يدرك مدى تنوع هذه المجتمعات إثنياً ودينياً.
العامل الآخر للإنهيار، هو الوسيلة التي استخدمت لإنهاء نظام صدام حسين، التي قضت بإلغاء الدولة، وبالتالي تحويل العراق إلى ساحة صراع لا نهاية له، إضافة إلى فتح الباب لإيران للتمدد حتى البحر المتوسط.
مع ذلك، لا أرى إمكانية لتقسيم المنطقة، لأن التقسيم يعني الدخول في حروب أهلية لا نهاية لها. وأيضا، لا أرى عودة إلى ما قبل الانتفاضة السورية. الحقيقة الوحيدة أن هناك تنوعاً ينبغي أخذه بالاعتبار وصياغة أنظمة حكم تستطيع التأمين بين وحدة المجتمع وإدارة تنوعه. وقد يكون في هذا السياق “اتفاق الطائف” صيغة تساعد على البحث والتفكير.
* من خصومتك لأيديولوجيا اليمين اللبناني، إلى ابتعادك المتأخر عن اليسار اللبناني والعربي، عدا عن غربتك عن الأيديولوجيا القومية والبعثية، وعدم صلتك بما يسمى “الممانعة”.. أين تجد نفسك؟ أو بالأحرى أين نجد أنفسنا؟ أين أنت الآن، خصوصاً أنك ممن خاضوا تجربة النضال مع حركة “فتح” و”الحركة الوطنية”، ثم انتقلت للجلوس إلى يمين البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير مثلاً. هل يعني لك اليسار اليوم شيئاً؟ هل تنحاز إلى صفة “الديموقراطي”؟ هل ترى نفسك في الليبرالية اللبنانية كما تمظهرت مع مشروع رفيق الحريري؟
– خصومتي لما أسميته أيديولوجيا اليمين اللبناني ناجمة عن ذاكرة نضالات طالبية في البداية، ومتابعتي لما جرى في باريس في أيار 1968. وهي أيضاً نابعة من موقف عائلي، فوالدي (حميد فرنجية) لم يكن يوماً من مؤيدي هذا اليمين، وكان على صلة جيدة مع جمال عبد الناصر، وبالتالي لم تلعب الاعتبارات الطائفية في خياراته السياسية أي دور.
هذا في النشأة، أما في الممارسة فهناك حادث جعلني أعيد النظر في تجربتي في “الحركة الوطنية”. هذا الحادث هو اغتيال كمال جنبلاط العام 1977. كانت الصدمة كبيرة، ذلك أن من قام بالاغتيال هو النظام السوري، الذي افترضنا أنه حليف اليسار و”الحركة الوطنية” والمقاومة الفلسطينية. بعد تلك الحادثة، بدأت العمل على إيجاد المخارج من الحرب، فكنت ممن نظّموا أولاً علاقة حوار بين “القوات اللبنانية” ووليد جنبلاط العام 1979. وفي ما بعد، عندما بدأ مسلسل السيارات المفخخة يضرب المنطقتين الغربية والشرقية لبيروت، نظمت بمساعدة مدير مخابرات الجيش اللبناني آنذاك جوني عبده، لقاءات بين أمن “القوات اللبنانية” وأمن حركة “فتح”. وبعد أسابيع من الاجتماعات توقفت هذه الموجة الرهيبة. واستمرت هذه الاجتماعات لمدة شهور، وكان آخرها في 4 حزيران 1982، لحظة قصف الطيران الإسرائيلي للمدينة الرياضية وبدء الاجتياح الشامل والمدمر.
استمرت منعرجات التحول السياسي بعد حرب 1982، إذ تعرفت على رفيق الحريري في تلك الفترة. وفي العام 1987 بدأت المساهمة في إنجاز اتفاق الطائف (كتابة المسودات الأولى). وقد شارك معي في هذا العمل الفضل شلق وآخرون. ومع إقرار اتفاق الطائف، ورفض السوريين الالتزام بمواد محددة، تنص على الانسحاب التدريجي إلى البقاع ثم إلى الحدود، بعد إقرار الإصلاحات الدستورية، بدأت معارضتي العلنية للوجود السوري في لبنان. وعندما ألقيت محاضرة في طرابلس عن ضرورة تنفيذ “الطائف” لجهة الإنسحاب السوري، أقدمت المخابرات السورية على نسف سيارة صديق لي، كرسالة تنبيه وتهديد.
في تلك الحقبة، بدأت مع عدد من الأصدقاء، من بينهم السيد هاني فحص وفارس سعيد ومحمد حسين شمس الدين ورشيد جمالي، العمل على إنشاء إطار للحوار أسميناه “المؤتمر الدائم للحوار اللبناني”، وبدأنا الوصل بين مكونات هذا المجتمع من “المقاومة الإسلامية” في طرابلس إلى أعضاء وعاملين في “القوات اللبنانية” إلى يساريين في الجنوب.. ومن أعمال هذا المؤتمر التمهيد لما صار يُعرف بـ”مصالحة الجبل”. وأيضاً، من أعماله المشاركة في اللقاءات الحوارية المسيحية – الإسلامية، كذلك العمل على إنشاء لقاء “قرنة شهوان”، ثم إتمام مصالحة الجبل في العام 2001. والفكرة المحركة كانت بسيطة: لا يمكننا استعادة سيادة البلد واستقلاله إلا من خلال الوحدة الإسلامية – المسيحية، وهذا ما أجلسني إلى يمين البطريرك صفير الذي “اختبر” البيان الشهير الصادر في أيلول 2000، اختبره معي ومع فارس سعيد.
ماذا بقي من يساريتي بعد كل هذا؟ بقي أمر مهم جداً، هو الحس الاجتماعي الذي يتحكم بكل الخيارات الأخرى.
* لا شك في متابعتك للثورات العربية، كمواطن عربي أولاً وكسياسي ومنظّر. هل تابعت عن كثب ما حدث في مصر وتونس، وما يحدث في اليمن وليبيا، وربما الأهم بينها هو القضية السورية؟ في كل الأحوال، هل حقاً لن نحصد سوى الكوارث من كل ما جرى؟ الدولة الوطنية في العالم العربي انهارت، الإسلام بوجهيه السياسي والفقهي مأزوم، الفكرة القومية تحطمت. ما رأيك بالنموذج التونسي؟ ما الذي تعنيه الفوضى الليبية؟ عودة مصر إلى حكم القائد العسكري؟ انهيار العراق؟ النكبة السورية؟ الفشل اللبناني المديد؟ حرب اليمن؟
– ما حدث مع “الربيع العربي” أمر بالغ الأهمية. للمرة الأولى يكتشف الإنسان العربي فرديته. فهو قبل أن يكون جزءاً من الأمة أو جزءاً من طائفة أو إثنية، هو إنسان فرد، صاحب القرار الذاتي، وله الحق كفرد بالحرية والكرامة والعدالة. هذا الاكتشاف هو بمثابة ثورة فعلية. لم نعد نتكلم بالجمع الاعتباطي، بل نعي كينونتنا كأفراد. وهذه التجربة مرشحة بشكل طبيعي لأن تعترضها صعوبات هائلة ومتعددة الأشكال في كل دول الربيع العربي. لذا، من المبكر جداً الحكم على هذه التجربة، فهي على الأقل أنهت أيديولوجيات تنتمي إلى زمن الأيديولوجيات الشمولية، الذي ولّى منذ زمن طويل في الغرب. وهي أيضاً تفتح ملف الإسلام ودوره في تطوير المجتمعات في مقابل إرث يعمل على توظيف الدين في السياسة. وهي أعادت طرح الخلل القائم في العلاقة بين النظام العالمي الجديد والعالم الإسلامي. وأخيراً، هي تجربة كاشفة لأزمة النظام الرأسمالي، الذي لم يعد يولد سوى فروقات اجتماعية فادحة تمهد الطريق، بالضرورة، إلى العنف.
وأرى أننا نعيش آخر لحظات هذا العالم القديم، الذي فرض نفسه على شعوب المنطقة بالقوة. وظهور عالم جديد ليس أمراً سهلاً، ولكن حتماً سنرى ولادة جديدة لهذا العالم العربي.
* عطفاً على السؤال السابق، كشفت الثورة السورية مشكلة الأقليات والأكثريات والخوف المتجدد بين الجماعات. أنت كمسيحي مشرقي، كيف تفسر هذا المشهد الكارثي؟ ما السبيل إلى “طمأنة” الأقليات و”إنصاف” الأكثريات؟
– لا يجوز، ولا بشكل من الأشكال، تحميل الجماعات وزر ما ارتكبته القوى المتصارعة باسم تلك الطوائف أو الجماعات. المطلوب هو حماية بعضنا البعض، وذلك بنسج علاقات بين الأقليات والأكثريات حمايةً للجميع. ولن تتم طمأنة الأقليات أو إنصاف الأكثريات من خارج شبكة الأمان هذه، التي ينبغي إقامتها بإرادة داخلية. فالدول الخارجية لا ترى هذا الفريق أو ذاك إلا من خلال مصلحة ضيقة واستخدام رخيص للخوف المعمم.
* في مقابل كوارث “الربيع العربي”، هناك من يطرح فكرة “الثورات الصغيرة”، ثورة بالتقسيط، ثورات مطلبية، احتجاجات موضعية بعناوين محددة: البيئة، الفساد، التعليم، محاربة البطالة، الحركات النسوية، الإصلاح القضائي، ..إلخ، هل هذا ممكن وعملي وأجدى؟ هل بشائرها هي الحراك اللبناني الأخير؟
– من نتائج “الربيع العربي” هو استنهاض ما سمي “المجتمع المدني” ودفعه إلى القيام بمبادرات متنوعة. يمكن ذكر المسألة المتعلقة بالزواج المدني، وحركة حقوق المرأة، ورفض العنف أو الإقتتال.. هذه التحركات تمهد الطريق لتحول أساسي، هو تغيير النظرة إلى السياسة. فالسياسة بمفهومها التقليدي، كتعبير عن صراع على السلطة، وصلت إلى نهايتها. وهذا التغيير نابع أساساً من وعي الإنسان بأنه ليس فقط عضواً في جماعة يحدد خياراتها حزب لم يستشره، بل هو فرد حرّ له كل الحقوق. وهذا الفرد بات يدرك تمام الإدراك أهمية العلاقة مع الآخر، في حين أن الأحزاب لا تزال تعتبر الآخر المختلف عدواً ينبغي إزالته. لم يعد بمقدور السياسة السائدة تقديم الأجوبة المقنِعة للمواطنين، فكيف يمكننا إقناع اللبنانيين بأن غياب الكهرباء أمر طبيعي في هذا الزمن؟!
* في الحراك المدني اللبناني أيضاً: معظم النخبة الثقافية انتقلت من الحماسة إلى الحذر إلى النقد، ثم إلى الاختلاف وربما الإحباط. هل هي مسألة سوء تفاهم بين الأجيال؟ هل هي مسألة الغموض السياسي أو حتى التناقضات السياسية بين جماعات الحراك؟
– فوجئ جيلي بهذا الحراك، لأنه لم يعتبر يوماً التحرك على قاعدة مطلب محدد، كجمع النفايات، يعني الناس في حياتهم اليومية، ويحركهم سياسياً.. لأننا أتينا من مدارس وتجارب سياسية مختلفة جداً. أما الانتقاد الذي يُوجّه لهذا الحراك بأنه ليس حاملاً لمشروع سياسي متكامل، فهو يكشف جهلاً بالطبيعة الجديدة لهذا الحراك. وبهذا المعنى، كل من شارك أو تابع أو تضامن مع هذا الحراك، طرح على نفسه سؤالاً قد يشكل المدخل للتغيير المطلوب: ماذا بعد نهاية “السياسة”؟
* لو عدت عشر سنوات إلى الوراء.. ما الأفكار أو الأفعال التي أقدمت عليها أو وافقت عليها، تود لو لم تقبل بها أو تتبناها؟
– من الصعب جداً الإجابة. لكن باختصار، علينا جميعاً أن نتصارح مع أنفسنا ومع ماضينا لكي نتمكن من رسم معالم مستقبلنا.