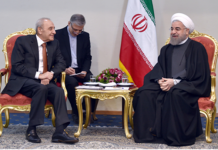جعجع ينكفىء: الحلفاء اجبروني
منير الربيع/المدن/السبت 21/11/2015
لم تكن شخصية رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، تحتاج إلى بحث معمق، فهي شديدة الوضوح، حين يخاصم يذهب حتى النهاية، وحين يحالف يتمسك بتحالفه إلى الآخر، هذه الشخصية ميزت جعجع عن نظرائه، وأبعدته عن الدخول في تسويات، وادخلته الى السجن. مؤخراً، بعض المتغيرات تطرأ لدى جعجع، يتعاطى بواقعية أكثر، ومن منظور مسيحي بعد أن كان يتعاطى في السنوات الأخيرة مع الأمور السياسية من منظور أبعد. من قانون “اللقاء الأرثوذكسي”، إلى “إعلان النوايا” والعمل مع “التيار الوطني الحر” لصياغة قانون إنتخابي يوفر صحة التمثيل لدى المسيحيين، وصولاً إلى إستعادة الجنسية، ومؤخراً موقفه من تهميش رئيس جهاز أمن الدولة عن الإجتماعات الأمنية في السراي، وهو ما يعني ان نغمة جديدة قدمها لدى جعجع، توحي وكأنه عاد إلى الإنحسار ما بين كفرشيما والمدفون. تعتبر مصادر “القوات” أن حلفاء جعجع أجبروه على ذلك، غياب الحريري ومعاناته المالية وترك جعجع في الميدان وحيداً، أحد أسباب ذلك، إضافة الى هجوم النائب وليد جنبلاط المستمر على جعجع وطروحاته، وتغريد حزب “الكتائب” خارج السرب مراراً وتكراراً، ما يعتبره جعجع خروجاً عن السياق وتقديم أوراق الإعتماد لحزب الله، كل ذلك دفع بجعجع إلى تحصين نفسه سياسياً، وتعزيز موقعه المسيحي، خصوصاً أنه باتفاقه مع عون يحصل على شرعية مسيحية يطمح إلى تحقيقها منذ زمن، ولم يعطه إياها حليفه الأساسي تيار “المستقبل”، والخلاف يبدأ من الإنتخابات النيابية، ومن عدد النواب الذي يرشّحه جعجع للوصول إلى الندوة البرلمانية. ليس جعجع وحده من يتخذ خيار الإنكفاء وعدم الدخول في الحسابات الأطراف الإسلامية، سبقه عون في إدعاء التمثيل المسيحي والحفاظ على حقوق المسيحيين، وكذلك حزب “الكتائب”. وهم لم يعودوا يعتبرون أن هذا الأمر مدعاة خوف خصوصاً في هذه المرحلة، بل هو واجب لحماية الوجود. وفق ما توصف مصادر “المدن” لواقع الحال المسيحي الجديد، لا سيما أنه يختصر في نهج الأحزاب المسيحية الأبرز، أي “القوات” و”التيار” و”الكتائب”، فإنهم على ما يبدو قد وصلوا إلى قناعة مغايرة لقناعة الميثاق والعيش المشترك وما إلى هنالك، من هذه الطروحات التي لم يتحقق منها شيء بالنسبة إليهم، ولذلك أصبحوا في اعتبار أن حلم البطريرك الياس بطرس الحويك هو وهم غير قابل للتحقق لا على صعيد لبنان الكبير ولا على صعيد المواطنة والعيش المشترك. وبالتالي فلا بد من العودة إلى النغمة السابقة، وهي قد تكون على شاكلة إما لا مركزية موسعة، أو فيدرالية. وهنا تجدر العودة بالذاكرة إلى إحدى الطرائف المنقولة عن الرئيس الراحل كميل شمعون، إذ يقول أحد الصحافيين في حقبة الثمانينيات من آل الحويك لـ”المدن” إنه خلال إجتماعات الجبهة اللبنانية في المنطقة الشرقية، كان شمعون كلما التقى هذا الصحافي، يشتم البطريرك الحويك، فما كان من الزميل الرد على شمعون بسؤاله لماذا؟ والحويك هو أحد أبرز المؤثرين في تكوين لبنان الكبير، ليأتي جواب شمعون سريعاً: “بقي البطريرك الحويك يطالب بتوسيع لبنان وضمّه للمسيحيين والمسلمين، وها هم المسلمون اليوم يقصفوننا، لو بقي لبنان صغيراً لكان أفضل”. ليست خيارات جعجع جديدة، بل الآن آخذة في التوسع، وهي عملياً تعود إلى العام 2011 في حينها اتخذ جعجع هذا الخيار، منذ دعمه لاقتراح القانون الأرثوذكسي، وفق ما تشير مصادر المستقبل لـ”المدن”، في ذلك الوقت بحسب المصادر، كان جعجع يعتبر أن المنطقة ستذهب باتجاه الفيدراليات، وستقسم على أسس مذهبية، وطائفية. ولكن بعدها تراجع جعجع عن وجهة نظره هذه، وكرّس ذلك بانفتاحه على المعارضة السورية، وحيّا الربيع العربي، إلا أنه مع بروز تنظيم داعش وتوسعه عاد إلى وجهة نظره. يحمّل المستقبل نفسه جزءا من المسؤولية، فجعجع تعرض الى نكسات عديدة من قبل المستقبل، ففي العام 2009 أثناء التحضير للانتخابات النيابية، طالب جعجع بزيادة عدد نوابه، إلا أن المستقبل رفض ذلك، ولم يعطه ما يريد، بذريعة أن التيار الأزرق عابر للطوائف ولا يمكن أن يخسر نواباً مسيحيين لحساب القوات، ولا تستثني مصادر المستقبل “ذهاب الحريري إلى سوريا، ودخوله في لعبة السين السين، من دون سؤال جعجع حينها، ولا حتى مشاورته، ولا على الأقل وضعه في الصورة، فبقي جعجع يغرد خارج السرب”.
من نصرالله إلى مجلس الأمن
الـيـاس الزغـبـي/21 تشرين الثاني/15
لا يسع المراقب أن يتجاهل النقلة النوعيّة في الخطاب السياسي للسيّد حسن نصرالله، وما سُمّي “مبادرة” في إطلالتيه الأخيرتين قبل تفجيريّ برج البراجنة وبعدهما. وما يضاعف الاهتمام بهذا الخطاب هو اعتماده لغة الشرعيّات الثلاث اللبنانيّة والعربيّة والدوليّة، بعد طول عداء وجفاء، وبعد اعتماد لغة الحرب والكسر والغلبة على مدى عقد من الزمن، على الأقلّ. فالشرعيّة اللبنانيّة، منذ الاستقلال، تفرض الأخذ بمبدأ التطوير أو التغيير السلمي بالآليّات المدنيّة والديمقراطيّة وليس بقوّة السلاح والثورة والانقلاب، كما جرّب “حزب الله” مراراً. والشرعيّتان العربيّة والدوليّة تدعوان بإلحاح إلى تطبيق الدستور اللبناني واتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصّة بلبنان، وتحضّان دائماً مجلس النوّاب والقيادات السياسيّة على إحياء المؤسّسات الدستوريّة بدءاً بانتخاب رئيس للجمهوريّة كأولويّة لا بدّ منها. وقد كان البيان الأخير الصادر قبل يومين عن مجلس الأمن شديد البلاغة والوضوح، بحيث يمكن اعتباره خريطة طريق حاسمة للخروج من الأزمة اللبنانيّة. وبات من الضروري تلمّس مدى التحوّل الإيجابي في خطاب نصرالله، ومن ورائه إيران، نحو هذه الثوابت اللبنانيّة العربيّة الدوليّة، وما يجوز وصفه بـ”إعادة اللبننة”. فعلى هذه الثوابت التي تضمّنتها الخريطة الأُمميّة يجب قياس “المبادرة الإيرانيّة” على لسان الأمين العام لـ”حزب الله”، وليس على أيّ شيء آخر.
فهل الدعوة التي أطلقها إلى تسوية سياسيّة شاملة تعي هذه الأصول فعلاً، أم أنّها تُضمر في طيّاتها غايات أُخرى طالما أفصح عنها مواربةً أو مباشرةً، ومنها نسف الطائف بما فيه من توازنات ومناصفة وتغيير أسس الميثاق والصيغة التاريخيّين؟ أم أنّها مجرّد ورقة إلهاء في الزمن الضائع لتقطيع فترة ما قبل المرحلة الانتقاليّة في سوريّا والمنطقة، والتي ما زالت غامضة على طاولة فيينا؟ ا شكّ في أنّ “المبادرة” تفتح على الأقلّ بداية نقاش لسبر غورها وحقيقتها، وقد بدأ النقاش فعلاً ولو من باب التصريحات عن بعد، قبل أن ينتقل إلى الحوارات الثنائيّة والجماعيّة. وتحليل دوافع “المبادرة” وخلفيّاتها، سواء كانت ناتجة عن الاستدراك المسبق للحلّ في سوريّا، أو الإنهاك الذي حلّ بـ”حزب الله” والتمهيد للانسحاب أو أيّ حسابات أُخرى، لا يُنقص ولا يزيد في مدى صدقيّتها أو هوائيّتها. ولكنّ التأسيس عليها ضروري، لأنّها تقطع مع مسار صدامي طويل. ويكفي أنّها تعتمد منطق التسوية المرادف لمعنى وجود لبنان. وفي المنطق أنّ كلّ تسوية تعني تنازلات متبادلة للإلتقاء في الوسط. والوسط يعني التخلّي عن طرفَي الأزمة. وهذا يتجلّى حكماً في موقع رئاسة الجمهوريّة. فلا يُعقل أن يدعو نصرالله إلى تسوية سياسيّة ويريد في الوقت نفسه فرض مرشّحه للرئاسة. ولعلّه يدرك جيّداً استحالة التسوية حول ميشال عون، وصعوبة تخلّيه عنه في الوقت نفسه، فأوعز مباشرةً وعبر دمشق وطهران بتقرّب سليمان فرنجيّة من سعد الحريري، في عمليّة مشابهة لتقرّب عون سابقاً، على قاعدة “المكان يعُيد نفسه”، أي باريس لمثل هذه اللقاءات. والهدف ليس تسويق فرنجيّة عند الحريري والسعوديّة، فهذه مسألة شبه مستحيلة بفعل التصاق الأوّل بالأسد. ولا يُعقل أن يأتي رئيس ذاهب برئيس آتٍ، إلاّ في حالة الانفكاك السياسي الفعلي عن رئيس يبحثون له عن حماية أو منفى، أو دور ثانوي في أفضل الأحوال. الأرجح أن الإيعاز لفرنجيّة بالانفتاح على الحريري ينطلق من الرغبة في وضعه أمام عون كحالتين متصادمتين ضمن الفريق الواحد، فيكون المخرج باستبعادهما معاً، وتكون إذذاك “تسوية” نصرالله قد بدأ تطبيقها العملي بمرشّح توافقي. فلا غرابة في أن تكون معادلة عون – فرنجيّة مفتعلة لتأمين خروج “حزب الله” من “مأزقه الرئاسي”. وفرادة لبنان أنّه يبقى مختبراً إنسانيّاً عالميّاً، يستطيع تذويب أقسى الأجسام وأعتاها كـ”حزب الله” وسواه، بشهادة الأُمم في مجلس الأمن. وها هي مواقف الحزب العقائدي الديني الحديدي تبدأ بالتحلّل والترهّل أمام حقائق لبنان والعرب والعالم، ولو بمفردات اللغة والعودة إلى نهج التسوية. وهكذا يكون نصرالله قد بدأ يعترف بالشرعيّة الثلاثيّة فوق “شريعته” الأحاديّة.
النظام بلا رأسه والمعارضة بلا نصرها
حازم الامين/الحياة/22 تشرين الثاني/15
على العالم أن يختار في حربه على «داعش» بين تنازل أمني وتنازلٍ أخلاقي! هذا على الأقل ما تعرضه عليه موسكو عقب هجمات باريس الدامية. ويتمثل التنازل الأمني في جدولة الحرب وتدرجها، بدءاً من إسقاط النظام في سورية وصولاً إلى القضاء على «داعش»، والتنازل هنا يتمثل في إطالة أمد الحرب والتعامل مع المزيد من تعقيداتها. أما التنازل الأخلاقي فيتمثل في التعامل مع بشار الأسد كأمر واقع، على أن يترافق ذلك مع انقضاض دولي على «داعش» يُقدم عليه تحالف يضم إلى موسكو وواشنطن وباريس، طهران و «حزب الله» والنظام في سورية.
يمـــيل كثيرون إلى القول إن العالم سيختـــار التـــنازل الأخـــلاقـــي، وأن بشار الأسد لم يعد أولوية، وأن بقاءه ضعيفاً يؤدي وظائف ما زال العالم في حاجة إليها. أمن إسرائيل ومصالح موسكو ونفوذ إيران المشرقي، هذه كلها يؤمنها نظام ضعيف في سورية ما بعد «داعش».
أما الغرب فيمكنه أن يتعايش مع بشار على نحو ما تعايش مع صدام حسين ما بين 1990 و2003! وهذه مقولة سائدة ويتم الترويج لها في الكثير من الأروقة.
لكن بغض النظر عن قدرة أصحاب هذه الفكرة على تسويقها، وهم وجدوا في أحداث باريس قوة دفع لنظريتهم، لا بد من الإشارة إلى أن الخوض فيها لا ينطوي على تنازل أخلاقي فقط، بل ثمة عقد واقعية تحول دونها.
ما هي القوة البرية التي ستملأ الفراغ الذي سيخلفه «داعش» بعــــد دحره؟ ونحن هنا نتحدث عن أكثـــــرـ من ثلث مساحة سورية. النظام السوري؟ مـــــن السذاجـــة طبعاً الاعتقاد بذلك: ذاك أن النظام وحلفاءه الإيرانيين واللبنانيين كانت هزائمهم الميدانية في الكثير من المواقع قد أخذت شكل انكفاءات غير ناتجة عن هزائم عسكرية، إنما عن نقص بشري وضعف في البنى العسكرية.
ثم إن هزيمة «داعش» من دون حليف سني محلي وإقليمي ستكون تأسيساً لشروط إعادة إنتاج «داعش» موازٍ، وبقاء بشار في السلطة يعني ذلك حرفياً. فلن يجد التحالف الدولي قوة سنية تقف إلى جانبه في حربه على «داعش» طالما كان عنوان هذه الحرب «بقاء بشار الأسد». ثم إن نصراً مذهبياً على «داعش» هو انتصار له، والحرب على «داعش» من دون السنة ستنطوي على عمق مذهبي يُدركه الغرب تماماً كما تُدركه موسكو وطهران، وهؤلاء كلهم اختبروا الفشل الكبير في العراق، وسيكون تكراره في سورية ضرباً من الغباء.
في سورية، لا تستطيع طهران أن تُكرر خبرتها العراقية المتمثلة في أن «داعش» مشكلة السنة العراقيين، وأن تنكفئ بقواها العراقية إلى حدود المناطق الشيعية. الانكفاء عن المناطق السنية في سورية انكفاء عن سورية، وجبال العلويين لا تكفي لبناء دولة، فيما مدن الساحل لا يتمتع فيها العلويون بغلبة، ودمشق، معقل النظام، محاصرة من ريفها، ومن جنوبها وغربها.
وموسكو بدورها تُدرك أن حرباً جوية على «داعش» من دون قوة محلية لن تكون أكثر من تكرارٍ للحرب الجوية التي تخوضها الولايات المتحدة منذ نحو سنتين على «داعش» من دون نتائج فعلية.
سيكون البحث عن تسوية في سورية تُسهل القضاء على «داعش» من دون البحث في مصير بشار الأسد غير مجدٍ، والأرجح أن هذه قناعة الجميع، ويبقى السؤال في كيفية مغادرة بشار وبقاء النظام، بما يؤمن لجميع القوى الإقليمية بما فيها طهران مصالحها؟
أما الصعوبة الثانية، فتتمثل أيضاً في الشريك المعارض. ما هي القوة السورية المعارضة التي ستُجري التسوية؟ ذاك أن التسوية من دون بشار تقتضي شريكاً، وتقتضي أيضاً تنازلات موازية. معارضة منسجمة تقبل ببقاء النظام، مع ما يجره ذلك من بقاء لرموز منه. ثم إن قطاعات واسعة من المعارضة المسلحة لن تجد مكاناً لها في هذه التسوية، كـ «جيش الفتح» مثلاً المنضوية فيه «جبهة النصرة» و «أحرار الشام». وهذه القوى ستكون جزءاً من هموم الشريك المعارض، وجزءاً من مهماته الواقعية. فالنظام المُحَافَظ عليه لن يقوى على تحديد قواه وأطره الجديدة من دون مده بشرعية جديدة مكتسبة من قوى معارضة طرحت على نفسها تسوية لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال.
ولعل ما هو مطروح على السوريين في لحظة التسوية، لم يسبق أن طُرح على مجتمع مشرقي مـــن مجـــتمعات الحروب الأهلية. معادلة التسوية تقتضي من أهل النظام أن يتحولوا إلى شركاء فيه من دون رأسهم، ومن معارضي النظام أن يقبلوا به وأن يندمجوا في مؤسساته، مع ما يعني ذلك من ابتلاع لخُطب النصر والحق والغلبة.
صعوبات هائلة تنتظر التسوية السورية، لكن لا سبيل للانتصار على «داعش» من دونها. ولا يبدو أن عامل الوقت مساعد على هذا الصعيد، ولهذا ستتكشف الأيام والأسابيع القريبة عن جهد دولي حقيقي في هذا الاتجاه. ولعل مسارعة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى تحديد أسابيع لمباشرة المفاوضات الجدية في شأن سورية ليست المؤشر الوحيد على ذلك، فمسارعة الرياض للإعلان عن استضافة أطراف المعارضة السياسية لتشكيل وفد منسجم إلى فيينا مؤشر آخر، وربما كانت هدنة الغوطة الشرقية في دمشق تمريناً على هُدن موازية ومُرافقة لعملية المفاوضة.
الحديث عن أن القضاء على «داعش» تحول إلى أولوية غربية تتقدم الرغبة في البحث عن مستقبل النظام في سورية صحيح من دون شك، خصوصاً في ظل معادلة التنازل الأخلاقي في مقابـــل التنازل الأمني، فالغرب يُقدم أمنه على قيمه. لكن الذهاب إلى الحرب على «داعش» من دون أن تكون التسوية في سورية خطت خطوتها الأولى سيكون تكراراً لأخطاء حصلت في أفغانستان وفي العراق، ناهيك بأن المساهمة الغربية في الحرب هذه المرة لن تكون برية، وسيكون من الجنون تعويض المشاركة البرية بجيش النظام السوري وحلفائه في المذهب وفي الإقليم.
يبدو أن لدى السوريين الآن فرصة، وهذه لحظة التنازلات المؤلمة. أما القضاء على «داعش» فمن المرجح أن يكون مهمة تتعدى سورية.