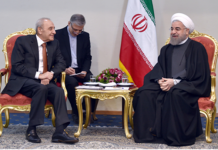سياسة أوباما في الشرق الأوسط.. نعي يتلوه جون كيري
أمير طاهري/الشرق الأوسط/20 تشرين الثاني/15
عندما جاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري في إحدى الأمسيات بمدينة نيويورك لكي يتحدث عن السياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما، ظن الجميع أنه قدم ليثني عليها. لكن بعد مرور ساعة وإلقاء 6 آلاف كلمة، أصبح من الواضح أنه جاء لكي يدفنها. لقد تحول المديح المتوقع إلى نعي غير مقصود.
كيري استهل كلمته ببناء صرح من الحجج والأعذار لما كان يعلم، لكن لا يريد الاعتراف به، أنه فشل من العيار الثقيل. ولكي يسلط الضوء على سيرته الشخصية، أبلغ كيري الحضور أنه تناول العشاء لتوه مع هنري كيسنجر الذي أقر بأن العالم اليوم أكثر تعقيدًا مما كان عليه في الأيام الخوالي الطيبة.
وقال كيري مشددًا على كلامه إن كيسنجر «لم يجابه هذا العدد من الأماكن والأزمات المختلفة» التي يتعين على وزير الخارجية الحالي أن يواجهها. ويضيف أنه في «عالم الحرب الباردة ثنائي القطب، كان الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة والغرب واضحين تماما إزاء الخيارات المتاحة». ويتابع كيري بأن عالم اليوم «متعدد الأقطاب» مما يجعل الخيار صعبًا، بيد أنه من الناحية اللغوية يعتبر مصطلح «متعدد الأقطاب» من قبيل الاستنباط الذي لا يتفق منطقيًا مع المقدمات، لا يوجد نظام يمكن أن يحتوي على أكثر من قطبين. لكن بما أننا نستخدم اللغة غير آبهين بالحيرة والارتباك الذي يمكن أن تحدثه ألفاظنا، فلا تلقوا بالاً للأمر. وبدأ كيري كلامه بمحاولة إثبات أن واشنطن ما زالت مهتمة بمنطقة الشرق الأوسط، وقال في هذا الصدد: «ينبغي أن نتذكر أن الشرق الأوسط يضم بعضا من أقدم أصدقاء أميركا، بما في ذلك حليفتنا إسرائيل، ولكن أيضًا الكثير من الشركاء العرب». ويعني ذلك أنه بينما تعتبر إسرائيل «حليفة»، فالعرب مجرد «شركاء». ورغم ذلك، لا تعامل إسرائيل كدولة حليفة ولا العرب كشركاء. وبعد يومين من بداية ولايته الرئاسية الأولى، عين أوباما السيناتور جورج ميتشل كمبعوث سلام للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، كما تباهى أيضًا بأنه «عندما نلتقي العام المقبل» ستكون هناك دولتان: واحدة إسرائيلية والثانية فلسطينية.
لكن بعد مرور 7 سنوات، يقدم كيري نسخة مقتضبة جدًا من طموح أوباما. إن الهدف السامي المتمثل في إنشاء دولتين لا يأتي على ذكره إطلاقًا. ويقول عوضًا عن ذلك: «نحاول أن نقلص العنف… حول الحرم الشريف في القدس».
إن المهندس المعماري الطموح تنازل إلى مستوى رجل إطفاء يحاول إخماد ألسنة اللهب، ودون أن يدرك النجاح حتى الآن. أما بالنسبة إلى «الشركاء العرب»، فلم يعد هناك حديث عن الخطط الكبرى الرامية إلى العضوية المنتسبة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتفاقات الجماعية للتجارة والتبادل التقني. إن ما يعرضه كيري ما هو إلا شعر متواضع المستوى. ويقول: «تخيلوا مستقبلاً يستطيع فيه الناس من النيل إلى نهر الأردن إلى الفرات أن يعيشوا ويعملوا ويسافروا بحرية وكيفما شاءوا، مستقبلاً يحصل فيه كل صبي وفتى على تعليم جيد، مستقبلاً يستطيع فيه الزوار أن يأتوا من دون خوف».
حسنًا، الخيال لا يكلف شيئًا (وبالمناسبة، على المرء أن يتساءل: لماذا يتوقف عالم كيري التخيلي عند الفرات؟ هل يعني ذلك أنه لا ينبغي أن يذهب أحد إلى بغداد على نهر دجلة؟). على أي حال، ما الذي تفعله إدارة أوباما لكي تحقق هذه اليوتوبيا؟
إجابة كيري تتلخص في التالي: «طلبنا من شركة ماكينزي أن تدرس آفاق الاقتصاد في الأردن وسوريا وإسرائيل ومصر والضفة الغربية. ما يثير الاهتمام أن صديقي العزيز وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد، طلب مؤخرًا أيضًا إعداد دراسة منفصلة «لكي يراجع» كل القطاعات بدءا من الزراعة وحتى السياحة». أي أن الولايات المتحدة تشتري دراسات تسويقية بدلاً من أن تطور سياسة خارجية في الوقت الذي تشتعل فيه الحرائق بالمنطقة. لكن الموقف الهزلي لا يتوقف عن ذلك الحد.
ويواصل كيري ليكتب منشورًا دعائيًا مصغرًا حول المعالم السياحية الجاذبة في المنطقة. ويقول: «أعني، فكروا في أعظم المعالم السياحية بالعالم. لقد زرتها… المكان الذي عمد فيه يوحنا المعمدان أناسًا كثيرين بما في ذلك السيد المسيح، المعبد القريب منه، وأحد أقدم المساجد في المنطقة… الجميع لديه شيء هناك، حتى الملحد إذا كان مهندسًا معماريًا ناشئًا لن يجد صعوبة في قضاء وقت ممتع هناك». هل هناك أي مقترحات ولو على الأقل عن إعادة إطلاق «محادثات السلام» بين إسرائيل والفلسطينيين؟ لا يوجد. إذن ماذا عن أي أفكار حول سبل إنهاء المأساة السورية؟ لا يوجد. ماذا عن سياسة لهزيمة وتدمير «داعش» التي تعهد بها أوباما قبل 18 شهرًا؟ إجابة كيري كانت: «رأينا أن الأفكار التي يبثها الإرهابيون في الرقة والموصل يمكن أن تصل إلى عقول البسطاء في مينيابوليس وميسيسبي. نحن ندرك تمامًا أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر على التصورات في جميع القارات لأن الناس يتأثرون بالتقاليد الروحية والأخلاقية التي تعود جذورها إلى تلك الأراضي القديمة». إذن، هل يمثل «داعش» تقاليد «روحية وأخلاقية»؟ حسنًا. لكن ماذا تنوي أن تفعل إزاء ذلك؟ لا يمتلك أوباما جوابًا.
لقد وعد أوباما بأن يدمر «داعش»، بيد أنه هذه هي إنجازات الإدارة الأميركية حتى الآن التي يوردها كيري: «لقد شننا أكثر من 7300 غارة جوية. أجبرنا (داعش) على أساليب تنفيذها للعمليات العسكرية… أمنا الحدود التركية – السورية شرق الفرات التي تمثل 85 في المائة من الحدود التركية. الرئيس يجيز أنشطة أخرى لتأمين المساحة المتبقية… صعبنا من مهمة (داعش) في إعادة تزويد مقاتليها في الرمادي بالمؤن». لكن كيري أمضى بعض الوقت في التباهي بـ«اتفاق» أوباما مع إيران بوصفه إنجاز الإدارة الوحيد في الشرق الأوسط. ولذلك قال أوباما في 2008: «لا يمكننا السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي… سأبذل كل ما في وسعي لمنع ذلك»، بيد أن إيران تحتفظ، بموجب «الاتفاق» الذي يتباهى به، بقدرتها كاملة على إنتاج ترسانة نووية في غضون عام واحد. وحتى مع ذلك، لم توقع إيران على أي شيء وترفض إقرار «الاتفاق» عبر آلياتها القانونية.
إن النجاح الوحيد الذي يورده كيري لا علاقة له على الإطلاق بالولايات المتحدة. «وبالنسبة إلى المتشككين، سأرد بكلمة واحدة: تونس».
إن تونس تبلي بلاء حسنًا إلى حد كبير في الوقت الراهن، لكن ما علاقة ذلك بأوباما؟ إن نعي كيري لسياسة أوباما في الشرق الأوسط زاخر بالجواهر. إليكم القليل منها:
• «الإسرائيليون ينبغي أن يحظوا بالأمن، الفلسطينيون ينبغي أن يحظوا بالأمن، الناس في غزة ينبغي أن يحظوا بالأمن، الجميع ينبغي أن يحظوا بالأمن».
• «العنف يؤذي الجميع: الأبرياء وعائلاتهم، اليهود والسكان العرب في إسرائيل…يؤذي الجميع».
• «في العراق، يعرض (داعش) النساء والفتيات في المزاد العلني، ويعلم الناس أن اغتصاب الإناث غير المسلمات هو شكل من أشكال العبادة».
• «الرئيس أوضح بما لا يدع مجالاً للشك أننا مصممون على تفكيك (داعش) على نحو أكثر سرعة».
• أرجوكم لا تتقبلوا رؤية القائلين بأنه ينبغي تقسيم الشرق الأوسط على أسس طائفية».
• «علينا جميعًا أن نبذل المزيد، لأن الناس بدأوا ببساطة يفقدون الإيمان بأي من زعمائهم».
بدأوا فحسب؟!
لبنان والعراق و… انطفاء «الثورات» الباردة
رستم محمود/الحياة/20 تشرين الثاني/15
أسبوعاً بعد آخر، تبدو التظاهرات التي كانت «تجتاح» مُدن العراق كُل جمعة وكأنها لم تعد كما كانت بصخبها وخطابها وآمالها. تغدو أشبه بمُمارسة فولكلورية لبعض شُبان الطبقة الوسطى المدنيين. وكأن الإجراءات التقشُفية والإدارية الشكلية، التي أقدم عليها رئيس الوزراء حيدر العبادي، أقنعت القاعدة الأوسع من المتظاهرين، وأن رجال الفساد الفظيع ونُخبة الحُكم الطائفية، الموالية بغالبيتها لدول إقليمية شتى، وهوية العراق السياسية/الكيانية المُحطمة، ومعها الانشقاق الوطني الحاد وسلطة زُعماء المافيات والميليشيات…، لم تعد تشحذ أية همة للاستمرار بما بدأوا به. مثل الشُبان العراقيين المُنتفضين حال أقرانهم اللبنانيين. فمن تظاهرة مدنية جمعت آلاف المُتحدرين من حساسيات جهوية ومذهبية وطبقية شتى، وربما متباينة ومتخالفة، ممن يجمعهم حسٌ مدني باهتراء السُلطة الحاكمة، التي لم تعُد تستطيع أن تُنفذ حتى أصغر مهماتها الخدمية، بات الحراك اليوم مُنقسماً على نفسه، وغارقاً في تفاصيل وحزازات شخصية وتكتُلية، من دون برنامج وطروحات ورؤية واضحة لما هو مطلوب، وطبعاً من دون قدرة على تحريض المزيد من الكُتل الاجتماعية للانضمام إلى الحراك. ما كان يجمع الحراكين العِراقي واللبناني ليس فقط طبيعتهما غير الصِدامية وغير الصفرية مع السُلطات الحاكمة، على ما كانته باقي «الثورات» العربية. بل أيضاً خصائص في بنيتيهما، أهلتهما لهذا الانطفاء»، من دون أن تُحققا ما كانتا تتأملانه في البلدين، وإن في شكل نسبي. فهما كانتا، على عكس كُل البُلدان العربية الأُخرى، انتفاضة الأقلية السياسية والأهلية ضد الغالبية الحاكمة. بقول آخر، كانتا حراك الطبقة المدنيّة الوسطى العُليا، ضد سُلطة تستمد قوتها وشرعيتها في شكل ما من الطبقات الشعبية الأكثر عدداً والأقوى. وهو يشبه ما كان يرمي إليه مانديلا يوماً في سجنه وتحقق، وما سعى أوجلان بعد سنوات الى تقليده، لكنه فشل. فمانديلا في آخر الأمر كان زعيماً للغالبية الجنوب أفريقية السوداء، بينما يبقى أوجلان زعيماً للأقلية الكُردية في تُركيا.
على هذا فالمنتفضون في البلدين واجهوا نِظامين يرتكزان على شرعية انتخابية وتمثيل شعبي معقول، يصعب معه توجيه أية ضربة قاسية للنظام عبر هبّة شعبية استثنائية. من جِهة أُخرى، فقضايا الثورات اختلفت عن المطالب المدنية التي للحراكين اللبناني والعُراقي. فالقضايا الكبرى أغرت الملايين من الطبقات الشعبية في بلدان الربيع العربي بسهولة بالغة، وشكلت مُحرضاً ومصدراً للإغراء من دون حاجة للتصميم والمؤسسات والانتظام والتوجيه. لقد كانت قضايا أقرب ما تكون للفعل الآدمي الغريزي المحض. في الحالتين اللبنانية والعراقية، كانت تتعلق بتحديث المؤسسات وتطويرها، ومطالبة بخلق آليات أكثر تطوراً في اجتراح السُلطة الحاكمة وأدواتها، وأكثر ميلاً لفك الوسائل والأجهزة التي صنعتها شبكة السُلطة الفظيعة للزبائنية الشعبية وشراء ولاءات النُخب الخ… من المطالب المُركبة والمؤسساتية والمُجردة والتي لا تلقى إغراء مباشراً للقواعد الاجتماعية الأكثر هامشية. لكل ذلك فهي لم تتمكن من جذب وتحريض الطبقات المُتضررة من السُلطة الحاكمة في البلدين. أخيراً فهذان الحِراكان اندلعا في دولتين تستند السُلطة فيهما الى بُنى أهلية بعينها، وفي شكل صريح وواضح. وتستطيع هذه السُلطة بكل سهولة أن تُلبس أي حراك مُناهض لها ثوب المُناهضة لهذه البُنية الاجتماعية/الأهلية أو تلك. فمثلما أفشلت السُلطة العراقية التظاهرات الأولى قبل ثلاثة أعوام، واعتبرتها مُمثلة للتيارات السُنية «المُتشددة» المناهضة للعملية السياسية، وأنها بالتالي ثورة مُناهضة للعراقيين الشيعة، فقد اعتبرت الحِراك الأخير مناهضاً للطبقات المحافظة الموالية لإيران وحُكم رجال الدين، وأظهرته مُعادياً لآلاف العراقيين المُحافظين. على منوالهما فعلت «السُلطة اللبنانية» (إذا كان يصحُ هذا التعبير) فنزّهت بعض الزعامات عن كل نقد أو مُناهضة، وفُرز الحراك بوصفه مُضاداً لزعامات لبنانية بعينهم من دون غيرهم، وبالتالي للبُنية الأهلية التي أفرزتهم. وقُدّم الحراك مناوأة لوزارة أو وزير بعينه، وبالتالي لبيئة هذا الوزير. من تونس إلى باقي بُلدان الثورات العربية، وبغض النظر عن التفاصيل والسمات التي لكل حراك ومجتمع بعينه، كانت الثورات دوماً «ثورات» ضُعفاء مُهمشين، ضد أقوياء مركزيين، وليس لهؤلاء الضُعفاء سوى مصدر قوة واحد، ألا وهو سيرهم في الاتجاه الصحيح من حركة التاريخ.
فرنسا: ثقافة وإرهاب
حسام عيتاني/الحياة/20 تشرين الثاني/15
في بلد يحتل فيه «المثقف العام» موقعا مهماً، تؤدي نقاشات الفرنسيين قبيل وبعد جريمة 13 تشرين الثاني (نوفمبر) جزءاً حيوياً من عملية رسم الطريق الذي سيمضي فيه مواطنو ذلك البلد على صعيد اجتماعهم السياسي وعلاقتهم مع الأقلية المسلمة والعالم. شنت المجموعة التي تبنتها «داعش» هجماتها الدموية قبل أن يخف صخب سجال أثاره اعتداء داعشي سابق في قلب باريس استهدف مجلة «شارلي إيبدو» ومتجراً لمأكولات الكوشير اليهودية. في أجواء الصدمة التي ولّدها اعتداء كانون الثاني (يناير)، جذبت الفكرة التي طرحها ميشال هويلبيك في روايته «استسلام» التي صدرت قبل عملية «شارلي إيبدو» بشهور قليلة عن أسلمة المجتمع الفرنسي أسلمة «ناعمة» تفضي إلى وصول رئيس مسلم إلى قصر الأليزيه، اهتماماً عريضاً لتناولها قضية الإسلام الفرنسي والتعامل معه. النَفَس العنصري الصريح الذي كُتبت الرواية به، ساعد في انتشارها وحصولها على دعاية كبرى إضافة إلى وضعها على طاولة التشريح السياسي، بعد الأدبي، باعتبارها رسالة من أحد ممثلي النخبة الثقافية إلى مواطنيه. لم تظل تظاهرات 11 كانون الثاني التي شهدتها المدن الفرنسية في منأى عن القراءة السياسية- الاجتماعية. ايمانويل تود، على سبيل المثال، خصص لها كتابه «من هو شارلي»، معتبراً أن التظاهرات رغم إصرارها على حمل القيم الجمهورية، إلا أنها تحت هذه اللافتات عكست إصراراً من منظميها والكثير من المشاركين على الحفاظ على أسس السيطرة السياسية والثقافية والاجتماعية التي سبق أن مهدت الطريق إلى المقتلة. رغم ذلك، يمكن الجزم أن أصوات اليمين بجناحيه التقليدي والمتطرف كانت أقوى من اعتراضات اليساريين وتحذيراتهم من الانزلاق إلى الفاشية في التعاطي مع المهاجرين والفرنسيين من أصول لا تنتمي إلى «العرق الأبيض» بحسب تعبير نادين مورانو المسؤولة في حزب «الجمهوريين» الذي يمثل الكتلة اليمينية الأكبر في البرلمان الفرنسي. انبرى عدد من مثقفي اليمين وأهمهم آلان فنكليلكروت للدفاع عن مورانو وحقها في استعارة هذا الوصف الذي قالت ان صاحبه هو الرئيس الأسبق شارل ديغول، مؤسس الجمهورية الخامسة وورد في مذكرات واحد من وزرائه. فنكليلكروت وهو الآن الممثل الأهم لمجموعة «الفلاسفة الجدد» الذين ظهروا بعد أحداث 1968، والذين يسميهم خصومهم «الرجعيين الجدد»، كان غزيراً في التعليق والكتابة حول جريمة الأخوان كواشي ضد «شارلي» وجمع تعليقاته الإذاعية وغيرها (من مواقفه منذ 2012) في كتاب حمل عنوان «الصواب الوحيد» وصدر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. كرست مقالات الكتاب انزياح فنكليلكروت الحاد صوب اليمين المتطرف المعادي للأجانب الذين «لا نعرف ماذا يريدون» والذين «يتمتعون بتمييز إيجابي لمصلحتهم»، لكنهم يرفضون التعبير عن تضامنهم مع ضحايا «شارلي إبدو» والذين تصدر عنهم كل آفات المجتمع الفرنسي من مخدرات وبطالة وانتشار الجريمة ويصل إلى التعبير عن أسفه من ضياع مقاربة عالم الانثروبولوجيا كلود ليفي- ستروس أمام المقاربة التي أسسها عالم الاجتماع اليساري بيار بورديو. أو بحسب كلماته غياب فكرة تمحور المجتمع حول الثقافة مقابل الصراع بين المسيطرين والمسيطر عليهم. هذا الابتسار لمقولات ليفي- ستروس، كان في صلب الرد العنيف الذي حمله عرض اود لونسيلان لكتاب فنكليلكروت في مجلة «نوفيل ابسيرفاتور». المجلة ذاتها نشرت قبل يوم واحد من هجمات باريس الأخيرة رسالة مفتوحة من الكاتب آلان باديو حذر فيها فنكليلكروت من الانحدار الى قيعان اليمين المتطرف وتوفيره التسويغ الذي يحتاجه العنصريون للانقضاض على المجتمع التعددي. يبدو النقاش السابق على جريمة 13 تشرين الأول، استمراراً لنقاشات قديمة تتعلق بالمفاهيم الاجتماعية التقليدية. مقاربة أكثر جدة بدأها باحثون شبان يهتمون بأثر ألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي والمعازل بمعناها الثقافي على أجيال من الشبان من أبناء المهاجرين الذين انفصلوا عن الواقع ولا يربطهم بالمجتمعات المحيطة بهم إلا شعور باللامبالاة والكراهية. من هنا يمكن فهم وصف «المنهجي» الذي تكرر كثيراً في كلمات الناجين من الجريمة عند حديثهم عن كيفية قتل المهاجمين ضحاياهم.