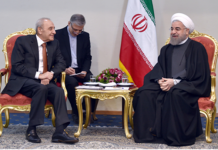ديموقراطية تركيا..ورموزها العربية
ساطع نور الدين/المدن/الثلاثاء 03/11/2015
من بديهيات القراءة لنتيجة أي معركة انتخابية في اي بلد في العالم، الاستهلال بعبارة رتيبة، مكررة الى حد الملل، مفادها “ان الديموقراطية هي التي انتصرت”.. وهي عبارة لم تستخدم كثيراً في الحالة التركية الاخيرة، ولم تتحول الى عنوان للمباهاة او حتى المزايدة كما في النماذج الغربية التي كانت تتفاخر في ما مضى بتجاربها الديموقراطية على المعسكر الاشتراكي الموؤد. بالامس أكسبت تركيا بتجربتها الديموقراطية المتجذرة، تلك اللازمة من الخطاب السياسي الغربي، معنى جديداً، ومنحتها فرصة اضافية، من دون ان تكون بحاجة حتى الى إعلان جدارة الانتماء التركي الى العالم الديموقراطي الحرّ، او تجديد الارتقاء الى مرتبة النموذج الفريد لدول نامية عديدة، عربية واسلامية وعالم ثالثية، لم تدرك طريقها نحو ذلك الصندوق السحري. على حافة بركان سوري وعراقي متفجر، وعلى مقربة من توتر روسي لم يسبق له مثيل، وعلى بوابة إضطراب إجتماعي وإقتصادي أوروبي حاد، خضع الاتراك لإمتحان جديد، في الحداثة وفي الالتزام بشروط الاستقرار والازدهار. ولم يكن نجاحهم جواباً على تحديات خارجية استثنائية لم تواجه مثلها الدولة التركية منذ الحرب الباردة. كان الداخل التركي يقدم أجوبة تاريخية.
الساعات الحاسمة التي عاشها الاتراك ما بين التوجه الى مراكز الاقتراع صباح الاحد والاعلان المتلاحق مساء عن نتائج فرز الاصوات وتوزع النسب والمقاعد في البرلمان الجديد، كانت ملحمية حتى وفق المعايير الغربية. مجتمع في ما يشبه حالة حرب، داخل الحدود وخارجها، أنجز عملية ديموقراطية لا تشوبها شائبة، ولا تجيز أي طعن. بلد خرج منذ أقل من عقدين على ضوابط الحكم العسكري وشروطه القاسية والمهينة، برهن ان مدنيته وديموقراطيته، والى حد ما ليبراليته، باتت من مقدساته الوطنية التي تسمو على جميع العصبيات والحساسيات الداخلية التي لا حصر لها.
في تلك الساعات بدا ان حكم العسكر هو من الماضي التركي البعيد، المتصل بالحقبة العثمانية، وتبين ان الهوية الاسلامية التي إستخدمت سلاحاً في مواجهة الجيش ، إختتمت في المعركة الانتخابية الاخيرة آخر حروبها السياسية، وقررت ان تستقر في مكانها الطبيعي في الوجدان التركي، فهي لم تعد بحاجة الى الحضور في الجدل اليومي. مثلما سقط الجيش التركي من الذاكرة تماما، غاب البرنامج الاسلامي الذي كان حزب العدالة والتنمية يقدم نفسه بصفته وريثه وحامل رايته، فاذا به يكتفي في الحملة الانتخابية بذكر الله وبركته التي حلت على المـؤمنين بليبرالية حزب العدالة والتنمية، اكثر من المطمئنين لخلفيته الاسلامية التي صارت خارج البحث وحتى خارج التداول. لم تعد هناك حاجة الى ذلك السلاح “الاسلامي” الفعال ، ولا ربما الى ذاك النموذج. حققت تركيا “اكتفاءها الذاتي”. وتكون انطباع بأن ذلك الحزب الذي حصل على تفويض شعبي حاسم يمكن ان يحكم تركيا مئة عام، اذا لم تفسده السلطة، أو لم يُصَب زعماؤه بجنون العظمة.. او إذا لم يسيئوا فهم الوصف ( اللامع والدقيق الى حد بعيد) الذي أطلق بالامس على رجب طيب اردوغان باعتباره أهم زعيم في تاريخ تركيا الحديث منذ مصطفى كمال، أتاتورك. ليس من السهل إخفاء مظاهر الاعجاب بتلك التجربة التركية، التي كانت، ككل انتخابات في اي بلد في العالم، فرصة شعبية للمنافسة بين برامج داخلية في الدرجة الاولى، لكنها كانت محملة بالكثير الكثير من الاشارات والرموز التي تتعدى حدود تركيا. فهي تحيي بلا أدنى شك نقاشاً عربياً سابقاً، حول الربيع الذي ضاع قبل الأوان، وهي تبعث الروح حتما في الكثير من الحركات والتيارات العربية الديموقراطية، الاسلامية وغير الاسلامية، وهي تمنح الكثيرين من الذين ما زالوا يقاتلون في سوريا على سبيل المثال أملاً جديداً، أقوى من أي وقت مضى، يشجعهم على رد الهجوم الروسي الايراني الراهن. الإنجاز الديموقراطي التركي يكاد يبدو حدثاً عربياً.
أردوغان ليس سورياً
عمر قدور/المدن/الثلاثاء 03/11/2015
نام النازحون السوريون في تركيا ليلة الأول من تشرين الثاني- نوفمبر وبالهم مطمئن بعد فترة انتخابية عصيبة. هذه المرة لم يلاحقهم النحس في ملجئهم إذ استُخدمت قضيتهم في البازار الانتخابي، وأبدت أحزاب المعارضة نيتها في التضييق عليهم حال فوزها. السوريون لم يكونوا الوحيدين في حالة ترقب، فلا شكّ في أنها كانت الانتخابات التركية الأكثر ترقباً لنتائجها في محيطها الجغرافي. مَن راهنوا على سقوط حزب العدالة كثر في المحيط الإقليمي والدولي، ومن راهنوا على فوزه لم يتوقعوا حجم الفوز الذي تحقق. الانتخابات ونتائجها بعثا رسالة مفادها أن الداخل هو صاحب القرار في الديمقراطيات، وأن الضغوط الخارجية قد تؤثر إلى حد ما لكنها ليست الفيصل، حتى إذا كان الأتراك قد اختاروا عملياً تفويض حكومة مستقرة بدل الانزلاق إلى حكومة أقلية ضعيفة سيشكلها حزب العدالة أيضاً. إنما، مع حفظ الأولوية للاعتبار الداخلي، لا يمكن تجاهل اعتبارات الأمن القومي المتصلة بالحدث السوري. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن بعض معارضي سياسة أردوغان في سوريا، وبعض من يبدون تحمساً لبقاء بشار في السلطة، يفعلون ذلك على قاعدة عدم السماح لأكراد سوريا بالحصول على وضع مشابه لأكراد العراق فيما لو سقط النظام. الأمر يتعلق أولاً بحساسية تركية تجاه القضية الكردية عموماً، لا محبة بنظام الأسد، ولا باعتبارات أيديولوجية تخص إسلامية حزب العدالة فحسب كما يسوّق الترويج الإعلامي. ولا يخفى أن أداء حزب الشعوب الديمقراطي، إثر تحقيقه نسبة أعلى من المتوقع في الانتخابات السابقة، قد أعطى إشارة سلبية لم تشجع ناخبيه الأتراك على الاستمرار في دعمه. فالحزب سوّق لفوزه بوصفه فوزاً كردياً فقط في الداخل، وبوصفه فوزاً للمحور الإيراني خارجياً.
لا يخفى أيضاً أن فوز أردوغان الأخير يزعج بعض دول الخليج، بما فيها بعض داعمي المعارضة السورية، وقد دفعت فصائل المعارضة ثمن الخلاف في الملف المصري إثر انقلاب السيسي. ومن المؤكد أن الإزعاج يزداد بمقارنة الانتخابات التركية بنظيرتها المصرية، سواء من حيث الأداء الديمقراطي أو من حيث نسبة إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع. من المنتظر أن يسوّق الإسلاميون هذه المقارنة لصالحهم، غير أن التسويق الأيديولوجي لا يحجب المقارنة الأصل بين الاستبداد والديمقراطية. الأهم من ذلك على الصعيد السياسي، أن كارهي أردوغان من محبي السيسي لا صلات جيدة لهم بالمعارضة التركية، وأفضل علاقات لهم بتركيا أتت في ظل حكم العدالة. وهم لا يملكون تصوراً بديلاً حتى في الشأن السوري فيما لو خسر حزب العدالة. مع الأسف تصورهم يقتصر على الثأر من أردوغان ليس إلا.
على صعيد الملف السوري، يصحّ القول أن لا تغيير جوهرياً سيطرأ على تعاطي حكومة حزب العدالة الجديدة. قد يكون الفوز حافزاً للتمسك بالموقف المعروف إزاء تنحية الأسد، من دون أن يملك هذا الموقف ديناميات قوية، ما لم يكن مشفوعاً بتنسيق إقليمي عريض يشمل السعودية في الدرجة الأولى. مثل هذا التنسيق قد يضغط على الروس وعلى إدارة أوباما من أجل تنشيط مسار الحل، بدل أن يضغط الروس وإدارة أوباما على كل دولة منفردة لفرض التفاهمات الروسية الأميركية. ومن المعلوم أن الروس وقوات النظام بدأوا باستهداف الشمال من أجل قطع خطوط الإمداد والسيطرة على الحدود التركية. إفشال المخطط الروسي بإحكام السيطرة على الحدود هو أهم استحقاق يواجه داعمي المعارضة الآن، لأن تحققه يعني ترجيح ميزان القوى نهائياً لصالح النظام وأرجحيته في أي حل مقبل. بالطبع، أردوغان ليس سورياً، وللقاعدة الاقتصادية التي انتخبته مصالح ضخمة مع الجارين الروسي والإيراني، أي أن الشطط لن يبلغ به حد التضحية بمصالح تركيا. هذا ما ينبغي أن يأخذه في الحسبان أولئك الذين يعلّقون آمالاً ضخمة على فوزه. وينبغي التمييز بين العاملين الإنساني والسياسي، فالأول الذي يخص استضافة تركيا النازحين السوريين لا يعفي حكومة حزب العدالة من النقد على عموم أدائها السياسي، ومن ذلك الإستثمار في التنظيمات المتطرفة أسوة بقوى دولية وإقليمية أخرى. أما على صعيد الإمدادات العسكرية فيعلم الجميع أنها خاضعة لاعتبارات خارجية لا لمتطلبات الوضع السوري، ومن ذلك حسابات الحكومة التركية والشد والجذب بينها وبين القوى الإقليمية والدولية، ولعل الكثيرين يتذكرون كيف تم انتزاع مدينة كسب الحدودية من سيطرة النظام بدعم تركي، وكيف جرى الانسحاب الطوعي منها بطلب تركي أيضاً. لقد منحت صناديق الاقتراع أردوغان النسبة الكافية ليحكم، لا ليتحكم، ويجوز القول بأن حزب العدالة فاز لكن الأردوغانية انهزمت. هذا هو المعنى العميق للحفاظ على الديمقراطية، وأيضاً عدم الخروج من الكمالية إلى معطف الأردوغانية. أيضاً هذا هو المعنى المطلوب تفهّمه في أوساط المعارضة السورية، سواء على سبيل الاستفادة من الدرس الديمقراطي، أو على سبيل وضع “زعامة” أردوغان في حجمها الواقعي وعدم انتظار الكثير منه. وإذا كان الاختلاف مفهوماً بين مؤيدي بشار والمعارضين حول حكم العدالة فإن ما يثير الشفقة الخلاف بين الوسطين العربي والكردي، لأنه بمثابة تطفل على القضية الكردية في تركيا من جماعات لا تملك بعد مصيرها في أرضها. وأن تعكس الانتخابات خسارة القوميين الأتراك والقوميين الأكراد معاً فهذا بمثابة الدرس الذي لا يبدو قوميو سوريا من أكرادها وعربها جاهزين للتعلم منه بعد.
تركيا وسورية وإيران
محمد علي فرحات/الحياة/04 تشرين الثاني/15
وظيفة الانتخابات في النظام الديموقراطي هي تجديد الحياة السياسية، وهذا لا يتحقق في بلدان كثيرة بينها تركيا، إذ يعتمد الحزب الحاكم وسائل ترغيب وترهيب تسمح بتجديد إدارته السياسية والاقتصادية بواسطة غالبية المقترعين. لقد مضى زهو الديموقراطية وانقضى، ولن نشهد ما يشبه الحدث الديموقراطي الكبير في بريطانيا، حين انتصر ونستون تشرشل في الحرب العالمية الثانية وما لبث ان تقبّل الهزيمة في الانتخابات تاركاً مقعد رئاسة الحكومة لشخص آخر. رجب طيب أردوغان وأحمد داود أوغلو لا يشبهان تشرشل كما لا تشبه تركيا بريطانيا، فضلاً عن أننا نشهد شيخوخة الديموقراطية في عالمنا، لكنها تبقى، فقط لعدم وجود بديل منها في اجتماعنا السياسي. وبقدر فرح حزب «العدالة والتنمية» بتفويض غالبية الناخبين انفراده بالحكم، فإن رئيسه أحمد داود أوغلو أحسّ بوطأة المسؤولية متخوّفاً ضمناً من ترسُّخ الاستقطاب في تركيا بين إسلاميين وأكراد وعلمانيين، لذلك ركّز خطابه على الداخل في نبرة تصالحية تمحو خطاب الحزب الانتخابي المعادي للأحزاب الأخرى، وتعهد عدم استبعاد أحد (من الدولة أم من المجتمع؟ ما دام الاستبعاد قائماً من الحكم). والتصالح تعبير جديد في خطاب «العدالة والتنمية» يهدف إلى تكريس الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي كان على حافة الانفراط نتيجة دعاوى الشك والتخوين، ونتيجة فعل الاستبعاد الذي اشتهر به رجب طيب أردوغان… وما دام «العدالة والتنمية» هو الحاكم وحيداً فلا داعي لمشكلات مع الأكراد والعلمانيين، وبالتالي سيتسع صدره لهم ويغض الطرف عن مخالفاتهم المحدودة مقدّماً نفسه كحزب راعٍ لجميع المواطنين في تركيا.
ولعل تسديد ضربتين تركيتين لـ «داعش» أثناء الانتخابات هو رسالة لهذا التنظيم الذي سهلت تركيا ولادته ونموّه، بأن لا يحاول التطاول على راعيه وأن يلتزم حدّه السوري. وهنا، في الساحة السورية بالذات، يبدو الصراع الذي تتداخل فيه قوى محلية وإقليمية وعالمية، الأكثر تأثيراً في الداخل التركي، لذلك تحتفظ أنقرة بمضمون موقفها من سورية وإن اضطرت الى بعض التغيير الشكلي. ويلاحظ المراقبون تنامياً، وإن بطيئاً، في التنسيق مع المملكة العربية السعودية في شأن الملف السوري، لكن التعاون الأساسي يبقى مع دولة قطر، مع تعديلات تقضي بالتعاون مع «جبهة النصرة» وتقليم أظافر «داعش» الذي يكاد ضربه يصبح هدفاً مشتركاً للاعبين في الميدان السوري. أليس لافتاً نداء أيمن الظواهري داعياً للتحالف بين «النصرة» و «داعش»، فكأنه يبحث عن مكان آمن لخليفة «داعش» في عباءة «النصرة» – «القاعدة». يعرف أحمد داود أوغلو أن ما بعد فيينا يختلف عما قبلها، لذلك تعمّد عدم التركيز على مطلب منطقة آمنة في شمال سورية. وهو يراقب باهتمام صورة أميركا الجديدة كوسيط، إلى حدّ ما، في الشأن السوري، ويقرأ جيداً الدعوة الأميركية لمشاركة إيران في مؤتمر فيينا الذي سيعقد جلسته الثانية شبه الحاسمة في عشرينات الشهر الجاري، ذلك أن إيران وتركيا ستكونان مدعوتين في المؤتمر إلى الكف عن التدخُّل في الشأن السوري وإلى سحب جماعاتهما العسكرية من البلد المنكوب: إيران (الخبراء وفرق «حزب الله» اللبناني ومقاتلون من العراق وأفغانستان) وتركيا («جبهة النصرة» وأخواتها).ولن تتغير سياسة تركيا ومعها سياسة إيران تجاه الأزمة السورية، إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي، يتردد أن واشنطن وموسكو تعدّان له بهدوء، بحيث يصدر مصحوباً بآلية تنفيذ مُلزمة. وبالتوازي بدأ إعداد قاموس للغة مشتركة بين الحكومة السورية ومعارضيها والتمرين على استخدام هذه اللغة في لقاءات تبدأ في موسكو وربما تتبلور في واشنطن. في حرب سورية التي تفاقمت حتى وصلت إلى العالمية، تربح الدول الكبرى، وتتحطم دول هيأت نفسها لدور الضحية، ويُجرى استخدام دول احترفت رؤية عظمتها في مرايا مكبّرة.
الانتخابات التركية وتداعياتها على الأزمة السورية
أحمد محمود عجاج/الشرق الأوسط/04 تشرين الثاني/15
أبرزت الانتخابات التركية الأخيرة، والفوز الكاسح لحزب العدالة والتنمية، مدى الاختلال الذي سيطرأ بالذات على الساحة السورية. ومما لا شك فيه أن أميركا وروسيا وطهران تدرك أبعاد هذا التحول، لكنها تجد نفسها في مأزق، لأنها لم تستعِّد له أساسا، وكان رهانها على حكومة ائتلافية تركية ضعيفة. تجد هذه الدول نفسها الآن في مواجهة رجل قوي يقود دولة نامية قوية، لها تاريخ مشرق، وباع طويل في التعامل مع التعقيدات الدولية، ودولة لها مصالح كبرى في منطقة يتنازع عليها الكبار. ثمة مؤشرات ستساهم في صناعة سوريا المستقبل أهمها شخصية إردوغان، وإسلامية الطرح التركي، والمشكلة الكردية، والضعف الأميركي وضيق الخيارات الروسية. إن شخصية إردوغان كانت هي المطروحة على التصويت، وهي التي صوت لها الناخبون الأتراك، وهي التي خاطرت سياسيا في إعادة الانتخابات، وتحدت كل استطلاعات الرأي، وفازت في النهاية فوزا كاسحا. ففي تركيا يوجد الآن رئيس قوي تجاوزت قوته أبا الأتراك «أتاتورك»، رئيس يواجه على الأرض السورية الروس والأميركان وإيران. فما يريده بوتين في روسيا لا يتطابق تماما مع ما يريده إردوغان، ولا مع ما يريده أوباما أو روحاني؛ بوتين يريد إنشاء دولة علمانية تلعب فيها الأقليات دورا رائدا، وتكون مربوطة به، وإيران لا تمانع، بينما أميركا لا ترى ضيرا طالما أن الروس هم الذين ستحترق أيديهم، وشريطة أن تكون لأميركا يد طولى في تشكيل سوريا وقولبتها. لسوء حظ الرئيس الروسي بوتين، ومعه الأميركي أوباما، أن إردوغان عاد بقوة للساحة السياسية، وعاد وبيده ورقة يجمع عليها شعبه وهي الورقة الكردية التي هي في صميم الأزمة السورية. بعبارة أخرى، تركيا لن تقبل أبدا بأن ترسم دول من خارج المنطقة مستقبل دولة جارة لسوريا، وأن ترسمها بطريقة ضارة بمصلحة دولة تركيا. هنا يلعب التاريخ دوره لأن إردوغان ليس شخصية عادية، بل هو معبأ بالتاريخ (العثماني)، ويدرك أن نمو بلاده وازدهار اقتصادها وأمنها مرتبط بما يجري في دول الجوار القريب؛ بمعنى أنه يريد حزاما آمنا لا يحق لأحد أن يتدخل به من دون مراعاة مصلحة تركيا؛ فكما أن روسيا لها نظرية «الجوار القريب»، وأميركا نظرية «الحديقة الخلفية» فهو لديه أيضًا نظرية «الجوار الإسلامي» التي تمنع على الآخرين التدخل في دول مجاورة ترتبط به ثقافيا ودينيا، وتاريخيا.
إن نظرية الجوار الإسلامي مع عودة إردوغان للسلطة ستأخذ مداها الطبيعي، وستكون البوصلة التي ستحدد السياسة الخارجية التركية. وقد رسم إردوغان ملامحها بدبلوماسية في الفترات السابقة على فوز حزبه، وهو أنه إذا ما أراد الأكراد التمدد إلى غرب الفرات، فإن تركيا ستتصرف وفق مصالحها ولن تراعي أحدا. وبما أن الجغرافيا هي المحدد لقوة السياسة، فإن سوريا ملاصقة لتركيا، وبوسع تركيا أن تزعج روسيا وبأكثر بكثير مما أزعجت باكستان الولايات المتحدة عبر حركة طالبان. فالجميع يعرف أن تركيا هي بمثابة القلب للحراك الثوري في سوريا وبالتحديد الإسلامي، وأن ما نسجته من علاقات في السنوات الأربع الماضية، كفيل بأن يضمن لها موقعا متميزا في المعادلة السورية. وقد تبين بالفعل للقيادة الروسية أن السيطرة على الجو لا تعني السيطرة على الأرض، وأنه ببضعة صواريخ متطورة يمكن للمعارضة السورية أن تفشل المخطط الروسي بأكمله.
يطال القلق إدارة أوباما التي راهنت هي الأخرى على تركيا مختلفة؛ فأوباما مصر على استحضار إيران كطرف فاعل في المعادلة العربية بعد الاتفاق النووي الأخير، وتحييد الدور التركي قدر ما أمكن، رغم ما تجره السياسة الأميركية من تداعيات سلبية على الأمن التركي. لكن أوباما سيشعر لأول مرة أنه بمواجهة واقع مختلف، وأن تركيا ما بعد الانتخابات غير تركيا ما قبلها؛ فإردوغان يرى في السياسة الأميركية ضعفا واضحا، وتراخيا في دعم حلفائه، ويعتبر الرئيس الأميركي غير عابئ بما يجري، وعليه فإن إردوغان سيعتمد سياسة لا تراعي الطرف الأميركي عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي التركي. وتعريف الأمن القومي مطاط جدا، وهو ما نلمسه في التعريف الروسي، والأميركي، والإيراني؛ وعليه فإن إردوغان لن يسمح بأن تُقولب وتُصاغ سوريا إلا بما يتناسب مع أمن بلاده ومصالحها. ولعل المشكلة الأكبر التي ستواجهها أميركا هي الكرد الذين تستخدمهم في مواجهة تنظيم داعش، والذين يراهم إردوغان ومعه كثير من الشعب التركي أداة بيد أميركا، وخنجرًا سيمتد إلى قلب الوطن التركي. وما تصريحات إردوغان بهذا الخصوص إلا دليل على أنه سيصل إلى تصادم مع أميركا، وأن أميركا في ظل أوباما لن ترى مصلحة بإغضاب إردوغان تركيا. وبالطبع سيخسر الأكراد! بيد إردوغان ورقتا الداخل والإقليم وهما يؤهلانه للعب دور صانع الحل السوري؛ ففي الداخل غَيَّر إردوغان تركيا تماما، فهي الآن لا تشبه تركيا العلمانية الراديكالية أبدا، بل هي تشبه أكثر ما يمكن تسميته الليبرالية الإسلامية، التي تركز على التوسع الثقافي والفكري والتجاري، دونما اختزال للعامل الأمني. وقد برهنت الانتخابات الأخيرة أن الداخل التركي بأكثريته مع إردوغان، وأن الذين محضوه الأغلبية هم الكرد المحافظون الذين وجدوا أن طروحاته لا تختلف عن عقائدهم، ووجدوا أنهم في مأمن في ظله. كذلك على المستوى الإقليمي، فإن خلفية إردوغان الدينية، وتراث العثمانية، وانخراطه في شؤون المنطقة، سمحا له أن يكون مؤثرا في الإقليم المجاور، وهو ما تبدى في تأييد شعبي ليس بالقليل في العالم العربي الذي يشعر بأنه محاصر ومستباح. وبناء على هذا فتركيا تدرك أنها ستجد مناصرة من السعودية التي تعتبر أهم دولة عربية، بعدما خرجت مصر من المعادلة واختارت الدور الحيادي في الأزمة السورية؛ فكلا الدولتين متفقتان على أن الأسد ليس له مكان في سوريا المستقبل. كما أن إردوغان سيستخدم بذكاء أزمة اللاجئين وثقلها على الاتحاد الأوروبي، الذي سيجد نفسه مضطرا للمساومة والقبول بالطروحات التركية. لقد أعطت الانتخابات التركية إردوغان تفويضا جديدا، ووفرت له كذلك المعطيات الداخلية الزخم الشعبي الداعم له، ومنحه المعطى الإقليمي القدرة على المناورة والتحرك، وبهذا فإنه بشخصيته القوية وبالرؤية والخلفية التي يحملها، سيكون بالفعل اللاعب الأقوى في الأزمة السورية، ستكون تركيا في عهد إردوغان الدولة الأولى التي ستقول علنا: لا للأسد؛ وستكون الدولة الأولى التي ستصر على حماية أمنها من الجوار السوري، ولو أدى الأمر إلى استخدام القوة.
مع عودة إردوغان قويًا إلى السلطة توقعوا ما لم يكن متوقعًا!.