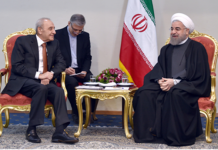أميركا وتقسيم العراق مقابل إيران وتقسيم سورية
عبدالوهاب بدرخان/الحياة/03 أيلول/15
عبّر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أخيراً عن اندهاش وانزعاج من تصريح لرئيس هيئة الأركان الأميركي الجنرال أوديرنو، قبيل تقاعده، قال فيه أن تقسيم العراق «يمكن أن يحدث»، بل إنه «قد يكون الحل الوحيد». كانت تلك خلاصة انتهى إليها عسكري قيادي أمضى أعواماً عدة في العراق، وبمعزل عن دوافعه ونياته فالمؤكد أنه تعامل مع جميع مكونات المجتمع وتحادث معها بصراحة لا تميز العلاقات في ما بينها. لكن رد مكتب العبادي اعتبر تصريحاته «غير مسؤولة» وتنمّ عن «جهل» بالوضع في العراق. كل مَن يريد للعراق أن «يبقى» (!) موحداً يتمنى طبعاً أن يكون العبادي محقّاً وأكثر علماً بحقائق بلده، وهو مؤهّل لذلك. لكن، بعد أسبوع، كان المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني من أشار إلى «التقسيم» ولو من زاوية مختلفة وفي سياق إلحاحه على مواصلة الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء، بل المضي بها بوتيرة أكثر سرعة. قال المرجع، في إجابات مكتوبة عن أسئلة لـ «فرانس برس»: «إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الأصعدة، فإن من المتوقع أن تسوء الأوضاع أزيد من ذي قبل، وربما تنجر إلى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله». وذهب المرجع أبعد حين حمَّل «الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية معظم المسؤولية عما آلت إليه الأمور»، لأن «كثراً منهم لم يراعوا المصالح العامة للشعب العراقي، بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية، فتقاسموا المواقع والمناصب الحكومية وفقاً لذلك، لا على أساس الكفاءة والنزاهة والعدالة»…
طوال فترة الاحتلال، لم يلتقِ المرجع الشيعي أي مسؤول أميركي رغب في مقابلته، لكنه يلتقي اليوم والجنرال الأميركي على استخلاص واحد، من دون أن يتقصدا ذلك. وفي العامين اللذين سبقا الانسحاب الأميركي بنهاية 2011 كثّف مسؤولو سلطة الاحتلال إلحاحهم على رئيس الحكومة آنذاك نوري المالكي لبدء العمل على «المصالحة الوطنية» التي كان أعطاها أولوية في البرنامج الحكومي، معتبرين أن المصالحة شرط سياسي ضروري لتدعيم التهدئة الأمنية التي تأمّنت بتعاون «الصحوات السنّية». كان الأميركيون أدركوا الأخطاء التي ارتكبوها خلال الاحتلال، وإنْ لم يعترفوا بها حتى اليوم، إلا أن توصيتهم كانت واقعية وفي محلّها. كان لدى المالكي مفهوم آخر للمصالحة، وآلية أخرى لتحقيقها بالفساد والإفساد العابرَين للمكوّنات، وبسياسة «فرّق تسد» التي نجح جزئياً في تطبيقها حيال السنّة. كان المالكي يعتقد أنه يبني دولة الإخضاع للآخرين، لكنه في الحقيقة كان يصنع التقسيم صناعةً، وهو ما تبدّى في العامين الأخيرين من حكمه حين عامل اعتصامات السنّة بتجاهل واحتقار، وتحديداً في الشهرين الأخيرين اللذين اختتمهما بسحب الجيش من الموصل وترك «داعش» يستولي عليها قبل أن يحتلّ أجزاء من العراق وسورية. ليس واضحاً ما قصده العبادي بإشارته الى «جهل» الجنرال الأميركي بالوضع في العراق. ربما استند إلى تجربة حكومته التي تمثّل أطيافاً عدة وتقيم تعاوناً مع السنّة ولا يمكن اتهامها بالهيمنة الفظّة أو بالنزعة الاستبدادية اللتين عُرف بهما سلفه. غير أن مسحة التلطيف التي أضفاها على نهج الحكم لا تزال بعيدة من إعادة اللحمة إلى أجزاء البلد، بل يلزمه الكثير ليجعل من بغداد عاصمة جامعة ومن حكومته إدارة مركزية على مسافة واحدة من الجميع. ولعل ضم ميليشيات «الحشد الشعبي» إلى كنف «الدولة» شكّل تهميشاً مشرعناً للجيش الوطني بمقدار ما أثبت أن شيئاً لم يتغيّر في ما تأمر به إيران وتُطاع. فما بُني على خطأ لا يزال يراكم الأخطاء، وهو ما ظهر أيضاً في معارك طرد «داعش» من المناطق السنّية، فما تحرّر منها – كديالى وبعض صلاح الدين – لم يُشعِر أهلها بأنهم يعودون إلى «الوطن»، بل تخلّصوا من تسلّط ليقعوا تحت تسلّط آخر تديره إيران بمعزل عن الحكومة لكن بمعرفتها. هكذا، فبدل أن يشكّل «التحرير» اختباراً إيجابياً حاسماً لمصلحة وحدة العراق إذا به يفرض تأخيراً بعد تأخير في استرجاع المناطق المحتلّة – لا سيما الأنبار ونينوى – ويستوجب تغييراً بعد آخر في الاستراتيجية.
في نيسان (أبريل) الماضي أقرّ الكونغرس الأميركي مساعدة عشائر السنّة تسليحها في شكل مباشر، وكذلك إقليم كردستان. وعلت أصوات الأطراف المرتبطة بإيران رافضة هذه الخطوة، واعتبرتها سعياً أميركياً إلى تقسيم العراق. وعلى افتراض أن هذه الانتقادات محقّة فهي كانت ستكون فاعلة ومفيدة لو أن إيران أتاحت خيارات أخرى. هذا لا يعني أن دوافع الأميركيين نظيفة، لكن ينبغي التذكير بأنهم طلبوا منذ بداية تدخلهم، بدعوة من المالكي، أن يكون لسكان «مناطق داعش» دور ومساهمة في تحريرها، ومنحوا الحكومة مهلة زمنية كافية لترتيب العلاقة معهم. وعدا فجوة انعدام الثقة بين «جماعة إيران» وهذه المناطق التي اختبرت جيداً ارتباطات السلطة ومرجعياتها الحزبية، فإن إيران رفضت على نحو قاطع تسليح العشائر وراحت تحاول ربط مجموعات استتبعها المالكي بـ «الحشد»، لكن هذه الخطة لم تبرهن فاعليتها. الواقع أن العارفين بدواخل السياسة الإيرانية الخاصة بالعراق واظبوا طويلاً على تأكيد رفضها أي «تقسيم»، بل اعتبروا ذلك «ضماناً» لـ «وحدة البلد»، لكنهم تبيّنوا أن ما كانت تبحث عنه إيران، فضلاً عن ابتلاع العراق، هو تأمين تواصل آمن ودائم مع سورية – النظام وبالتالي مع لبنان – «حزب الله»، ولم تكن تبالي بمصلحة العراقيين، ناهيك عن السوريين أو اللبنانيين. ولأن المهم عند إيران هو أجندتها ومستقبل نفوذها فإن عوامل عدة، أهمها اختلاط الأوراق بسبب «الحرب على داعش» وانكشاف هشاشة نظامَي دمشق وبغداد وفئويتهما وطائفيتهما، جعلت طهران تبدّل موقفها وتشرع في الاستعداد للتقسيم باعتباره «الحل الوحيد» الذي يمكّنها من الحفاظ على «مصالحها» في العراق كما في سورية واستطراداً في لبنان، وذلك بالاعتماد دائماً على الميليشيات التي أصبحت الجيوش «الوطنية» مجرد رديف لها. وعذرها في ذلك أن التقسيم يتحوّل أكثر فأكثر إلى خيار دولي، وعندما اقترحه جو بايدن للعراق في عام 2006 أي قبل أن يصبح نائباً للرئيس قوبل باستهجان ورفض، علماً أن الوقائع على الأرض أكّدته بـ «فدرلة» إقليم كردستان. كانت هناك فرصة لإيران كي تحبط التقسيم، لو توافرت لديها الإرادة، غير أن وحدة العراق لا تستقيم مع هيمنة إيرانية. لذلك، يتعامل الأميركيون الآن مع واقع صعب في «الإقليم السنّي» بعدما ساهموا والإيرانيين في صنعه.
ما عزّز التغيير في موقف طهران أن حليفها النظام السوري انطلق في تعامله مع أزمته من خيار «التقسيم» إذا لم ينجح في إخضاع الشعب، وما كان له أن ينجح على رغم كل ما بذله الإيرانيون لمساعدته. ومع تقدّم الأزمة وتعقّدها زاد اقتناعهم بأن «سورية الأسد» هي الضامن الوحيد لمصالحهم، فمع سورية موحدة وحكومة جامعة سيخسرون كل شيء بعد كل هذا العداء الدموي الذي أبدوه للشعب السوري. والفارق بين بشار الأسد وساسة العراق أنه كان حاسماً أمره حتى قبل أن يثور الشعب عليه، أما العراقيون سنّة وشيعة فلم يعدموا الأمل في إبقاء البلد موحّداً، لكنهم أمضوا اثني عشر عاماً في تظهير انقساماتهم وتعميقها. وإذ يستخدم الجميع «داعش» للإشارة إلى صعوبة التعايش مع الآخر، يحدسون بأن التقسيم سيجعلهم مستعمرات للقوى الخارجية ولن يكون وصفة للاستقرار بل للتقاتل الداخلي.
على رغم أن تصريحات الجنرال أوديرنو، معطوفة على اقتراحات بايدن، لا تشكّل بعد سياسة أميركية، إلّا أن الإيرانيين يربطونها بتسليح العشائر ليعتبروها مشجِّعة. فإذا صار الأميركيون مقتنعين الآن بتقسيم العراق، فلا بد أنهم يتقبّلون أيضاً تقسيم سورية. ففي الحالين هناك تكريس للأمر الواقع الذي زرعته إيران وحلفاؤها.
سذاجة دي ميستورا وتاريخ الأسد
حسان حيدر/الحياة/03 أيلول/15
في ظن روسيا واعتقاد الأمم المتحدة أن الحراك الديبلوماسي المتقطع الذي ترعيانه والاجتماعات والمشاورات التي تنظمانها في هذه العاصمة أو تلك، مع أطراف في المعارضة السورية، ومع ممثلين هامشيين لنظام الأسد، يمكن أن تؤدي جميعها إلى تسوية للحرب الأهلية في البلد المدمر، تشبه النهايات السعيدة للأفلام الهندية أو المسلسلات التركية. لكن الوسطاء الدوليين المعنيين بسورية، وفي مقدمهم دي ميستورا الذي وضع صيغة «أكاديمية» للتسوية كما يراها، يحاولون تجاهل ما يعرفونه تماماً من أن الأسد ورجاله لن يدخلوا في أي حل لا يضمن استمرار حكمهم وبقاء نفوذهم ومصالحهم، ليس فقط لأنهم لا يزالون قادرين على القتل والمراوغة ومقاومة الضغوط، بل لأنهم لا يرون، بسبب تركيبتهم الطائفية والأيديولوجية، أن هناك حلولاً وسطى للأزمة. فهم إما ينتصرون بالكامل وينضم العالم كله إلى صفهم مصفقاً تحت شعار «محاربة الإرهاب»، وإما سيظلون يقاتلون حتى النهاية، طالما يجدون من يقدم لهم الدعم السياسي والعسكري، ومن بين هؤلاء روسيا نفسها التي تنتحل دور الوسيط. وأمام هذا الواقع، يعمد هؤلاء الوسطاء إلى التحايل وتفخيخ اقتراحاتهم بتضمينها فقرات غامضة تحتمل أكثر من تفسير واجتهاد، إن لناحية مغزاها السياسي أو مداها الزمني أو لجهة إمكان تطبيقها العملي. ولنأخذ مثلاً الفقرة في خطة دي ميستورا التي تقول انه تسبق المرحلة الانتقالية مرحلة تمهيدية تتمتع خلالها الهيئة الحاكمة الانتقالية بسلطات تنفيذية محددة (المقصود محدودة) تمتد لفترة زمنية لا يحددها النص، أي تترك لاتفاق الأطراف المعنيين. يعني هذا الاقتراح أن الفترة الانتقالية التي نص عليها بيان «جنيف 1» تناسلت وأنجبت فترة جديدة مائعة، وقد تنجب غيرها بحسب الظروف والأوضاع الميدانية والسياسية، وأن ما ذكره البيان عن منح الهيئة الانتقالية صلاحيات كاملة لم يعد وارداً في فترة أولى ليس معروفاً متى تنتهي. وهو ما يدعو إلى التذكير بتجربة نظام الأسد اللبنانية في تطبيق اتفاق الطائف الذي نص على انسحاب الجيش السوري وتسليم الأمن إلى السلطات اللبنانية بعد سنتين كحد أقصى من تاريخ توقيعه، وكيف أنه ماطل 16 عاماً في التنفيذ بحجج مختلفة اختلقها، ورعا الانقسامات اللبنانية وشجعها حتى يبقى ممسكاً بعنق البلد وقراره، ولم يخرج من لبنان إلا بعد ارتكابه جريمة مروعة اضطرت دولاً كبرى إلى إنذاره بالخروج، فكيف وهو اليوم في أرضه و «منتخباً رسمياً» وتعترف أطراف عديدة بـ «شرعيته»، من بينها الأمم المتحدة؟ ولنا أن نتساءل ما ستكون عليه المرحلة التمهيدية الانتقالية إذا ظل الأسد ممسكاً خلالها بالأجهزة الأمنية والعسكرية؟ وماذا سيحصل لقوات المعارضة إذا كان «داعش» الذي ينسق مع النظام ويخوض معاركه بالوكالة عنه، سيواصل هجماته على مواقعها، فهل يستطيع أحد عندها ضمان أن قوات النظام لن تهاجمها أيضاً تحت غطاء منع «داعش» من التقدم؟ وفي فقرة أخرى، يقول دي ميستورا إنه في حال إخلال الأطراف بتنفيذ بنود التسوية، سيجري مشاورات مع دول مجموعة الاتصال ويرفع توصياته إلى مجلس الأمن. لكن هل يمتلك هذا المجلس قراراً موحداً يستطيع فرضه على دمشق، ما دامت موسكو تتمتع فيه بحق النقض وتعتقد أن الأسد هو «الرئيس الشرعي» لسورية الذي لا يجوز استبداله أو اشتراط رحيله لبدء أي تسوية، بل تروّج معلومات حالياً عن زيادة انخراطها العسكري إلى جانبه؟ الموفد الدولي ليس ساذجاً بالتأكيد، بل يتعامل مع الوقائع الدولية التي تشي بأن الأميركيين أنفسهم ليسوا راغبين في إسقاط الأسد، حالياً على الأقل، وأنهم يمنحون أولوية مطلقة للحرب على «داعش»، لكنه يصبح ساذجاً عندما يسقط من اعتباره تاريخ بشار الأسد الدموي الذي يؤكد أنه لا يمكن أن يتنازل طوعاً ولو عن صلاحية بروتوكولية واحدة.
أوروبا بحاجة إلى «مشروع مركل» لمواجهة قضية الهجرة
رغيد الصلح/الحياة/03 أيلول/15
تحتل قضية الهجرة إلى أوروبا من البلدان المجاورة الحجم الأكبر من اهتمام أصحاب القرار والرأي في دول القارة والاتحاد الأوروبي. فهذه القضية هي موضوع مناقشات واسعة في المؤسسات الرسمية، وهي المادة الرئيسية في الاجتماعات المتوالية التي يعقدها وزراء الاتحاد الأوروبي المعنيون بقضايا الهجرة ومضاعفاتها. كذلك فإنها الموضوع الطاغي على سائر المواضيع الأخرى في أجهزة الإعلام الأوروبية الرئيسية. ويتناقل الأوروبيون بقلق ملحوظ أرقام الهجرة المتفاقمة الصادرة عن الأمم المتحدة حيث وصل إلى اليونان وإيطاليا وحدهما هذا العام حوالى 300 ألف من المهاجرين. فضلاً عن ذلك، استلمت ألمانيا وحدها أيضاً خلال النصف الأول من العالم الحالي، بحسب البيانات الرسمية 179 ألف طلب لجوء سياسي. بذلك تشهد أوروبا، كما يقول أحد الخبراء المعنيين بالهجرة أكبر موجة من الهجرة البشرية من خارج القارة. وتتحول هذه الأرقام إلى كوابيس لدى البعض إذ تقترن ببعض أعمال العنف التي يقوم بها مهاجرون أو متطرفون ضد المهاجرين. لقد بلغ هذا النوع الأخير من الاعتداءات خلال الأشهر الأخيرة 202 ضد مراكز إقامة المهاجرين وعملهم.
تسعى الدول الأوروبية الى مواجهة هذه القضية بالاستناد الى مبادئ يتضمنها «اتفاق دبلن» الذي وقّع عليه عدد من دول الاتحاد الأوروبي عام 1997، والأسس التي رسمها الاتحاد لسياسته إزاء دول الجوار، والقوانين والدساتير المرعية في دول الاتحاد. استرشاداً بهذه الوثائق، برزت في مناقشة قضية المهاجرين المقترحات الرئيسية التالية:
أولاً: تحصين «القلعة الأوروبية». وتنطلق هذه السياسة من اعتبار الهجرة إلى أوروبا من خارجها خطراً رئيسياً على القارة، أو بالأصح الخطر الأكبر عليها كما تتصوره أحزاب اليمين المتطرف. وتدعو هذه الأحزاب، مثل حزب «الحرية» في النمسا، و «الجبهة الوطنية» في فرنسا، الحكومات في الدول التي تنتمي إليها إلى التخلي عن القوانين والإجراءات التي تسهل دخول دول القارة أو حتى التنقل بينها. في هذا السياق تدعو أحزاب اليمين المتطرف الى رفع عدد وعدة قوات الأمن التي تقوم بحراسة الحدود وتخصيص المزيد من الأموال لاقتناء أجهزة الرقابة وتطوير أدواتها وتقنيتها، وإحكام الرقابة على المعابر البحرية والبرية بين الدول.
يقترن مشروع «القلعة الأوروبية» بحملات إعلامية واسعة تقوم بها أحزاب اليمين المتطرف ضد «تعريب» أوروبا و «أسلمتها». ولهذه الحملات نتائج سلبية كثيرة تصيب المهاجرين العرب، وتؤثر بالضرورة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أحوال أولئك المهاجرين الذين يصل عددهم إلى الملايين، وكذلك على العلاقات العربية- الأوروبية. ويزيد من هذه النتائج أن حملات التخويف ضد العرب باتت تؤثر على قطاع مهم من الرأي العام الأوروبي غير معادٍ أصلاً للعرب ولكنه حريص على أمن بلاده واستقرارها. ويزداد تأثر هذا القطاع من المواطنين الأوروبيين عند المقارنة بين الاهتمام الكبير بمسألة المهاجرين في أوروبا والتجاهل الذي تلقاه هذه المسألة في الدول العربية مع أنها بأي معيار قضية أوروبية- عربية.
يعاني هذا المشروع من ثغرات عديدة من أهمها أنه يتعارض أساساً مع المشروع الأوروبي والاتفاقيات التي عقدت في إطاره مثل «اتفاق شنغن» حول حرية التنقل بين الدول الموقعة عليه. لذلك فإنه بينما يكتسب بعض التأييد من معارضي هذا المشروع، فانه يحوله الى مشروع مرفوض من نسبة مرتفعة من مؤيدي الاتحاد الأوروبي من الذين يلمسون فوائده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ثم إن هذا المشروع قد يردع بعض المهاجرين الذين يدركون أهمية الصعوبات التي تمنع تسلل المهاجرين إلى القارة، ولكنه لن يحول دون استمرار الهجرة. فلقد ثبت أن العدد الأكبر من المهاجرين على استعداد لقبول شتى أنواع الأخطار من أجل الوصول الى بلاد الهجرة. وسوف تستغل هذا الاستعداد عصابات التهريب، ولكن بعد رفع أسعارها ونسبة الأرباح التي تجنيها من وراء استمرارها في تهريب المهاجرين. بذلك يفتح النهج الأمني البحت في معالجة قضية الهجرة الباب أمام ازدهار نمط خطر من أنماط الجريمة المنظمة في دول القارة.
ثانياً: نظام الكوتا الإلزامية. وقد اتفقت بعض دول الاتحاد على هذا الترتيب خلال شهر حزيران (يونيو) الفائت. فوفق نظام الكوتا، كان من المفروض أن تتحمل الدول الأوروبية نصيبها من المهاجرين بحيث تتوزع الأعباء على هذه الدول بصورة عادلة ومنصفة. فضلاً عن ذلك، وسيراً على طريق توزيع الأعباء، فقد اقترح بعض الاختصاصيين من مركز أوكسفورد للمهاجرين، تقديم المزيد من الدعم إلى الدول التي تستقبل مئات الآلاف من المهاجرين رغم حجمها الصغير وإمكاناتها القليلة، مثل لبنان والأردن. وكان من مسوغات هذا الاقتراح أن تمكين هذه الدول، عبر المساعدات الجزيلة، سوف يحولها إلى دول/ حواجز تحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وإلى مقر إقامة موقت، بحيث يعود المهاجر الى بلاده القريبة (سورية والعراق) في حال توقف الحرب فيها، وذلك خلافاً للمهاجر إلى بلاد بعيدة وذات مناخات اجتماعية واقتصادية وسياسية تسوغ له الاستقرار فيها.
الثغرة الأولى في هذا المشروع كمنت في شيطان التفاصيل. فقد وافقت دول المشروع على الكوتا ولكنها اختلفت عندما بدأ البحث في توزيع المهاجرين على الدول. فلقد حاولت كل دولة وافقت على هذه الصيغة تخفيض عدد المهاجرين إلى أراضيها وزيادته بالتالي إلى أراضي الغير. أما الثغرة الثانية، فقد أشار إليها بعض المعنيين في لبنان الأردن والدول التي يمكن أن تتحول الى مقر موقت للاجئين. فهذا التدبير الذي يشمل ما يقارب المليونين من المهاجرين، يتطلب هندسة سياسية واجتماعية واسعة وترتيبات لا تقتصر على هذين البلدين وحدهما، بل تطاول بعض بلدان المنطقة الأخرى أيضاً وهذا ما حد من الاهتمام بموضوع الكوتا.
الواضح في هذه المشاريع كافة، كما قالت صحيفة «نيويورك تايمز الدولية» إن ما من بلد أوروبي قادر على الاضطلاع بحل هذه القضية وحده». (17/08/2015) فمن هي الدول التي يصح أن تبحث وأن تتعاون معاً من أجل إيجاد الحلول الناجحة لقضية اللاجئين والمهاجرين؟ من البديهي أن تتحمل الدول التي تعاني من المعضلة الجزء الأكبر من المسؤولية في حلها. وهذا التوصيف ينطبق على الدول الأوروبية والعربية. وتقف المجموعتان اليوم أمام مصير مشترك يشبه إلى حد بعيد المصير المشترك الذي جمع أوروبا والولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. ففي نهاية الحرب جمع هؤلاء الخوف من الجيش الأحمر ووصول الأحزاب الشيوعية إلى الحكم في القارة الأوروبية.
هناك اليوم شيء مشترك بين الدول الأوروبية والدول العربية، ألا وهو التخوف من نتائج الأوضاع المضطربة في المنطقة العربية. إزاء هذه الأوضاع، فإن الدول الأوروبية سوف تخدم نفسها وشعوبها، كما تخدم المنطقة العربية والمجتمع الدولي، إذا قررت دعم مساعي التعاون الإقليمي بين الدول العربية. إن تقديم دعم حقيقي في هذا المضمار يساعد على تنمية تنقل اليد العاملة العربية بين بلدان المنطقة بحيث توفر على أوروبا تلقي الآثار السلبية للهجرة وللمهاجرين. إنه يسقط العديد من المبررات التي تدفع بعض الأوروبيين الى بناء القلاع والحصون والأسوار والجدران التي تسبب مرض الكلوستروفوبيا للشعوب المنفتحة. كما أن مشروعاً من هذا النوع يحول كوتا المهاجرين العرب من عبء تتهرب الدول الأوروبية من تحمله إلى مكسب تتنافس للحصول عليه. لقد تحدثت أنغيلا مركل، المستشارة الألمانية، إلى المهاجرين وإلى الألمان بلهجة دلت على نظرتها الصائبة إلى قضية الهجرة، فهل تطلق «مشروع مركل» فتؤكد أنها تملك نظرة مماثلة تجاه العلاقات الأوروبية-العربية؟