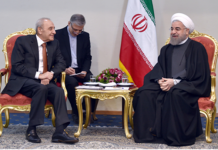Home تعليقات ومقالات مميزة عبدالوهاب بدرخان: نظام الأسد جاهز روسياً وإيرانياً لمساومات التقسيم//عبدالرحمن عبدالمولى الصلح: الأحكام...
نظام الأسد جاهز روسياً وإيرانياً لمساومات التقسيم
عبدالوهاب بدرخان/ الحياة/25 حزيران/15
سمع مبعوث الأمم المتحدة من رئيس النظام السوري، في لقائهما الأخير، أنه لا يزال يعطي الأولوية للحل العسكري على الحل السياسي. وفهم ستيفان دي ميستورا أن الشهرين اللذين استهلكهما في الاستماع الى شخصيات سورية مختلفة الانتماءات يندرجان فقط في سياسة «تقطيع الوقت» التي قامت مهمته عليها أساساً، فالحل السياسي لا ينفكّ يبتعد، مقدار تباعد الأطراف التي التقاها، ومقدار انفصال النظام عن الواقع. وكان لا يزال بإمكان بشار الأسد أن يحدد هذا الشرط، قبل عامين، وأن يكون هناك من يصدّقه، أقلّه بين أنصاره وأبناء طائفته، لكن حتى هؤلاء يجيلون في رؤوسهم السيناريوات المحتملة لسقوط الأسد وقد فقدوا الأمل تماماً بإمكان بقائه، بل يلومونه لأنه ضاعف الصعوبات المستقبلية أمامهم سواء في أمنهم أو في العلاقة مع المكوّنات الاخرى، ولأنه بات خاضعاً كليّاً للمشروع الايراني الذي يجهلون مآربه، كما أنه بدّد فرصاً لإنقاذ ما يمكن انقاذه من البلد على افتراض أن هذا كان بين هواجسه.
الواقع أن الأسد، الذي يواصل الحديث عن الحل العسكري، ربما كان يعني ما يقول، فهو منذ شرع في مجازر التهجير واقتلاع السكان، لم يعد يفكر في سورية وإنما في الأجزاء التي يريد انتزاعها من الخريطة لتكون في دويلته. وهو يدين للايرانيين في جعل هذا الهدف ممكناً، اذ كان أبقى قواته منتشرة في قواعد عبر مختلف المناطق حمايةً لمشروعه واستنزافاً للمعارضة، ولم تكن المعارك التي خاضها «حزب الله» والميليشيات العراقية بين منتصف 2012 ومنتصف 2014 لمصلحة النظام ومصلحة ايران سوى تحصين لذلك المشروع. أما الحل السياسي الذي يشير اليه فلا هو مستمد الى «جنيف 1 و2» ولا مما تتداولها مؤتمرات معارضي الداخل والخارج في موسكو أو القاهرة، بل انه يستند أولاً الى ما يعرفه الأسد عن تفاهمات بين الولايات المتحدة وروسيا، وإلى تفاهمات اميركية – ايرانية يتوقّعها بعد الاتفاق النووي.
على رغم ما يتعرّض له من خسائر، لا يبدو الأسد «قائداً» متضائلاً ومهزوماً. لماذا؟ لأن معيار الانتصار مختلف لديه، فهو منذ البداية يدير سقوط سورية بموازاة ادارته لسقوطه نفسه. فشعارا «الاسد أو لا أحد» و»الاسد أو نحرق البلد» لم يكونا من ابداعات «شبّيحة» النظام بل من «البروتوكولات» التي ربّى النظام نفسه وأنصاره عليها. فهي التي ضخّت في عسس العصابة الحاكمة «عقيدة» احتقار أرض البلد ومَن وما عليها، وهي التي أعادت أتباعها الى وحشية ما قبل البشرية وحلّلت لهم ممارسة أحطّ أنواع التعذيب والقتل والتمثيل بالجثث. ولعل تلك العصابة، بطبيعتها وأساليبها، جمعت كل تراث الارهاب من المغولي الى النازي فـ «الهاغاني الاسرائيلي»، بل بزّت الارهاب «القاعدي» واستبقت «الحشد-شعبي العراقي» ممهّدةً للإرهاب «الداعشي» ابنها الروحي…
لكن الحسابات التقسيمية للأسد قد تصحّ أو لا تصحّ، قد يكون هو موجوداً لرؤية نتائجها وقد لا يكون، إلا أن مساره الاجرامي زرع من المشاكل والأحقاد والعداوات الداخلية والاقليمية ما يجعل كثيرين يقولون اليوم، وليس الاسرائيليين فحسب، أن سورية «لم تعد موجودة». وبمقدار ما أن هذا الحُكم محبط للسوريين في المنافي القسرية في الداخل والخارج، وكذلك للعرب، بمقدار ما يقع كـ «خبر طيّب» في مسمع الأسد. فهذا يؤكد له أن الأحداث تسير في الاتجاه الذي أراده منذ اخترع «المؤامرة» لأن عقله السياسي لم يستوعب أن الشعب يمكن أن يلفظه، ومنذ اجتذب الجماعات الإرهابية «التكفيرية لإعادة ترويج «علمانيته»، بل منذ مذبحة الجامع العمري في درعا حتى مذبحة مشفى جسر الشغور وكل المذابح بينهما، وحتى تلك التي نالت من جنوده على أيدي «داعش» أو «جبهة النصرة» اعتبرها تعزيزاً لـ «استراتيجية الدويلة» التي تبنّاها وعمل من أجلها.
لم يعد أي بيان أو تصريح دولي يشير الى «سورية واحدة» أو «موحدة»، وكل الكواليس تلهج بتقويمات تصف سورية بأنها أصبحت جزراً أمنية متنازعة وقطعاً متناثرة تفرّق بينها قوات النظام: في الشمال كما في الجنوب خليط من فصائل معارضة متنافرة أو مؤتلفة، في الغوطتين الشرقية والغربية حول دمشق فصائل أخرى، في مخيم اليرموك وضع خاص حاول «داعش – فرع النظام» اختراقه، في القلمون حرب استنزاف للجميع وغير قابلة للحسم، داخل مدينتي حماة وحمص شيء وريفهما شيء آخر، الساحل قلق وشبه مستقر أما ريف اللاذقية فمتوتر حتى الغليان، حلب تنتظر معركة حسم لطرد قوات النظام لتليها مواجهة حتمية بين «جيش الفتح» و «داعش»، ادلب شهدت الانتصار المهم لـ «جيش الفتح» والسقوط الأهم لـ «جبهة النصرة» في مجزرة الدروز في قلب لوزة، الرقّة ودير الزور تحت هيمنة «داعش» الذي تلقّى تدمر كهديّة من النظام فعمد الى تلغيم مواقعها الأثرية تأكيداً لانتفاء السياحة في ربوع «دولة الخلافة»، وأخيراً ها هو «داعش» يتقايض خدمات مع «وحدات الحماية الكردية» التي تريد ربط عفرين وعين العرب/ كوباني بالحسكة تأسيساً للكيان الكردي المحاذي للحدود التركية وتمهيداً للتواصل الجغرافي بين «روج آفا» (غرب كردستان) مع كردستان العراق شرقاً، ولذلك هجّروا السكان قسراً من منطقة تل أبيض التي يعرفون أنها عربية لكنهم باتوا يسمونها «كري سبي» بالكردية.
وفي نظرة من الخارج أصبحت غالبية السوريين، وهي من السنّة، تبدو أشبه بـ «أقليات» مبعثرة في كل الأرجاء، فيما بلغت الأقليات المعروفة لحظة أكثر صعوبة من تلك التي عرفتها لدى التقطيع «السايكس-بيكوي» للخريطة وقد اصطدم آنذاك بوطنية زعماء آمنوا بالتعايش والعروبة وإمكان نشوء دولة للجميع، ولعلهم لم يتصوّروا أبداً أن يؤدي أي نكوص أو سقوط، بعد مئة سنة، الى الكابوس الأسدي الحاصل اليوم، كما لو أن سورية أمضت قرناً كاملاً في البحث عن ذاتها الى أن سقط مصيرها في يد عصابة كهذه وضعت كل فئات الشعب وطوائفه في مهب الريح.
فأقلّ ما تتبرّع به ديبلوماسيات العالم حالياً القول بأن سورية لن تقوم لها قائمة، وليس للدول المعنية بسورية أن تشكو من هذا الوضع، فهي عملت بكامل وعيها كي توصله الى مأسويته غير المسبوقة. مهما تفاوتت الخلافات بين الدول الخمس الكبرى إلا أنها بدت طوال الأزمة غير معنية بالشعب السوري أو بالأحرى غير مصدّقة أن هناك شعباً وعليها مسؤوليات تجاهه. وحتى الدول التي اشتغلت في القرن الثامن عشر على حماية الأقليات الدينية وخلخلت الدولة العثمانية لم تعد مهتمة بمن كانت لها سابقاً مصلحة في توفير الحماية لهم. على العكس، ربطوا مسيحيي العراق وسورية بمصيري صدام حسين وبشار الأسد، ورموا مسيحيي لبنان في فخ النظامين السوري والايراني، ولا يمانعون أن تطرح اسرائيل نفسها معنية بحماية الدروز، ويرتضون التخريب الايراني في بلدان العرب لمجرد أن طهران تدّعي رفع مظلومية الشيعة. لكنهم يستهجنون أن تسعى أي دولة عربية للتدخل في سورية أو أن تعرض حماية عشائرها، وسبق للاميركيين أن طلبوا من العرب أن ينسوا العراق ثم سلّموه الى ايران ولا يعارضون ابتلاعها اليمن أو قطعة منه. يعرف نظام الأسد لماذا لا يزال يقاتل لكنه يوحي للقوى الخارجية بأنه يقاتل من أجل الدولة والمؤسسات، وإذ توهمه بأنها تصدّقه فيما تقول إنه فقد كل «شرعية» فإن الكذبة تريحها وتعفيها من صداع طرح بدائل مع المعارضة. أما هذه فتقاتل أيضاً من أجل الدولة والمؤسسات لتخليصها من قبضة الاستبداد، واذا قُدّر لها أن تدركها فلن تجدها سوى هياكل عظمية. الفارق بين الاثنين أن النظام له مَن يمثله على طاولات المساومة بين اميركا من جهة وروسيا وايران في المقابل، فالكل مسكون الآن بأفكار تقسيمية تبحث عن صيغ على الخريطة. أما المعارضة فلا تعنيها مساومات كهذه، ولا تثير اهتمام الدول المتعاطفة معها، ولا يمكن أحداً، ولا حتى تركيا، أن يمثّلها فيها. لكن ورشة المساومات توشك أن تبدأ.
الأحكام القضائية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفؤاد شهاب
عبدالرحمن عبدالمولى الصلح/الحياة/25 حزيران/15
بدايةً، أسجّل أنني ضد تديين السياسة وضد التوجه السياسي للإخوان المسلمين، لأنّ الإسلام، وهو دين الحق، أكثر رحابة وسمواً من ان تحتكره جماعة من هنا وجماعة من هناك، إضافة الى اقتناعي بما ذهب اليه الشيخ علي عبد الرزاق في كتابه «الإسلام وأصول الحكم» بأنّ لا خلافة في الإسلام، وأنّ «الدولة» وإن وجدت زمن الخلفاء الراشدين، لم تكنْ «إسلامية» بالمعنى الديني. وأضيف أنّ «الإخوان» ارتكبوا أخيراً في مصر ما لا يُعد ولا يُحصى من «المعاصي» السياسية: الاستئثار بالسلطة، «أخْوَنة» البلاد والعباد، النكوص بكل التعهدات، أوّلها عدم الترشّح لرئاسة الجمهورية وآخرها سلسلة الوعود التي تعهّد الرئيس محمد مرسي تحقيقها خلال مئة يومٍ من توليه الحكم، ومنها تخفيف حجم القمامة من شوارع القاهرة!
نورد ما سبق، في ضوء أحكام الإعدام القضائية القاسية التي أصدرتها محكمة جنايات شمال القاهرة الأسبوع الماضي، وقضت بإعدام مرسي وقيادات الجماعة و104 آخرين. الإدارة الأميركية اعربت في بيانٍ عن انزعاجها الشديد من الأحكام ووصفتها بأنّها «موضوعة بدوافع سياسية». جوش إرنست متحدث البيت الأبيض قال إنّ بلاده «تشعر بالقلق العميق من الأحكام المسيسّة التي أصدرها القضاء المصري». الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عبّر عن «قلقه العميق» كرد فعلٍ على الأحكام التي صدرت. رئيس المجلس النيابي الألماني قاطع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا. أحكام الإعدام التي صدرت الثلثاء 16/6/2015، تُشكل نكسةً لتراث مصر الحضاري وانتقاصاً من الحرص على حقوق الإنسان، ولعلّها تُدرج ضمن المخالفات الجسيمة لمبادئ العدالة التي يجب أن ترعى إصدار أي حكم قضائي. داود الشريان عنوَن مقاله حول أحكام الإعدام تلك بِـ «إعدام الاستقرار في مصر» («الحياة» 17/06/2015). الاقتناع السائد، أنّها أحكام سياسية في الشكل والمضمون، وأنّها بالنتيجة خاضعة لمزاجية سياسية. ولعلّ الابتسامة التي علت وجوه المتهمين وهم في قفص الاتهام، يصغون إلى ما نطق به القاضي، تشي بعدم اكتراثهم بالأحكام التي صدرت. وهنا تحضُرُني أحكام البراءة التي صَدَرَت أخيراً بحق الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وأبنائه، مع مسؤولين سابقين، والتي هي على تناقض تام مع الأحكام القضائية التي صدرت قبل عامين والتي دانت مبارك وجماعته.
إعدام جمال عبد الناصر أوائل الستينات سيد قطب زعيم الإخوان المسلمين آنذاك، لم يؤدِّ الى الاستئصال السياسي للإخوان، بل زادهم نفوذاً. وأميلُ إلى الاعتقاد أنّ الأمر نفسه سيحدث اليوم. لا يمكن دحض فكرٍ إلاّ بالفكر وبالحجة المضادة، علماً أنّ حرية الرأي والتعبير لا يجب أنّ تكون محلّ خلاف. ولكنّ الأمر في مصر وصل الى حد التخوين، فإذا كنت مع توجهات النظام فأنت وطني، وإذا كنت إخوانياً، فأنت خائن. كان من المؤمل بأن يكون الجيش المصري عقب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، حامي الديموقراطية، لكنّ، يبدو أنّ قدر مصر، منذ ان تولّى «الزعيم الخالد» جمال عبد الناصر الحكم، أن تُسَلِّمْ زمام أمرها للمؤسسّة العسكرية… والثابت كما يُشير خالد فهمي أستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية في القاهرة في كتابه «كلّ رجال الباشا»، أنّ الدولة المصرية، منذ عهد محمد علي، كانت في خدمة الجيش، لا العكس! وللتذكير فقط، فالمؤسسات التابعة للجيش المصري تشكل 30 في المئة من الاقتصاد القومي المصري ونفوذه يمتد الى قطاعات مختلفة.
أيُّ مراقبٍ لما آل إليه الوضع في مصر، يلحظ قبضةً بوليسيّة تتحكم برقاب العباد، وأنّ الجهد منصبٌ على قوننة العمل السياسي وتجفيفه، وصولاً إلى إلغائه، ما يزيد من الاحتقان السائد، بدل العمل على تنفيس ذلك الاحتقان وتعزيز آليات العمل الديموقراطي. التقارير الصحافية تُشير إلى أن 163 حالة إخفاء قسري او احتجاز من دون تحقيق تمّ رصدها في مصر في 22 محافظة منذ نيسان (ابريل) 2015، بينها 60 حالة اخفاء قسري وفقاً للمعايير الدولية و31 حالة من دون متابعة، و64 حالة إخفاء قسري منتهية، حيث تمّ التأكد من ظهور المعنيين بعد مرور أكثر من 24 ساعة على احتجازهم من دون وجه حق، ورد ذلك في صفحة «الحرية للجدعان» (مجموعة من المحامين المتطوعين) التي حدّدت مصادرها بدقة. (زينب ترحيني، «السفير العربي» في18/6/2015).
أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضي، ذكّرتني «بأجواء» محاكمة أخرى، هي نقيض أجواء محاكمات القاهرة، علماً انّ المتهمين دينوا بمحاولة انقلاب. كان ذلك ليل 30- 31 كانون الأول 1961، حين قام الحزب القومي السوري بمحاولة انقلاب لإطاحة فؤاد شهاب، رئيس الجمهورية آنذاك. بلغ عدد المشاركين في المحاولة الانقلابية 179 فرداً، منهم 11 عسكرياً، بينهم ثلاثة ضباط. شكلّ الانقلاب هاجساً لدى الطبقة السياسيّة اللبنانية. فسُمعت أصوات وكانت طاغية، تطالب بإعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ومن ثمّ إحالة الانقلابيين على محكمة عسكرية خاصة. لكنّ الراحل الكبير الرئيس اللواء فؤاد شهاب، العسكري/ الديموقراطي، وفق ما وصفه الراحل غسان تويني، رفض تلك الدعوات. بل، أكثر من ذلك، أصرّ على ان تنظر محكمة التمييز العسكرية برئاسة قاضٍ مدني (أميل ابو خير) وعضوية ضباط عسكريين، بأحكام الإعدام التي سبق أن أصدرتها محكمة عسكرية ابتدائية. وفي ضوء مخالفة رئيس المحكمة أميل ابو خير أحكام الإعدام – لأنّه اعتبر انّ الجريمة هي جريمة سياسيّة – رفض الرئيس شهاب توقيع مراسيم الإعدام تأييداً لقرار القاضي أميل ابو خير. في نهاية عهده، أصدر الرئيس شهاب مرسوماً قضى بإبدال عقوبة الإعدام بالحكم المؤبد. ولاحقاً، في عهد الرئيس شارل حلو، والذي يُعدّ في بداياته تتمّة لعهد الرئيس شهاب، صدر عام 1969 قانون عفو شامل عن المحكومين. (راجع مسعود ضاهر، «محاولة الحزب القومي الانقلابية عام 1969» ، «النهار» 6/7/2003). ليتَ أصحاب الشأن في مصر العزيزة يحذون حذو الرئيس اللبناني الراحل شهاب، (وهو القائل في خطاب القسم، 23/9/1958 «بين مركز قيادة الجيش حيث الصمت رفيق الواجب، ومنبر هذه الندوة حيث الكلام هو السيد»)… الذي حرصَ على عدم إراقة الدماء تعزيزاً للعمل الديموقراطي والوحدة الوطنية. فالقضاء اللبناني، وفي حالة «الحزب القومي السوري»، الذي قاد انقلاباً ضد الحكم (وهو ليس حال مرسي وجماعته الذين لم يقوموا بانقلابٍ عسكري) وظّف كآلية للإصلاح وليس للانتقام او التشفّي. وكم نتمنى من صميم القلب ان تسري الأمور في هذا المنحى في مصر العزيزة والتي يُعتبر استقرارها محطّ أنظار العرب، كلّ العرب!