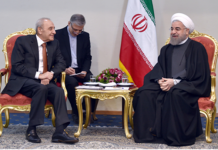«الأردن الكبير»… والدرس اللبناني
حازم الامين/الحياة/21 حزيران/15
قال الكاتب الأردني فهد الخيطان، في سياق تحفّظه عن مقولة «الأردن الكبير»: «لا نريد أكثر من الأردن»، وذكّر الخيطان أصحاب المقولة بالتداعيات المُدمّرة لـ «مقولة موازية» عن «حزب الله الكبير» بعد أن خرج الحزب من لبنان إلى سورية. لكن الخيطان ليس الصوت الوحيد الذي صدر عن وطنية أردنية معترضة على توسيع المهمة الأردنية لتشمل جنوب سورية وغرب العراق. ثمة أصوات أخرى صدرت عن وطنية أردنية أيضاً، لكنها وطنية مثلومة بشحنة شرق أردنية، ولا تخلو من نزق طائفي. فأن تكون متحمساً لقتال حزب الله في سورية، ومتحفظاً عن دور لبلدك خارج الحدود، فهذا يعني أنك تحب بلدك وتكره لبنان، وهذا داء مستفحل في اليسار العربي الذي لطالما شكّل لبنان تحدياً لمقولاته. هذا النقاش يصلح للتأمل بـ «المهمة الأردنية» بعد ظاهرة تسلّم الملك عبدالله الثاني الراية الهاشمية في عيد الجلوس السادس عشر. وهو نقاش صحي على كل حال، إذا ما قورن بغياب النقاش اللبناني حول مهمة حزب الله في سورية. ذاك أن مقالات قليلة معترضة على هذه المهة لا تعني نقاشاً. أما في الأردن، فالمهمة خارج الحدود لم تبدأ على نحو مباشر، ولم يتخطَّ جندي أردني الحدود بعد، ولعبة الرموز (استحضار الثورة العربية الكبرى والراية الهاشمية) ما زالت في مستواها الداخلي. والحال أن المملكة وجدت نفسها وسط فراغ سنّي كبير وهائل يعصف بالبادية الشمالية والغربية، وفي هذه الصحراء لا بد من نفوذ، وإلا تسرّب «داعش». لكن هذه المقولة تصلح أيضاً لاستخدامات أخرى: أليس حزب الله كان باشرها وارتدّت وبالاً عليه وعلى لبنان، وهنا يبدو تذكير الخيطان في مكانه تماماً.
نعم، أدارت المملكة ما يعنيها من الملف السوري خلال السنوات الأربع الفائتة، على نحو أكثر حكمة ودراية مما أداره حزب الله. لم تذهب مع أحد إلى الأخير. أعلنت أنها جزء من الخيارات العربية، وأن النظام في سورية فقد أي شرعية، لكن ذلك لم يُملِ عليها خطوات ميدانية تُهدد استقرارها. أبقت على السفارة السورية في عمان، ولولا خروج سفير النظام بهجت سليمان، عن آداب العلاقات الديبلوماسية، لكان مقيماً حتى اليوم هناك. وفي مقابل ذلك، احتضنت المملكة فصائل سورية تقاتل النظام في الجنوب وصولاً إلى ريف دمشق. كان المطلوب ألا تُهزم هذه الفصائل، ولكن ألا يسقط النظام قبل تبلور بديل غير مُهدِّد لاستقرار المملكة. فعلت المملكة ذلك مستفيدة من رعاية أميركية لهذه الوجهة. وفعلته أيضاً مُدركة أنه لا بد من صيغة للتعامل مع ترنّح النظام في دمشق. فأحياء قليلة في عمان تفصل بين مقاه يتجمّع فيها معارضون سوريون للنظام، ترعاهم أجهزة المملكة الأمنية والسياسية، عن السفارة السورية التي تتولّى تصريف الأعمال القنصلية لعشرات آلاف من السوريين اللاجئين.
هذه الواقعية المفرطة، كانت حصيلة خبرات تحصّلت من تعامل الأردن مع موجات النزوح الهائلة التي عصفت بعمان منذ إعلان إمارة شرق الأردن. النزوح السوري هو النزوح الرابع، إن لم يكن الخامس. نزوحان فلسطينيان كبيران قي 1948 و1967، ونزوح عراقي في 2003، والنزوح السوري اليوم. وتخلّلت هذه النزوحات الكبرى نزوحات صغرى، كنزوح الإخوان المسلمين السوريين إلى عمان في 1982 وهو بلغ عشرات آلاف العائلات، ونزوح الفلسطينيين من الكويت في 1991، والذي تجاوزت كتلته البشرية مئتي وخمسين ألف فلسطيني.
إذاً، القول إن عمان لا تتّسع لمشروع «الأردن الكبير» صحيح، لكنه غير واقعي. فوظيفة الأردن لطالما كانت أكبر من الطموح «الوطني» في العيش في مملكة هذه حدودها. المنطقة لطالما طافت على المملكة من دون رغبة هذه الأخيرة، وكانت مهمة الدولة العميقة هناك امتصاص هذه الطوفانات من دون أوهام تضخم الدور.
اليوم، ما تغيّر ليس تضخماً في شعور المملكة بنفسها وبقدرتها، فالانتقال من الدور الاستيعابي إلى المبادرة خارج الحدود ربما أملته معطيات مختلفة، تتعلّق بالمهمة الأردنية نفسها. وأن يذهب العاهل الأردني إلى البادية ليعلن منها أن حماية العمق العشائري الشرقي والشمالي هي مهمة القوات المسلّحة أيضاً، فهذا ليس إعلاناً لتجاوز الحدود، على نحو ما أعلن حسن نصرالله تجاوز الحدود اللبنانية، إنما التذكير بأن التوازن خارج الحدود جزء من أمن المملكة، وأن ما يتقدّم في أولوياتها هو مصلحتها في حدودها الراهنة، لا أكثر.
في عمان، تسمع من يقول لك أن لا مستقبل للنظام في سورية، وأن السلطات تتعامل مع هذا الأمر بصفته حقيقة وواقعاً، لكنك تسمع أيضاً أن لا مصلحة لأحد بأن يسقط بشار الأسد قبل تبلور بديل، وقبل وجود خيار لما بعد السقوط.
لكن يبدو أن عمان أدركت أخيراً، احتمالات دراماتيكية سورية. فهي تشعر أن النظام في سورية يُخلي بإرادته الساحة لـ «داعش»، وهو استهدفها بانسحابه من تدمر، حيث أصبح «داعش» على بعد نحو 15 كيلومتراً عن الحدود مع الأردن. العدة الرمزية التي استحضرت في احتفالات عيد الجلوس، تؤشّر إلى أن الحديث عن المهمة خارج الحدود يهدف إلى التعامل مع هذا الاحتمال، لا إلى وهم «الأردن الكبير». «الراية الهاشمية» و «الثورة العربية الكبرى» في مواجهة تحديات «الخلافة» وراياتها وإغراءاتها.
المتغيّر أن النظام يمكن أن يهوي من تلقائه، لا سيما في مناطق على الحدود مع الأردن، وهي تبلغ نحو 385 كيلومتراً. وعمان مختبر معلومات على هذا الصعيد، وهي تتحوّل بفعل الواقعية المفرطة في المملكة إلى برامج عمل منزوعة من مؤشرها العاطفي ومضامينها القيمية.
تدرك الدولة الغامضة في عمان، أن الدفع بـ «داعش» إلى الحدود مع الأردن هو من الأسلحة الأخيرة للنظام في سورية، وهذا أمر لم يكن جزءاً من المعادلة التي أقامتها معه منذ بداية الثورة في سورية. ومثلما تحوّلت إلى وعاء لاجئين طاف على موقعها وعلى حجمها، لا بد من الاستعداد لطوفان آخر وشيك سيحمل للأردن، إذا لم يستعدّ له، حملة الرايات السود.
المسألة هنا مختلفة تماماً عن اجتياز حزب الله الحدود اللبنانية. الحساب الأردني هنا يتقدّم الوظيفة الإقليمية للمملكة.
مفارقات في المشهد السوري المعارض
أكرم البني/الحياة/21 حزيران/15
ثلاث مفارقات يمكن التوقف عندها اليوم في قراءة واقع المعارضة السياسية وما تعانيه من قصور في ممارسة دورها المفترض أمام التطورات الميدانية المتسارعة في المشهد السوري. أولاً، بينما تستعر المعارك على أشدها في الجنوب والشمال السوريين، لا تزال أطياف من المعارضة السياسية تهتم بعقد المؤتمرات، وآخرهما في مصر وتركيا! وكأن ما يجري لا يعنيها، وكأن ما تم عقده من مؤتمرات خلال السنوات المنصرمة لم يكن كافياً، فكيف الحال حين يبدو غرض هذه المؤتمرات إعادة تقاسم الحصص والمواقع، طالما لا تضيف قراراتها جديداً من حيث الجوهر الى المواقف السياسية المعلنة للمعارضة في وثيقتي القاهرة في 2012، وطالما تكرر الالتزام بخيار الحل السياسي وفق بيان «جنيف 1» وقيادة مرحلة انتقالية تؤسس لدولة المواطنة الديموقراطية.
ولكن على من تعول المعارضة السورية في تحريك عجلة الحل السياسي؟! هل على ضعفها وتشتتها وانفلات القتال على مختلف الجبهات؟! أم على تشدد النظام سياسياً وإعلانه خطوطاً حمراً للتفاوض لا يمكن المساس بها تتمثل بالدستور ورئاسة الجمهورية والجيش وأجهزة الأمن؟! أم على تقدم تنظيم داعش وتبلور الطابع الإيديولوجي الاسلاموي لمختلف الجماعات المسلحة التي لن ترضى بغير شرع الله حاكماً؟! أم على استمرار تضارب مصالح الأطراف الإقليمية والعالمية المؤثرة في الصراع السوري وتالياً عجز المجتمع الدولي عن خلق إرادة حازمة تضع حداً لهذه المأساة؟!
للأسف يكرر بعض قادة المعارضة فكرة تقول بأن أي صراع مسلح أو قتال أهلي لن يخمدا إلا بحل سياسي، ويعتقدون بأنهم كمعارضين سياسيين أصحاب الحق في هذه النقلة، وما عليهم سوى الانتظار وترتيب أنفسهم وتأكيد حضورهم في المناورات الإقليمية والدولية كي يكونوا أصحاب الكلمة الأعلى في هذه المهمة، غافلين عن ارتباط دورهم السياسي بالوزن الشعبي الذي يحوزونه على الأرض، وعن استحالة أن تمنحهم الجماعات المسلحة ثقتها وهي القادرة على خلق كفاءات سياسية تمثلها، بخاصة أنه لا يخفى على أحد أن هذه الجماعات تجد المعارضة السياسية مارقة ومنتفعة، أو ملحدة تريد استبدال شرع الله بنظام الكفار الديموقراطي، مستثنية قلة من المعارضين بدأوا يداهنون هذه الجماعات ويدافعون عن معاركها ومسلكياتها ويغازلون صحة خياراتها الإيديولوجية والسياسية!
ثانياً، تعجب من معارضة دأبت على المطالبة بوقف العنف كمقدمة للشروع بحل سياسي، لكن بعضها الذي تفتنه اليوم «انتصارات» الجماعات المسلحة، صار من أشد المطالبين باستجرار سلاح نوعي للمقاتلين، ومن أكثر المتحمسين للحسم العسكري، من دون تحسب لدور سطوة القوة العارية في تنحية الحقل السياسي أكثر فأكثر وتهميش المجتمع المدني وتدمير الحاضنة الشعبية وخسارة فئات لها مصلحة في التغيير الديموقراطي لكنها ترفض منطق العنف والسلاح!
ويفاجئك من معارضة دأبت طوال سنوات على تقديم خطاب جامع حول الشعب الواحد وحقوق المواطنة المتساوية وتصمت بعض فصائلها عن فرض نمط الحياة الاسلاموية إرهاباً على الناس، وعن الانتهاكات التي تمارس بحق المختلفين دينياً ومذهبياً، والأنكى حين يعتبر بعض قادتها ما تم من اندفاعات عدوانية ضد منتمين لأقليات مذهبية، مجرد أخطاء عابرة يمكن تجاوزها، مكررين خطاب التطمينات عن الإسلام الرحيم والعادل، وأيضاً الاتهامات بحق كل من ينتقد ما يجري من تجاوزات، بأنه متخاذل أو خائن للثورة غرضه التعمية عن عنف النظام وتأجيل أولوية مواجهته وتغذية الفتنة التي يحاول زرعها بن الأديان والمذاهب! وتستغرب كيف توصلت فصائل مسلحة تختلف بمرجعياتها الدينية إلى توحيد صفوفها في ما يسمى جيوش الفتح وإعلان مراكز مشتركة لقيادة معاركها، بينما لا تزال المعارضة السياسية عاجزة عن توحيد صفوفها أو ضبط إيقاع نشاطاتها، ولا تزال أطراف منها تزدري الأطراف الأخرى وتتبادل الاتهامات وأحياناً الشتائم بسبب التنازع على موقع أو منصب أو لمجرد الاختلاف في الرأي أو الاجتهاد!
ثالثاً، بينما تلتحق بالجماعات الجهادية الآلاف من الكوادر والكفاءات من الدول العربية والغربية لنصرة مشروعها الاسلاموي، يتناقص بشدة الوجود السياسي والمدني المعارض في البلاد، وإذا كان أمراً مفهوماً أن يخفت الرهان على جدوى العمل من الداخل وأن يتراجع معارضون عن وعودهم بالعودة الى الديار بسبب تفاقم الأوضاع وخطورتها، فأمر غير مفهوم أبداً إهمال التواصل مع ملايين السوريين في مخيمات اللجوء وعدم خلق قنوات سياسية ثابتة ومستقرة للتفاعل معهم بما في ذلك انتقال بعض الكوادر والقادة للعيش بينهم، ليس فقط لتخفيف همومهم ومعاناتهم وضمان سلامة إغاثتهم، وإنما أيضاً لكسب ثقتهم وتحصينهم، قولاً وسلوكاً، بالروح الوطنية والديموقراطية في مواجهة قوى متطرفة تبذل جهوداً حثيثة لجرهم الى أجندتها.
أخيراً، لا يضاف جديد عند وضع المسؤولية على النظام في ما وصلت إليه الأوضاع بتنكره لأسباب الصراع السياسية ولجوئه الى القمع والعنف المفرطين، أو إرجاع الأمر إلى سلبية المجتمع الدولي وتقصيره في وضع حد لهذه المحنة، أو القول، لتخفيف عمق المأساة، بأن الشعوب لا بد أن تدفع إثماناً باهظة لقاء تحررها. فما يجب أن يتضح في ضوء المفارقات السابقة هو المسؤولية التي تتحملها المعارضة السياسية أيضاً، ولا نقصد هنا إحلال الرغبات مكان الواقع بل رؤية ما كان يمكن أن ينجز ولم ينجز وتالياً المبادرة لتصحيح ما يمكن تصحيحية قبل فوات الأوان، إن لجهة اهتمام المعارضة السياسية بمعاناة الناس وما يكابدونه والتواصل معهم وبذل ما يفترض من جهود مخلصة لنيل ثقتهم ودعمهم، وإن لجهة مراقبة مسلكياتها لتقديم صورة صحية عن معارضة تقرن أقوالها بأفعالها وتظهر مسؤوليتها السياسية والعملية بتبني الخيار الديموقراطي وجاهزيتها للدفاع عنه والتضحية في سبيله، ضاربة المثل بنبذ الأساليب الخاطئة والتآمرية في إدارة خلافاتها واحترام التعددية والمشاركة والالتزام بقيم الحرية وحقوق الإنسان.