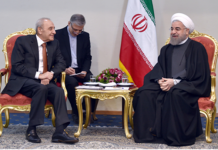من الأناضول إلى لوس أنجليس مروراً ببيروت
يوسف بزي/المستقبل/27 نيسان/15
تروي أمي ماري (أو مارو، باللغة الأرمنية)، أن عائلتها من جهة والدتها هربت من المذبحة العثمانية عام 1915، مشياً على الأقدام من نواحي الأناضول، مجتازة جبال طوروس باتجاه مدينة حلب. وفي روايتها، أن أمها ولدت على ذاك الطريق، المليء بالأهوال وقطاع الطرق والعصابات، التي كانت تنقض على قوافل اللاجئين نهباً أو قتلاً و»سبياً».
ولا تخلو رواية أمي من حكايات يشترك فيها الكثير من الأرمن، عن جرار الذهب التي كانت تكنزها العائلة، وعن المؤن التي نهبها العسكر العثماني، وعن الفتيات اللواتي اغتصبن، وعن المشانق التي كانت تنتشر في ساحات البلدات والمدن، وعن عصابات الكرد والبدو العرب، الذين كانوا يغيرون على الناجين في السهوب الواسعة.
كانت قصة والدتي تشبه إلى حد كبير ما صوره إيليا كازان في تحفته السينمائية «أميركا.. أميركا» (1963)، عن عالم القسوة والخوف والإضطهاد في الحقبة الأخيرة من الزمن العثماني.
ولدت أمي في دمشق، من أم أرمنية وأب مسيحي لبناني، وترعرعت في حي الأشرفية ببيروت وسط عائلة أمها. فلم تتعلم العربية إلا بالمقدار الذي اتقنه معظم الأرمن من كلمات يومية، ركيكة على الأغلب. وكان قدرها، في سن مراهقتها، أن أحبت شاباً مسلماً شيعياً، كان هو بدوره من الجيل الذي اضطر في مطلع الخمسينات إلى هجران الجنوب اللبناني نحو العاصمة، بعد أن نزلت «نكبة» فلسطين ككارثة على جوار بنت جبيل، إذ اقفلت الحدود الفلسطينية، وانتهت كل تجارة وكسدت الاسواق وتضاءلت موارد الزراعة وبدأت بيروت تبث إغراءاتها.
في ذاك الزمن، مع تدفق اللاجئين الفلسطينيين المنكوبين إلى لبنان، وبدء الهجرة الريفية إلى المدن، تزوج أبي محمد، الشاب الفقير، من المراهقة القاصر ماري، وهربا سوية إلى حي النبعة، موطن المهاجرين الجنوبيين الشيعة الجديد، الذي سيسمى «حزام البؤس»، المجاور لحي برج حمود، موطن الأرمن الذين استوطنوا هناك بعد المذابح العثمانية.
تروي أمي كيف أن الدرك أوقفها ووالدي في المخفر، بتهمة الخطف والزواج من قاصر من دون موافقة أهلها. كيف أن راهبات مدرستها أتين إليها في المخفر يعرضن صور شبان مسيحيين لتنتقي أي واحد منهم وتتخلى عن هذا الشيعي محمد، لكن من دون جدوى.
تروي «مارو» أن أهلها أنكروها بعد هذا الزواج وقطعوا كل صلة بها، حتى بعد أن أصبحت أماً لثلاثة أطفال، بل إن إخوتها وأخواتها لم يحاولوا مرة أن يلتقوا بها، وكأنها لم تولد أصلاً. وهي بدورها أقامت قطيعة تامة بهم، رغم أنها كانت حريصة على تذكيرنا نحن أولادها بأسمائهم، ومن منهم الأكبر أوالأصغر، راوية لنا قصصاً عن جدتها ووالدتها وأبيها الذي نادراً ما كان يأتي إلى المنزل، هو الذي يدير فندقاً في دمشق، حسبما أتذكر من أمي.
لم تتصل أمي بأهلها، بعد مقتل والدي بالحرب عام 1975، ولم تعرف عنهم شيئاً في خضم جولات القصف والتهجير والخطف والقتل. كانت حينها أرملة عنيدة، مليئة بالمرارة والقسوة والغضب المكتوم. وحين دخلت الميليشيات المسيحية إلى النبعة، هربت بنا إلى أحياء الأرمن في برج حمود. يومها، لم أسمع من أمي أي كلمة عربية. استعادت بغتة لسانها الأرمني، وراحت تتصرف بوصفها أرمنية. ويومها أيضاً كان الأرمن يستقبلون كل الهاربين من النبعة، ويحمونهم، كما لو أنهم يستعيدون صور ما حل بهم وبأهلهم قبل ستة عقود من ذاك الزمن (1976). لكن هذه المرة كان المنكوبون مسلمين وكرداً وعرباً، لبنانيين وفلسطينيين..
فقط، وبعد انتهاء الحروب اللبنانية، ذهبت أمي لأول مرة منذ عقدين إلى الأشرفية، تبحث عن عائلتها وأقاربها وجيرانها السابقين. ذهبت من دون أن تخبرنا، لتعود خائبة، إذ علمت أن أهلها هاجروا إلى لوس أنجليس، ككثير من الأرمن اللبنانيين، في مطلع العام 1975، ليستوطنوا هناك مع المهاجرين الآخرين الآتين من أصقاع الأرض إلى أميركا: عرباً ولاتينيين وصينيين وفيتناميين وكوريين وما لا عد له من أقوام وإثنيات.
في مطلع التسعينات أيضاً، انتبهت أن معظم عائلة أبي وأقاربه باتوا هم أيضاً مهاجرين إلى ديترويت في أميركا، حتى أن أخي بدوره بات مهاجراً إلى هناك. ولست أدري لما استدعي دوماً فيلم «أميركا.. أميركا» كلما تفكرت في سيرة تلك العائلات وفروعها، عائلتي الإفتراضية، أهلي «الوهميين» الذين لم أعرفهم حقاً.
ليست هذه سيرة شخصية إطلاقاً، إذ أن دورة المجازر والنكبات والتهجير القسري وحروب الإبادة، وحكايات جرار الذهب واغتصاب النساء وقطع الرؤوس وإفناء القرى وتدمير المدن، لم تتوقف يوماً، منذ «المذابح الأرمنية» المتزامنة مع المذابح والمجاعات التي لحقت بالأشوريين والكلدان والإيزيديين والسريان ومسيحيي جبل لبنان.. وهي ستتكرر مع نكبة الفلسطينيين الذين دفعوا ظلماً ثمن الذنب الأوروبي في «الهولوكوست«، وسنشهدها في حروبنا الأهلية على امتداد الخريطة العربية من جنوب لبنان وجبله إلى دارفور السودان، وستتكرر مع «حملة الأنفال» التي حاولت إبادة الكرد واقتلاعهم من أرضهم، وها هي اليوم تصيب ملايين السوريين الهائمين في البلاد المجاورة أوالغرقى في مياه البحر.
وكما حكاية أمي، يبدو أن «الضحايا» أيضاً لا يعرفون كيف يتعايشون مع بعضهم البعض.