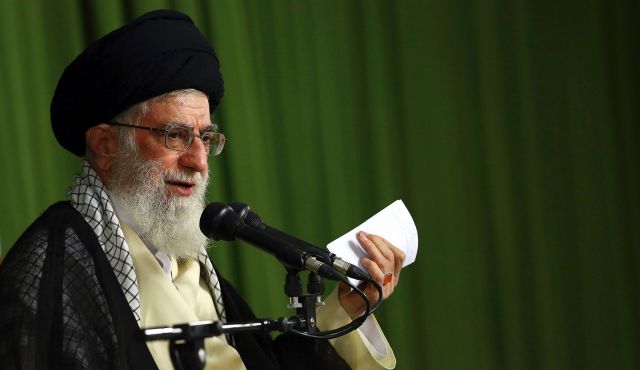هل الشيعة محكومة أبديا بتعذيب الذات؟!
غسان الإمام/الشرق الأوسط/02 كانون الأوسط
هل تبقى الشيعة محكومة، أبديا، بظاهرة الجلد وتعذيب الذات؟! سؤال كنت أطرحه، بمنطق الغرابة والحسرة، على أصدقاء أعزاء من شيعة مثقفين وعاديين، في دمشق وبيروت، كلما طفح أمامي موسم عاشوراء، بالدماء المتدفقة من الرؤوس الحليقة المشطوبة بالمدى والخناجر. والظهور المشقوقة بسلاسل الحديد. بشيء من الفكاهة «العلمانية» الممزوجة بخجل مريب، كان الأصدقاء المثقفون، ومعظمهم ينتسب إلى أحزاب سياسية «كافرة»، في تلك السنين الخوالي يجيبون بأن «أعراف» عاشوراء من لزوميات ما لا يلزم، ما دام أن هناك شيعة تشعر بندم تاريخي مزمن، على عدم نجدة وإنقاذ آل البيت، قبل كذا من مئات السنين. أما الصحاب الشيعة العاديون، فكانوا يجيبون بأن لولا محبة آل البيت لما كانت هناك شيعة. ثم يتحسسون رؤوسهم المشطوبة، وكأنهم يتأكدون أنها ما زالت موجودة، في زمن لم يكن، بعد، يعرف ظاهرة الرؤوس المقطوعة. تذكرني «خناقاتي» الفكاهية مع الأصدقاء الشيعة بـ«خناقة» الرئيس اللبناني فؤاد شهاب مع صديقه رئيس الحكومة صائب سلام. وقد رويت سابقا للقراء الأعزاء حكاية الجدل الذي كان يحتدم في مجلس الوزراء حول «حقوق» الطائفة الشيعية التي تعتبر نفسها مظلومة في التسوية التاريخية بين السنة والموارنة التي قام على أساسها استقلال لبنان، ولم يقعد بعدها.
كان الرئيس الماروني يقول للرئيس السنِّي: «إذا كانت هناك حقوق للشيعة، فليأخذوها من السنّة». وكان صائب بيك يردّ ببلاغته المعهودة: «وماذا يعطي المغبون للمحروم يا فخامة الرئيس؟!». والجواب دلالة على أن السنة لم تكن راضية عن تلك التسوية إلا بعد أن أصلحها اتفاق الطائف، بتحقيق توازن سلطوي بين الطوائف الثلاث السنة. والشيعة. والمسيحية. السنة لم تتملكهم ثقافة الأضرحة والموتى. وهم يترحمون على علي بن أبي طالب ونجليه الحسن والحسين، بقدر ما يعتزون بمعاوية الذي انتقل إلى دمشق، كعاصمة سياسية وحضارية، لأقوى دولة في العالم آنذاك.
كصحافيين، كنا نتجنب نشر صور مواكب عاشوراء البشرية الدامية. بل كانت المرجعيات الدينية الشيعية تؤثر عدم النشر. وتطلب ذلك من الصحافة. أين أمس من مواكب عاشوراء اليوم التي تبدو القيادات السياسية والدينية الشيعية، وخصوصا في العراق، أنها وراء تنظيمها وسوقها؟! أذهب إلى القول إن هذه المراجع الطائفية تتحمل المسؤولية عن عدم تأمين سلامة عشرات ألوف الساعين الذين يتجهون إلى الأضرحة، أو إلى حتفهم قبل الأوان، وذلك على قدر مسؤولية المجهولين الذين يدبرون الانتحاريين الذين ينسفون هذه المواكب، بلا رحمة. وبلا اعتبار للنواهي الدينية المقدسة عن الثأر والانتقام، باستخدام العنف. والقتل المتعمد.
بات الإنسان أداة رخيصة للدعاية الاستفزازية، في الإعلام الموجه لخدمة الأغراض السياسية لأنظمة الطوائف. نكايةً بمشاعر السنة، فقد سمح نظام بشار للقوات والميليشيات الإيرانية بتنظيم موسم علني لعاشوراء في دمشق، وذلك ربما للمرة الأولى في تاريخها.
في المقابل، تنظم «داعش» مشاهد تلفزيونية لقطع الرؤوس. وكأنها لا تدري أنها تسيء بوحشيتها ولا إنسانيتها إلى الإسلام السنِّي أمام العالم كله. بل تقول إنها تتعمد ذلك، لحفز أميركا وأوروبا على إنزال جيوشها في ديار الإسلام! متجاهلة بغباء ما حل بسوريا. وفلسطين. ومصر من مجازر. ومذابح. وتدمير. وتخريب، خلال ثلاثة قرون من الهجمات الصليبية المدعومة بالكراهية الدينية والعنصرية للعرب والإسلام.
لماذا وكيف تدهورت الانتفاضات، من تظاهرات سلمية خجولة إلى هذه الحروب الدينية والسياسية، بكل ما يرافقها من استفزازات متبادلة، حتى بين الطوائف المعارضة للأنظمة؟ في الخلفية البعيدة، هناك الفقه الديني المتزمت غير المؤهل، بعد ثلاثة قرون صليبية، للتعامل مع المجتمع والعالم وفق أنظمة وشرائع القانون الدولي.
في الأسباب المعاصرة، هناك أنظمة فقدت كبرياء المسؤولية الأخلاقية في التعامل مع مجتمعاتها. ثم هناك الفشل المروع في التعليم الرسمي. والتربية العائلية. وخطط التنمية. وتخطيط الأسرة. كل ذلك أدى إلى إنتاج أجيال فالتة شبه أمية، من صلب آباء لا يجيدون سوى إنتاج الأطفال، بلا معرفة أو قدرة على تربيتهم. ثم هناك جامعة لا تنتج سوى شباب ينتظرون تلقي وظيفة حكومية، فتتلقفهم البطالة التي قد تدفعهم مع فقدان الأمل، إلى حشر أنفسهم في تنظيمات الفاشية الدينية.
تقية النظام في الخوف من مرجعيته الدينية التقليدية دفعته إلى صرف النظر عن تخطيط الأسرة. فازداد عدد المصريين في عهد الرئيس مبارك 40 مليونا. وتضاعف عدد الجزائريين ستة أمثال في خمسين سنة (37 مليونا). والحال في المغرب مشابه للحال في الجزائر.
لم يحظ الرقم الرسمي، بعد، بالاحترام في الدول العربية المعاصرة. وما زال الشك يساور المواطن في مصداقية هذا الرقم ودقته. وأروي هنا للقارئ حادثة قديمة العهد تؤكد صحة ما أقول. ففي أول زيارة لعبد الناصر إلى دمشق بعد قيام الوحدة المصرية / السورية، استدعى مصطفى حمدون وزير الإصلاح الزراعي في الإقليم الشمالي (السوري).
قال الرئيس للوزير بغضب وانفعال: «إيه ده يا مصطفى. انتو توزعوا أراضي على الفلاحين قد مساحة سوريا مرتين؟!»، ثم سحب عبد الناصر من حقيبته ملفا لتصريحات وبيانات المكتب الصحافي في الوزارة يتضمن الأرقام المبالغ فيها.
وكان مصطفى حمدون يحرص على نزاهة سمعته. فقد كان ضابطا كبيرا في الجيش. وشارك في قيادة الانقلاب العسكري الناجح على ديكتاتورية أديب الشيشكلي (1954). وعندما قامت الوحدة، فعل عبد الناصر خيرا. فقد سرح كل ضباط السياسة والآيديولوجيا من الجيش السوري. وبينهم مصطفى حمدون الذي كان محسوبا على زعيمه الاشتراكي أكرم الحوراني. لكنه أسند مناصب وزارية لبعض الضباط المسرحين، لإرضائهم. وكسبهم إلى جانبه. على كل حال، راجع حمدون أرقام مكتبه الصحافي، ثم أمر بتسريح مديره.
وبعد، قد تسألني يا قارئي العزيز عن حل، لكل هذه الكوارث التي نزلت بنا. أجيب بأن الكاتب الصحافي لا يملك حلا لكل هذه الكمية الهائلة من التراكمات والتعقيدات في السياسة. والمجتمع. والطائفة. الصحافي مجرد ناقد يتولى توصيف إشكالية أو إشكاليات حياتنا الاجتماعية والسياسية. أما الإصلاح فهو مهمة الذين يقولون ويعملون في الميدان. أقصد هذا الجمع الغفير من الدارسين. والباحثين. ورجال البيروقراط والتكنوقراط الذين يملكون الخبرة والتجربة.
الكاتب الصحافي لا ينصح. ولا يتفلسف. فهو ليس بمعلم مدرسة. لست مصلحا إداريا أو اجتماعيا. ولا أبالي أن أغادر هذا العالم كما وجدته. إنما الصحافي ناقد يمارس واجبه. لكن لا أخجل شخصيا من الاعتراف بأني أدخلت الرقم على المقالة السياسية. انتقدني الكثيرون. فقد اعتبروا الرقم متطفلا على التحليل السياسي. قالوا إني حولت المقالة إلى ريبورتاج (تحقيق). ثم عاد معظمهم إلى استخدام الرقم. فقد وجدوا فيه دعما لمصداقية منطق الصحافة السياسية.