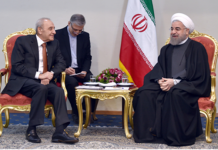المسيح الشرقي لا يستجدي الحماية من أحد
عقل العويط
20 أيلول 2014
النهار
“من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه، ويحمل صليبه كلّ يوم ويتبعني” (لوقا 9/23).
المسألة واضحة. مملكة المسيح ليست من هذا العالم. ولا هي بالطبع مملكة السياسة، ولا مملكة القادة الزمنيين والروحيين. فالمسيح لا يعقد مؤتمرات لحماية المسيحيين. ولا مؤتمرات لحماية الأقليات الشرقية الأخرى، أكانت إتنية أم دينية. وهو لا يطلب وصايات الدول، ولا حماياتها. فكيف إذا كانت الوصايات والحمايات من طريق الولايات المتحدة الأميركية؛ هذه التي تعبد ربّاً واحداً هو المال، وهي نفسها التي ما إن توحي أنها تريد حماية طرفٍ ما، حتى يتعرض هذا الطرف للاستئصال أو الاقتلاع والتهجير. مثل هذا المصير يسري على الجميع، باستثناء إسرائيل طبعاً.
كلّ الحمايات هباء. كلّ المؤتمرات هباء. وحدها موهبة العيش، هنا والآن، تحمي.
أن تكون موهوباً للعيش هنا؛ هذا هو التحدّي الحقيقي. ليس عند المسيحيين من تحدٍّ آخر البتّة، سوى كيفية المحافظة على موهبة العيش هنا. ما أقوله عن المسيحيين، أقوله عن المسلمين أيضاً، وأقوله في الآن نفسه عن كلّ الدولتيين، المتنوّرين، المدنيين، العلمانيين، الديموقراطيين، الذين يتوقون للاندراج كمواطنين أحرار في دولة المواطنة. ليس ترفاً أن يكون المرء عربياً، أو شرقياً، أو مسيحياً، أو مسلماً، أو لاأدرياً، “أكثرياً”، أو “أقلّوياً”. ليس ترفاً أن “يقرّر” المرء أن يعيش، هنا، والآن. بل بطولة. من أراد من المسيحيين أن يحيا هنا، والآن، فعليه أن يمارس بطولة العيش. سوى ذلك، في إمكانه أن يكون أيّ “شيء”. وفي مقدوره أن يخترع أساليب أخرى للعيش؛ كأن يساوم، أو يذعن، مثلاً، أو يطأطئ، أو “ينسجم”، إلى أن يصنع له الأمل حياةً أخرى.
عارٌ أن يذهب البعض إلى الولايات المتحدة الأميركية لمطالبتها بحماية الأقليات. عارٌ أن تشهد الولايات المتحدة مؤتمراً للمسيحيين الشرقيين، وأن يشارك فيه مسيحيون شرقيون. ليس لأن المؤتمرات مكروهة أو معيبة في ذاتها، بل لأن مكان هذه المؤتمرات يجب أن يكون هنا حصراً، ومع أهل المكان حصراً. ثمّ إن القائمين بالمؤتمرات الدينية والداعين إليها والمشاركين فيها، يحتاجون في الأصل، ودائماً، إلى موهبة الروح القدس، التي وحدها عند المسيحيين تملك السلطان القلبي على وجداناتهم الفردية والجمعية، وتفتح أمامهم السبل المغلقة.
لا حلّ خارج الهنا. فماذا يفعل المسيحيون الشرقيون بأنفسهم حين يعبّرون عن الهلع البشري حيال المصير، أو حين يطالبون بحمايات دولية، أو حين يهرعون إلى عقد المؤتمرات، لاستجداء البقاء في أرضهم؟ إذا كانوا لا يستطيعون البقاء، لأيّ سببٍ من الأسباب الموضوعية، كالسبب الناجم عن المظالم الحقيقية اللاحقة بهم، فليس عليهم سوى أن يختاروا بين الشهادة و”الحلول” الأخرى. فإذا اختاروا الشهادة، فيكونون يشهدون للمسيح. وإذا اختاروا “الحلول” الأخرى، فيكونون، بذلك، يختارون العالم، وهذا حقّهم البشري.
لكنّ هذا الحقّ البشري الطبيعي، إذ يندرج في لعبة المصالح والأمم، وإذ “يتنافس” والشهادة المسيحية، ويتناقض معها، فإنما يسحب من يد المسيحي “حقّ” المطالبة بالحماية، من منطلق الشهادة للمسيح. الانحياز إلى الحقّ البشري، والانخراط فيه، والتورّط في دهاليزه وكواليسه ومتاهاته، يستوجب الخضوع لشروطه من جهة، ويُبطل، من جهة أخرى، مفعول الحقّ الآخر. يبطل مفعول البطولة، ويكون يسدّد، واقعياً وموضوعياً، طعنةً نجلاء إلى المعنى الأجلّ في الإيمان الديني المسيحي؛ معنى أن يكون المسيحيون الشرقيون شهوداً ورسلاً؛ هم الذين يُفترض بهم، أن يحملوا أمانة الشهادة عن المسيحيين في العالم كلّه، لأنهم، أكثر من سواهم، بل دون سواهم، ورثة المسيح البشري، الشرقي، وأبناء ذرّيته.
للشاهد أن يشهد. كلّ عملٍ مضادّ لهذا الدور، يُخرِج الشهادة للمسيح من معناها، ومن فاعليتها الجوهرية، ويُفقدها خصوصيتها، ويجعلها عملاً دنيوياً، بشرياً، سياسوياً، آفلاً، مختلفاً تماماً عن بطولة العمل في المسيح.
ليس للمسيحي أن يخاف من كونه أقلّية. ليس له، في الأصل، أن يثير النقاش حول مسألة الأقليات والأكثريات، وأن يبحث عن مكانةٍ له فيها. معناه، وقيمته، موجودان خارج هذه القضية تماماً.
حين تحضر، على سبيل المثال، مسألة رئاسة الجمهورية في لبنان، يجب أن تحضر من كونها فاعليةً دولتية، مدنية، سياسية، وليست فاعلية دينية. وحين تثار من منطلق ديني مسيحي، تقع في الاستغلال، وسوء الاستعمال، وتصاب رمزيتها في صميمها، وتفقد جانباً كبيراً من أهميتها.
المسيحي، مسؤوليته أن يكون شاهداً. ليس عنده، كمسيحي، من مسؤوليات ثانية، أو موازية، إلاّ إذا أراد أن يختار العمل في العالم، الذي يخضع لشروط العالم، وحقوقه، وليس لشروط المسيح وحقوقه. عندما يختار المسيحي العالم، يتحمّل المسؤولية القانونية الناجمة عن هذا الخيار. رئاسة الجمهورية اللبنانية، هي في هذا المعنى، مسؤولية لا شأن لها بالمسيح، ولا بالمسيحية. هي شأنٌ سياسوي، دنيوي، بحت. من حقّ الذين يبحثون عنها، أن يناضلوا سياسياً – لا دينياً – من أجل الفوز بها، وأن يبحثوا عن السبل السياسية الآيلة إلى تحقيق هذا الفوز، ولكن خارج الشرط المسيحي. لا علاقة البتّة للمسيح بهذه القضية.
ما يفعله المسيحيون الشرقيون، ساسةً وقادةً روحيين، حين يستخدمون المسيح، لغايات دنيوية، وسياسوية، يقع مطلقاً خارج المسيح. وحين يستسلمون للهلع، وحين يطالبون بالحمايات، فإنما ذلك يناقض حمل الصليب، ويناقض كونهم مسيحيين، حيث يقع تصرّفهم في صميم السياسة، أي خارج الجوهر المسيحي، فيكون لا علاقة له بشهادتهم كمسيحيين.
ليس مسموحاً للقادة السياسيين عند المسيحيين بأن يثيروا مسألة السلطة السياسية، ودورهم فيها، إلاّ من منظور محض دولتي، دنيوي، سياسيوي. فليكفّوا، والحال هذه، عن “توريط” المسيح والمسيحيين في الموبقات السياسوية التي يمارسونها. هذه خطيئة كبرى يرتكبها هؤلاء الزعماء الدنيويون، فكيف إذا كانت تُرتكَب بمشاركة القادة الروحيين، ومباركتهم!
هذا في اللاهوت. أما في الواقع السياسوي، فثمة لبنانيون وسوريون وعراقيون، مسيحيون، خائفون مما يجري، وقلقون على المصير. هذان الخوف والقلق مشروعان، وواقعيان؛ مرةً بسبب الأنظمة الديكتاتورية، ومرةً بسبب الظلاميات التكفيرية الإلغائية، أكانت سنّيةً أم شيعية. هذان الخوف والقلق، يجعلانهم يبحثون عن الحلول التي يعتقدون أنها تنجّيهم من شرّ ما يواجهونه من ديكتاتوريات سياسية وأمنية وظلاميات دينية، لا تطاولهم فحسب، بل تطاول كلّ “خارج” على مفاعيل الأمر الواقع. فليعرف الجميع أن هؤلاء “الخارجين” هم مسلمون ومسيحيون وعلمانيون ولاأدريون ولادينيون على السواء.
سابقاً، كان هؤلاء المسيحيون أنفسهم يعيشون في كنف الديكتاتوريات الاستبدادية، وكان الكثر منهم يكتمون التوق إلى ما يطمحون إليه من حرية وكرامة، بقبول الانضواء تحت أجنحة هذه الديكتاتوريات. اليوم، تعصف بوجودهم قوى التكفير والاستبداد من كلّ حدب وصوب. لكن الخيار؛ وتالياً ما يترتّب عليه؛ واحد، ماضياً وحاضراً، هنا وهناك، وفي الحالتين: إما الشهادة للمسيح، وإما تواطؤهم ضدّ مسيحيتهم، وضدّ كرامة الشخص البشري، والقبول بالذلّ.
الحلّ الوحيد لهؤلاء المسيحيين، ولقادتهم السياسيين والروحيين، أن يبتدعوا مع مواطنيهم الآخرين، وخصوصاً المسلمين، الدولة التي ينتظمون في كينونتها القانونية والسياسية. وحدها صناعة الدولة المدنية الديموقراطية، ووحده الانتماء إلى دولة القانون هذه، ينجّيان المواطنين، كلّ المواطنين، من الإهانات التي تطعن في كرامة وجودهم وعيشهم. فكيف إذا كانوا مسيحيين ومسلمين على السواء!
المدنيون المسيحيون، يستطيعون أن يفعلوا الكثير إذا أرادوا أن يفعلوا الكثير. هم، إذا شاؤوا أن يحملوا رمزياً صليب المسيح في العالم، في إمكانهم أن يكونوا خميرةً معنوية في العجين السياسي والمجتمعي، وأن يساهموا في ابتداع صيغة خلاّقة، تصون المعنى الأساسي للمسيحي الشرقي، باعتباره وارث المسيح الأول في هذه الأرض، وتحفظ المسيحيين الشرقيين، كفاعلية قيمية، إنسانوية ومجتمعية وثقافوية وحضارية.
تعيش المجتمعات العربية مخاضها الوجودي العسير. ما يصيب المواطنين المسيحيين، يصيب في الآن نفسه المواطنين المسلمين، الذين ينتظمون في رحاب الدولة المدنية. كما يصيب كلّ الذين يهجسون بالعقل والحرية والديموقراطية والعيش المتنوّع. لا خلاص لهؤلاء جميعاً إلاّ بصناعة الدولة المدنية. وحدها تقلّم أظفار التكفيريين والظلاميين والاستبداديين والإلغائيين، من هذه الجهة أو تلك.
ليست المسيحية هي وحدها في الخطر، بل هو الإسلام خصوصاً وأيضاً في خضمّ هذا الخطر. فليكفّ المسيحيون عن التباكي وإبداء الهلع واستجداء الحمايات. وليبحثوا عن الحلّ الوحيد في ابتداع موهبة العيش هنا. والآن. وليعلم الجميع أن المسيح الشرقي لا يستجدي الحماية من أحد. ولن يطلب اللجوء من أحد. معياريته الوحيدة أن يكون مسيحاً، أو أن يتشبّه بالمسيح.
ما عدا ذلك، تقع مسؤوليته على أهل السياسة. وهؤلاء، يجب أن يكونوا أدرى بشعابها ودهاليزها ومتاهاتها، وأدرى من أين تؤكل كتفها. هم يتحملون تبعات أعمالهم ولعنات التاريخ، أو مجده. فليتحمّلوا.